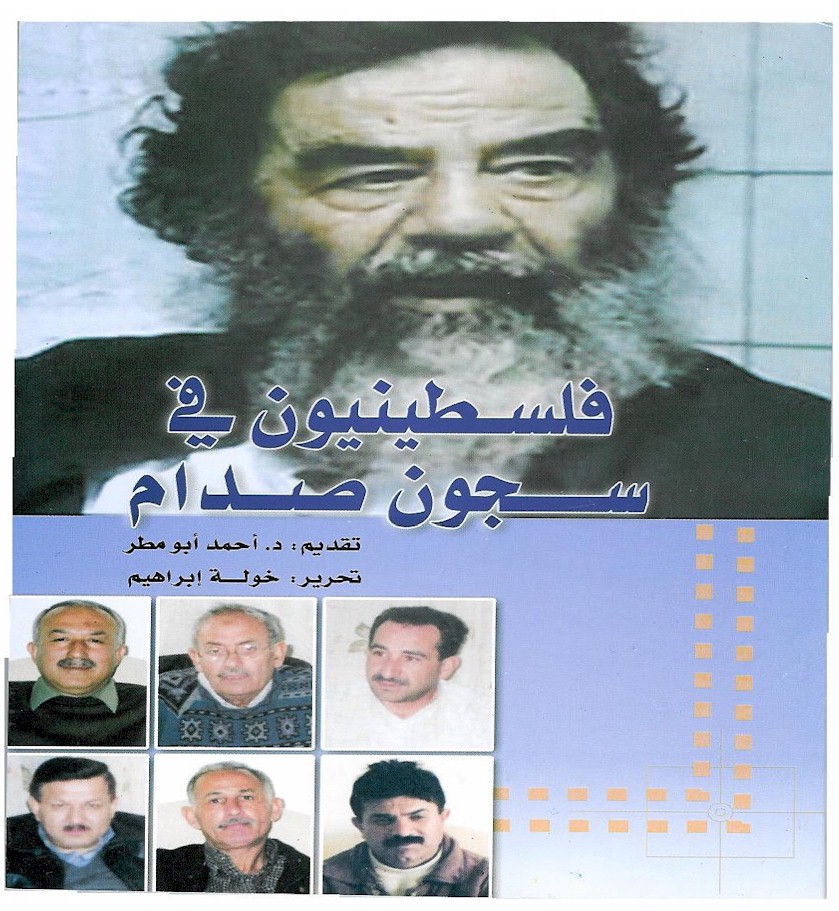
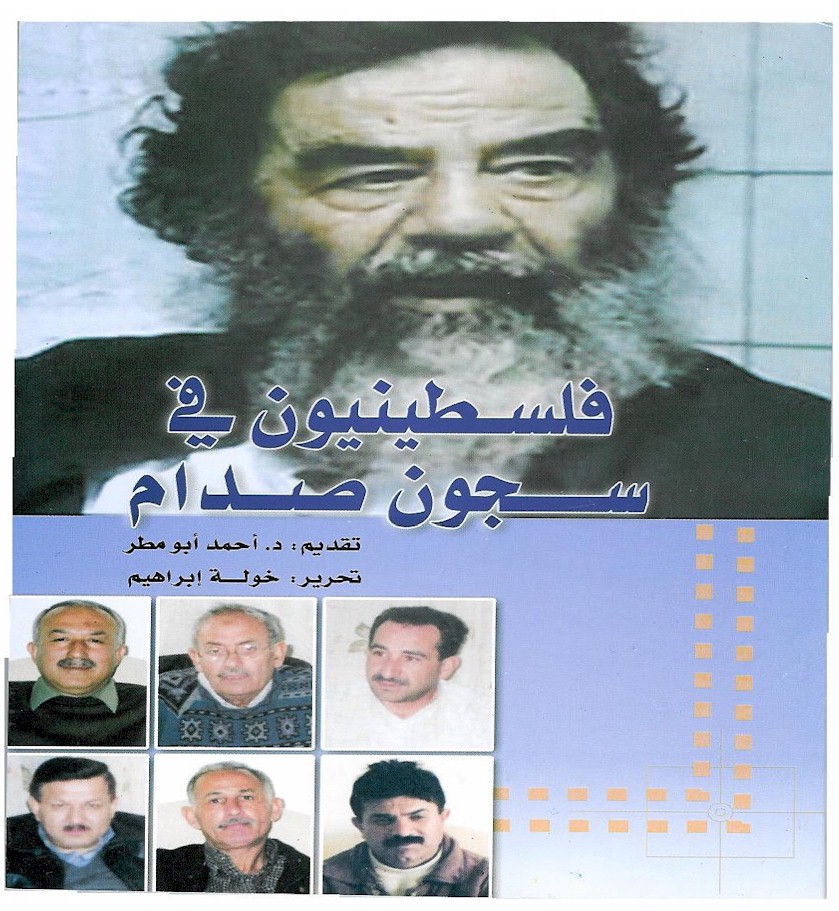
|
فلسطينيون في سجون صدام
الطبعة الأولى 2004 مقدمة / الديكتاتور وقضية فلسطين ... بقلم الدكتور أحمد أبو مطر الشهادة الاولى / محمد جميل السويركي / مخيم عين الحلوة .. لبنان الشهادة الثانية / ضيف الله حسين حمدان أبو رياش ... مادبا الشهادة الثالثـة / عدنان محمد عبد القادر جبارين الشهادة الرابعة / عبد الاله سليم الحجاوي الشهادة الخامسة / عماد محمد عبدالله الشهادة السادسة / أحمد إبراهيم عايد الشهادة السابعة / محمد الإدريسي شهادة على الشهادات / خولة إبراهيم قراءة في كتاب " فلسطينيون في سجون صدام " للدكتور أحمد أبو مطر من جرائم الديكتاتور صدام بحق الفلسطينين: كيف قُتل وديع حداد؟
الديكتاتور وقضية فلسطين بقلم الدكتور أحمد أبو مطر كانت قضية فلسطين دوماً ورقة مزايدة لدى كافة الأنظمة العربية، وبإسم هذه القضية قامت كافة الانقلابات العسكرية غير الشرعية في العديد من الأقطار العربية، فهي الكلمة الأولى في البيانات والخطابات عند الاستيلاء على دور الإذاعة والتلفزيون من قبل أي ضابط برتبة ملازم أو عقيد، فهو إنقلب على من سبقه للسلطة عبر إنقلاب أيضاً، لأنه لم يقم بواجبه نحو القضية الفلسطينية.. وهكذا كانت هذه القضية وما زالت طوال الستين عاماً الماضية الورقة الرئيسية في أيدي الحكام، يلعبون بها لتبرير هزائمهم وجرائمهم. وضمن مسيرة هؤلاء الحكام، إنفرد الديكتاتور المجرم صدام حسين، منذ تفرده بالسلطة عام 1977، باستعمال هذه القضية غطاءاً لسياساته العدوانية الخارجية، وجرائمه الداخلية التي راح ضحيتها ما لا يقل عن مليونين من العراقيين، بكافة إنتماءاتهم: عرباً وأكراداً، مسلمين ومسيحيين. في عام 1977، ولاحقاً لما عُرف بميثاق العمل الوحدوي مع النظام البعثي السوري، قام بإعدام عشرات من قياداته ورجاله، بتهمة التآمر لحساب البعث السوري، وهذا التآمر -حسب إدعاءاته- يعيق العمل الوحدوي الهادف إلى تحرير فلسطين.. وفي عام 1979، بدأ حربه ضد الجارة المسلمة إيران، بحجة الدفاع عن البوابة الشرقية للوطن العربي، هذه البوابة التي تشكل حصناً لتحرير فلسطين.. وفي عام 1990، قام بعمل إجرامي لا أخلاقي، لا مثيل له في كافة مراحل التاريخ العربي، عندما احتل دولة الكويت، وعاث حرسه الجمهوري فيها فساداً وقتلاً وتخريباً، مدّعياً تارةً أنها جزء من العراق، ورابطاً أحياناً بين إحتلاله للكويت وإحتلال إسرائيل لفلسطين.. وعقب قيام التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بدحره من الكويت مهزوماً، وتحرير الكويت، قام بلعبة أسماها (جيش القدس) الذي كان في حد ذاته جيشاً تلفزيونياً للاستعراضات، والضحك على جماهير جاهلة مسلوبة الإرادة، وعندما إكتمل تدريب هذا الجيش وزعه على المحافظات العراقية، لقمع الانتفاضة والمعارضين.. وأثناء إحتلال الكويت، قام بإطلاق عدة صواريخ خالية من أية قدرات تدميرية، برمجها لتسقط في صحراء النقب، ولم تُحدث أية أضرار أو خسائر، وكل ذلك ضمن سياق الضحك على الجماهير، والإدعاء بأن كل ما يقوم به، إنما من أجل فلسطين، وعمد في كل خطبه في السنوات العشر الأخيرة، إلى تكرار جملة (عاشت فلسطين حرة عربية.. من النهر إلى البحر).. وهو نفس خطاب غالبية الأنظمة العربية المتاجرة بهذه القضية.. وهذا ما يُفسر هوس بعض القيادات العربية (الجاهلة) بهذا الديكتاتور المجرم، الذي إرتكب بحق الشعب العراقي، ما لا يقبلون هم أن ترتكبه أنظمتهم بحق شعوبهم.. وهذا ما يفسر غضب الشعب العراقي من هذه القيادات العربية، ومن قطاعات واسعة من شعوب عربية، لأنها تريد الحرية والديمقراطبة لنفسها، وتصفق لحاكم طاغية ارتكب أعنف وأقذر الجرائم بحق الشعب العراقي.. ورغم هذا التضليل، فإن الشعب الفلسطيني نفسه، لم يسلم من جرائم هذا الطاغية، ففي هذا الكتاب التوثيقي، نقدم شهادات لعدة مواطنين فلسطينيين، أدخلتهم أجهزة الطاغية وبعلمه، سجون النظام وزنزاناته، دون أية أخطاء أو جرائم ارتكبوها، وفقط ليقول للجميع، أنه لا يخاف أحداً، حتى الفلسطينيين الذين يتاجر بقضيتهم.. هؤلاء الأشخاص، يروون تجاربهم الأليمة، بأسمائهم وصورهم، بذكر كافة التفاصيل من أسماء سجانيهم إلى أماكن أقبية سجنهم، مع ذكر تواريخها وكافة وقائعها.. والهدف من تسجيل هذه الشهادات ونشرها، هو كشف جانب مجهول من جرائم هذا الطاغية، ولتوضيح حجم الإنجاز الذي تحقق بإسقاطه ونظامه في التاسع من أبريل/نيسان 2003، ثم إعتقاله في الثالث عشر من ديسمبر/كانون أول 2003 . وأود التأكيد على أن كافة هذه الشهادات، موجودة بصوت أصحابها، كما وردت في هذا الكتاب، ومتاح الحصول عليها لكل من يطلبها.. إن هذا الكتاب يكشف حجم جرائم هذا الديكتاتور بحق بعض أبناء الشعب الفلسطيني، التي هي شبيهة بجرائمه الجماعية بحق الشعب العراقي.. علّ المضللين يفيقون من سباتهم، ومتعة رشاوي الديكتاتور لبعضهم.. ليروا هذا المجرم على حقيقته.
محمد جميل السويركي - مخيم عين الحلوة - جنوب لبنان مواليد 27 أيار - مايو 1960
في الأول من آب/أغسطس، عام 1980، كان عمري تقريباً عشرين عاماً، وكان قد مضى عام على حصولي على شهادة الدراسة الثانوية (التوجيهي)، ولعدم وجود الإمكانيات المادية، لم أتمكن من الإلتحاق بأي من الجامعات اللبنانية أو الجامعات العربية في الأقطار العربية المجاورة. عملت في أعمال يدوية في الجنوب اللبناني، أحصل منها على مردود مالي لا يستحق الذكر، لكنه في ظل أوضاع عائلتي المتردية، كان يسهم في سد بعض حاجات الأسرة.. وفي يونيو/حزيران من عام 1982 تزوجت من إبنة عمي (سامية)، التي كانت في الرابعة والعشرين من عمرها، وحاصلة مثلي على شهادة الثانوية العامة (التوجيهي)، وتعمل في محل (خياطة) لملابس النساء.. في إحدى زياراتي لبعض الأصدقاء في بيروت، تعرفت على مواطن لبناني من عائلة (بشور)، عرفت أنه من قيادة حزب البعث اللبناني، الجناح الموالي لحزب البعث العراقي. شكوت له أحوالي وظروفي، ورغبتي في مواصلة دراستي الجامعية، فوعدني بمحاولة إيجاد مقعد جامعي لي في إحدى الجامعات العراقية، من ضمن الكراسي الجامعية المخصصة لحزب البعث اللبناني، وهي حوالي ثلاثين مقعداً سنوياً، موزعة على عدة كليات منها كلية الآداب، التي أرغب في دراسة التاريخ فيها. إتصل بي هذا المواطن اللبناني، فذهبت للقائه في بيروت في العشرين من يوليو 1983، ففاجأني بخبر مفرح، مفاده أنه تمكن من تسجيلي في قسم التاريخ بجامعة بغداد، ضمن المقاعد المخصصة لحزبه، حزب البعث اللبناني، وأنه ينبغي أن أسافر في موعد أقصاه بداية أغسطس/آب 1983، كي ألتحق بالجامعة فور إفتتاحها، وأنه أستطيع أن آخذ معي زوجتي، إذ سنحصل على غرفة في المدينة الجامعية، وهو سيتصل مع مسؤول حزب البعث هناك لتدبير عمل لزوجتي في إحدى مرافق الجامعة، وبعد ذلك نستطيع إستئجار شقة عائلية، ونترك المدينة الجامعية. وصلت مع زوجتي بغداد في الموعد المحدد، وقابلنا مسؤول حزب البعث في كلية الأداب بجامعة بغداد، الذي قدم نفسه على أنه الرفيق مجيد السعدون، وأرسلنا على الفور مع سائق عراقي إلى المدينة الجامعية، حيث حصلنا على غرفة فيها، وطلب مني أن تعود زوجتي وحدها غداً لمقابلته من أجل تدبير عمل لها.. عادت زوجتي من اللقاء غير مرتاحة لسلوكه معها، والكلام الذي سمعته منه، فهو يُصرّ على أن تأتي دوماً للقائه وحدها، وفي الغالب في نهاية الدوام، حيث لا أحد في مكتبه، ورغم ذلك كنا مضطرين، لأن تستمر في الذهاب للقائه كلما طلب منها ذلك، فالعمل الموعودة به زوجتي أكثر من ضروري لنا.. إنتهى الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1983، ونحن ما زلنا في المدينة الجامعية، وزوجتي لم تحصل على العمل الذي يعدها به، وفي كل لقاء يقسم بأن حصولها على العمل بات قريباً.. بين الفصلين الدراسيين، توجد إجازة جامعية حوالي إسبوعين.. إتصل بي المسؤول الحزبي نفسه، وقال: أريد أن أدعوكما، أنت وزوجتك، لقضاء الإجازة معي ومع أسرتي في مصيف صلاح الدين بشمال العراق.. وفعلاً أرسل لنا احدى سياراته، أوصلتنا إلى المصيف، وكان هو شخصياً في إنتظارنا.. أوصلني مع زوجتي إلى شقة كبيرة، وتبدو فيها مظاهر الرفاهية، وقال: إستريحوا، وفي المساء، سنحضر أنا وزوجتي للتعارف، ثم نخرج للعشاء معاً.. جاء إلى الشقة حيث نقيم، حوالي الساعة الثامنة مساءاً وحده وقال: إن زوجته ستلحق به بعد ساعة، لإنشغالها بموعد حزبي مفاجئ.. ولكنه يريد مني خدمة ضرورية وسريعة، فقد نسي ملفات ضرورية في مكتبه في بغداد، ولا يأمن غيري على الذهاب لإحضارها مع سائقه، لم أستطع الرفض، ووافقت زوجتي على الفكرة، فهذه الخدمة سوف تشجعه على إيجاد عمل لها، وكلها دقائق وتحضر زوجته، ويبقون معاً إلى حين ذهابي وعودتي من بغداد.. كانت الرحلة من الشمال إلى بغداد، ذهاباّ وعودة، تحتاج إلى ما لا يقل عن عشر ساعات، ولما وصلت ليلاً، كان مكتبه مقفولاً، فانتظرت إلى الصباح، حيث أعطاني سكرتيره فعلاً بعض الملفات في حقيبة يد صغيرة مقفلة، وعدت إلى مصيف صلاح الدين، بعد حوالي عشرين ساعة، أي بعد أن أمضت زوجتي -حسب اعتقادي- ليلة كاملة معه ومع زوجته.. أعطيته الملفات، وغادر إلى شقته، وكانت المفاجأة، أن زوجتي أخبرتني، أنه طوال الليل وهي وحدها معه، ولم تحضر زوجته، وأنه حاول بكل الوسائل ممارسة الجنس معها، مستعملاً الترغيب والتهديد، ولم تفصح لي إن كان قد وصل إلى ما يريده معها أم لا.. ولم ألح عليها في هذا الأمر، لحراجة موقفها وموقفي.. أخبرنا في اليوم الثاني، أنه يعتذر لأن زوجته انشغلت بأعمال حزبية، وسافرت إلى جنوب العراق.. لذلك سنعود معه إلى بغداد.. بدأ الفصل الدراسي الجامعي الثاني، وما زلت مع زوجتي في غرفتنا بالمدينة الجامعية، وبعد إسبوع من بدء الدراسة، استدعاني مسؤول الأمن في الكلية، ليخبرني أنني مطلوب للتحقيق، لأن هناك معلومات وصلته، تفيد بأنني مدسوس من قبل حزب البعث السوري للتجسس على حزب البعث العراقي.. حاولت نفي هذه التهمة، فصفعني على وجهي، وأمر حارسان بتقييد يديّ، وأخذي إلى العقيد (جاسم المعاني) في جناح رقم (12) بسجن أبي غريب، وأعطى الحارسان ملفاً ضخماً مليئاً بالأوراق. وصلت إلى السجن، فبادرني العقيد جاسم المعاني، كما إسمه مكتوب على مكتبه، بأن صفعني على وجهي، وركلني بقدمه، فوقعت على الأرض، فصرخ: قم.. يا فلسطيني.. يا جاسوس.. كلكم جواسيس.. والله لأعذبك عذاب البين يا كلب.. قمت من على الأرض، أصرخ من الألم، فبادرني بالضرب بعصى غليظة في يده قائلاً: فلسطيني جاسوس.. أكيد أبوك باع أرضه لليهود كمان يا إبن الكلب.. بناءاً على أوامره أخذني حارس مكتوف اليدين، إلى زنزانة قذرة، ودفعني ليصطدم وجهي في جدارها، وأقفل عليّ الباب، وعاد إلى حيث العقيد.. أمضيت في هذا الوضع المهين، حوالي أربعة شهور متواصلة.. نقص وزني بشكل ملحوظ، وأصبح يلازمني ألم حاد في المعدة، كنت أصرخ منه عالياً، دون عرضي على طبيب أو توفير أي نوع من الدواء.. ومن حين إلى آخر، يطلبني العقيد (جاسم المعاني)، ويقول لي صراحة: (لا بد أن تعترف أنك جاسوس، أرسلك البعثيون السوريون للتجسس على البعث العراقي)، وأعود للتأكيد بأنني في حياتي لم أغادر مخيم عين الحلوة، إلا إلى بغداد للدراسة، وأسألوا الحزبي البعثي اللبناني الذي أمّن لي الكرسي الجامعي.. يرفض توضيحاتي هذه، ويبصق عليّ قائلاً: تذكر أين زوجتك الآن.. عندئذ سوف تعترف يا ابن الكلب يا جاسوس مرّ عليّ في هذا الوضع، ثمانية شهور، لا أعرف شيئاً عن أسرتي في مخيم عين الحلوة، أو عن زوجتي (سامية) في المدينة الجامعية ببغداد.. مرة طلبت من العقيد مسؤول السجن، أن أرسل رسالة لأسرتي وزوجتي، فانهال عليّ بالضرب قائلاً: وين فاكر حالك يا ابن القحبة.. في لندن أم في باريس.. باكر إن شاء الله تطلب مقابلة الصليب الأحمر.. وبطحني أرضاً، وداسني على معدتي بقدميه، بقسوة لا مثيل لها، قائلاً: تذكر زوجتك.. الآن ربما هي ممددة هكذا، ولكن في وضع آخر.. اعترف يا فلسطيني يا جاسوس.. مرّ أكثر من عام كامل عليّ في هذا الوضع.. وفي يوم الخامس من أيلول/سبتمبر من عام 1984، وكان يوم (اثنين)، أخرجني السجّان إلى مكتب العقيد، فبادرني إلى القول: ما اشتقت لزوجتك.. ستخرج الآن لمقابلة الرفيق مجيد السعدون، وربما ترى زوجتك في مكتبه.. وضعوا على عينيّ عصابة من القماش، ورموني في سيارة، سارت حوالي ثلاثين دقيقة، دون أن أعرف أين تسير أو أين وصلنا.. أنزلوني منها، وعندما رفعوا الغطاء عن عيني، وجدت نفسي داخل غرفة واسعة، فيها مكتب وكنبات، دون أن أعرف أين هذه الغرفة، وفي أي مبنى.. ومن غرفة مجاورة، كانت تصدر أصوات مختلفة، ميّزت من بينها صوت الرفيق مجيد السعدون، يقول لمن حوله: (زوجته.. وشبعت منه.. أريد أرميها زي الكلبة والجاسوس لازم يعترف.. ويوقع بخط يده أنه كان يتجسس للسوريين، لأن مسؤول بعثي لبناني يسأل عنه وعن زوجته..).. بقيت وحدي في الغرفة حوالي ساعة ونصف.. والأصوات من الغرفة المجاورة، أسمعها حيناً وتهدأ حيناً آخر.. وفجأة، فُتح الباب، وإذا زوجتي (سامية)، تدخل عليّ شبه عارية، لا يستر جسدها سوى ملابسها الداخلية.. أقفلوا علينا الباب، وانخرطنا معاً في بكاء عميق.. كدت أجن لهذا المنظر الذي رأيت زوجتي به.. فقالت لي: هذا المنظر أهون بكثير، مما كان يفعله معي السعدون وحراسه وسائقوه، طوال العام الماضي.. لا أستطيع الكلام الآن.. لا بد أن تعترف أنك جاسوس للسوريين، وإلا فستبقى في السجن طوال عمرك، وأنا سأظل أتنقل بين غرف نومهم وأسرتهم.. وأنخرطت في البكاء مجدداً، لتخبرني أنه طوال العام الماضي، كان المسؤول الحزبي، ينقلها من شقة إلى شقة، ويجبرها على شرب الكحول، ثم يغتصبها، وبعد أن يخرج يتركها في أيدي الحراس، ليغتصبوها على التوالي.. وفي مرة، صحت من تأثير الكحول، لتجد نفسها تحت أحد الحراس، فقالت له باكية: مو عيب.. بعثي زيك ويغتصب فلسطينية.. فصرخ فيها: يا قحبة.. جوزك جاسوس.. وما نغتصبك.. إسرائيل اغتصبت فلسطين.. وإحنا نغتصبك... شو فيها ! بقيت مع زوجتي وحدنا حوالي ساعة ونصف.. ثم دخل علينا المسؤول الحزبي ذاته، ومعه ثلاثة حراس.. هجم واحد منهم على زوجتي، ومزق ملابسها الداخلية، فوقفت عارية أمامنا، تحاول ستر جسدها بيديها، دون فائدة.. دفعها المسؤول الحزبي بيديه، فوقعت على الأرض ممددة على ظهرها. حاولت الوقوف، فركلها بقدميه، وقال لي: آه.. تعترف.. ولا أخلي الشباب يغتصبوها أمامك.. لم أتحمل هذا المنظر، فقلت له أعترف.. حاضر.. سيدي.. والله أنا جاسوس للسوريين، وأساساً أرسلوني للتجسس عليكم، على البعث العراقي.. ضحك عالياً، وقال لأحد الحراس: زين.. هات ملابس الحرمة من الغرفة المجاورة.. وأعطاني ورقة مكتوب فيها: “أنا المواطن الفلسطيني محمد جميل السويركي، من مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان، ومن مواليد 27/5/1960، أعترف صراحة وأنا بكامل قواي العقلية وبدون أية ضغوطات نفسية أو جسدية، بأنني قدمت إلى بغداد في آب/أغسطس 1983، مرسلاً من قيادة البعث السوري في لبنان، لأدرس في جامعة بغداد مع زوجتي، وذلك كغطاء للتجسس على الرفاق في البعث العراقي، وتحديداً مراكز القيادة وتحركات الرئيس القائد صدام حسين حفظه الله، وقد زودتهم قبل اعتقالي بالعديد من التقارير، التي كنت أرسلها مع سائق إحدى الشاحنات التي تعمل على الطريق بين بغداد ودمشق، وقد كان قدوم زوجتي معي بشكل مخطط، كي أستغلها للوصول إلى القيادات التي أرغب في جمع معلومات عنها.. وأشهد أنني لقيت وزوجتي معاملة حسنة في كافة مراكز السجن التي كنّا فيها.. وكان الرفاق البعثيون العراقيون، يأسفون لوجود فلسطيني جاسوس مثلي ومثل زوجتي..”. قرأت هذه الورقة، وزوجتي ما زالت عارية أمامي، وكلما ترددت، بادرني العقيد المسؤول الحزبي بالقول: آه.. تريد يغتصبوها أمامك.. خذ هذه الورقة، وأجلس على المكتب، وأكتب ما في هذه الورقة، على ورقة أخرى بخطك.. بهدوء وبخط واضح.. فعلت ذلك خلال دقائق.. وعندما إنتهيت منها.. قرأها.. وقال: خوش.. والله.. ولد مطيع.. ما تستاهل نغتصب زوجتك أمامك.. قدّم لي جهاز تسجيل وقال: الآن.. سأفتح جهاز التسجيل، وعليك أن تقرأ هذه الورقة كاملة، كي أسجل إعترافاتك بصوتك يا جاسوس.. يا جوز (.....)، وأطلق شتيمة بذيئة.. سجّلت بصوتي ما هو مكتوب على الورقة، أخذ جهاز التسجيل والورقة، وقال للحراس: خذوا هالمرة على المزرعة إللي كانت فيها.. ورجّعوا الجاسوس للسجن، في انتظار المحاكمة، وإن شاء الله سيكون حكمك إعدام يا ابن الكلب.. وما حينفع مراجعة بعثي لبناني، يسأل عنك وعن زوجتك.. هو أكيد يسأل عن زوجتك فقط.. أكيد إشتاق لها.. عدت إلى السجن، وقبل أن يأخذوني إلى الزنزانة، طلب العقيد جاسم المعاني من الحراس أن ينتظروا معي في مكتبه، لحين عودته من جولته على أركان السجن.. عاد بعد حوالي نصف ساعة، وطلب من الحراس الخروج من المكتب، وسألني عمّا حدث معي في مكاتب المسؤول الحزبي، فسردت له كل التفاصيل، فقال لي: وقعت الورقة، وسجلت ما فيها بصوتك.. والله.. كل القوى ما طّلْعك حيّ من بغداد.. بكيت بحرقة أمامه، وأقسمت بالله أنني بريء ولا علاقة لي بالبعث السوري.. ضحك قائلاً: عيني.. كلنا عارفين إنك بريء.. المشكلة إشلون المسؤول الحزبي يستفرد بزوجتك.. ويستعملها كما يشاء لشهواته.. كان لازم تلفيق هاي التهمة.. بس الآن ما في شي ينفعك.. زوجتك تحت رحمته.. وأنت إعترفت بأنك جاسوس.. بخطك وبصوتك.. خذوه للزنزانة.. جاء الحراس، ورموني في نفس الزنزانة، دون أن أعرف أين أخذوا زوجتي.. لا قانون يحكم المعاملة للسجناء، فنحن رهن مزاج الحراس ومسؤول السجن.. الحراس ينفّسون عُقدهم بضربنا وشتمنا بدون رحمة.. وبعضهم يسألك عن عنوان وهواتف لأقاربك، إن تدفع له كذا.. يعدك بالمساعدة.. وفي اللحظات القليلة التي نلتقى فيها بسجناء عراقيين، يحدثونا عن نفس سوء المعاملة.. ونفس الابتزاز.. في نهاية يوليو/تموز 1985، مرّ عليّ في السجن، وهذه الأوضاع المزرية، حوالي سنتين.. وفي آخر يوم من هذا الشهر، أخرجوني من الزنزانة إلى مكتب مسؤول السجن، ليخبرني.. أن هناك عفواً عاماً من الرئيس صدام حسين، سوف يشملني أنا وزوجتي.. وعليّ أن أكتب، الرسالة التالية بخطي للسيد الرئيس: “السيد الرئيس القائد صدام حسين حفظه الله أنا الجاسوس الفلسطيني محمد السويركي، وزوجتي الجاسوسة سامية السويركي، نشكرك جزيل الشكر على العفو العام عنّا، وهذه مكرمة لا ننساها لك”.. وقعت على الورقة، وأخبروني أنهم سوف يأخذونها لزوجتي في مزرعة المسؤول الحزبي، لتوقيعها، ثم ننتظر الافراج عنّا.. في الخامس والعشرين من آب/أغسطس من عام 1985، اقتادوني من السجن إلى حافلة كانت تقف أمام مدخل السجن، وفيها حوالي عشرين رجلاً وإمرأة، ومن بينهم زوجتي.. سارت بنا الحافلة، وبعد ساعات، ألقونا على الحدود السورية.. بعد إجراءات قاسية، وعدة ليالٍ في السجون السورية، عدت مع زوجتي إلى مخيم عين الحلوة.. كانت حالة زوجتي قد وصلت حد الإدمان على الكحول من جراء ما تعرضت له في بغداد.. وأنا ساءت حالتي الصحية والعقلية.. وما زلت حتى عام 2004، أتساءل: هل يحدث مثل ذلك في أي من سجون العالم.. إنها سجون المجرم صدام حسين فقط التي تشهد ذلك، ومع الفلسطينيين خاصة.. ضيف الله حسين حمدان أبو رياش مواليد 26/8/1962 في مادبا لقد ذهبت إلى العراق لأول مرة في منتصف تشرين الأول من عام 1982، بهدف التقديم للدراسة الجامعية ولم أُوفق، وليتني توقفت عند هذه النتيجة.. لكن حظي كان يريد الوصول بي إلى اتجاه آخر، فقد عدت إلى الأردن ولكنني مع وصول القبول في العام التالي، حملت نفسي مرة أخرى (على الهجرة إلى الشمال) جامعة صلاح الدين في اربيل - كردستان العراق، وأكملت دراستي في علم الاجتماع ولكنهم اعتقلوني في الأول من تموز 1987 وأنا في طريقي إلى الأردن، كي أحضر والدتي لحفل التخرج الجامعي ! هذا الحفل الذي لم أحضره بالطبع.. ولم أتخرج لحد الآن ! وبدأت الحكاية بأن أستوقفوني في المطار بعبارات مختصرة “نريدك لخمس دقائق فقط”، لتنتهي الخمس دقائق في عام 1998 ! وأثارا إستغرابي أكثر أن حقائبي وأوراقي الرسمية كانت معهم.. ماذا يريدون.. ما معنى إعادتي إلى الخلف والطائرة على وشك الاقلاع ؟ هل يعني هذا أنهم سيحرموني حفل التخرج وحضور والدتي في الخامس عشر من تموز ؟ هذه هي الأسئلة التي كانت تدور في ذهني القاصر حتى هذه اللحظة عن إدراك أبعاد أخرى أو مؤامرات كانت تحاك لي في الخفاء. وعلى الفور سيتبادر إلى ذهن أي إنسان يسمعني سؤال: “ألم تكن قد مررت بمضايقات سابقة طوال تلك السنوات ؟". ولكي أجيب فأنا مضطر للعودة إلى سنوات عمري الجميل، كأي طالب على وجه الأرض يحمل معه حفنة من الآمال وتخطيطات بريئة لرسم لوحة المستقبل، وربما مخططات “غير بريئة” لحياة منطلقة يعيشها فتىً غادر المدرسة للتو، وودع الأهل وكسر الطوق من حوله، وأنا لم أكن بطبيعتي شقياً ولا مشاغباً ولكن بدوي نشأ في بيت من الشعر، لا يعرف دروب السياسة ولا هو يفقه معانيها، وكل ما يعرفه هو أن الأشياء تأتي بالتعلم والتدريب، ومن شأن حياة جامعية مترامية الأطراف، متعددة الأهداف أن تمنحه القدرة على الاكتساب، ولا يمكنني نسيان ذكر ما كنت عليه من الحدة وعدم الليونة، أو ما يمكن تسميته بفقدان اللياقة الاجتماعية، ويا للصدمة، فإن أول ما يواجه الطالب هو مسؤولو الاتحادات الطلابية الذين يعرضون خدماتهم ومساعداتهم على القادم الجديد الذي يتلمس أول الطريق. وبدأت أدرك أن هذه المقدمات ستقود إلى نتائج على الصعيد الآخر، فما هي إلا جسور يمدونها كي أصل النقطة المحددة من قبلهم، ولم أقبل صعود أي جسر من جسورهم، وكان لي صديق قد نصحني من قبل بالسكن لدى عائلة كردية لأنني بالأساس استبعدت السكن الداخلي، وقد يستغرب البعض لجوئي للسكن في الوسط الكردي، من منطلق الحكم على الأكراد بعداوتهم للعرب، ولكن الحقيقة هي غير ذلك، فلقد لمست في الأكراد طيب المعشر وحسن الضيافة، ولأنني شخصياً أخجل من الإقامة الدائمة لدى عائلة فقد طلبت مساعدتهم في تأمين شقة أسكنها بمشاركة طلاب آخرين، انتهى موضوع السكن.. لتبدأ اللقاءات في مقر الاتحاد العام لطلبة الأردن وليس من حديث يخوضون فيه معي، سوى الانتماء للحزب العظيم، وكانت حجتي التي أسوقها للرد عليهم ببساطة: أنا فلسطيني يحمل معاناته أينما حلّ وارتحل وليس هناك من دواع للأطر الأيديولوجية.. ولكن هذا لا يسمن ولا يغني من جوع في عرفهم، فيزداد الضغط وتشتد وتيرة الانتقادات وتحتد النبرات، ولكن معي وفي كل مرة تتكسر النصال على النصال. حاولت من جانبي ابقاء علاقاتي بالطلاب في إطار من المحدودية والتحفظ، ومرت السنة الأولى قاسية، وبدا للطرف الضاغط أنني أسد الطريق فلاحت في الأفق علائم الحقد والكراهية، والحقيقة التي بدأت أنجذب إليها هي معاناة الاكراد ورغبتي في تعميق صداقاتي بالطلاب الأكراد، فقد وجدت قواسم مشتركة بينهم وبيني، كمثل القواسم المشتركة لمعاناتهم ومعاناة الفلسطيني، ولربما كانت هذه هي بداية المنعطف، أو بداية ما يمكن تسميته “الخطأ الشخصي”، إذ أنني لم أسر في درب “بعثي حتى التخرج”، وأول تعرض قامت به الأجهزة الأمنية ضدي حدث في نهاية العام الدراسي الأول حيث اعترضتنا سيارة (أنا وزميل لي من مادبا) ونزل ركابها ليختطفونا إلى دائرة أمنية: عصبوا عيوننا وانهالوا علينا بالضرب وتوجيه الإهانات قالوا: “أنت في بداية دراستك ومن السنة الأولى تظهر عداءك للبعث وتنسى خيره عليك”، واقتصر ردي عليهم “لا تمنّوا عليّ، فأنا أصرف من مالي الخاص الذي يصلني من أهلي”. واطلقوا سراحنا.. عدت لأنفذ نصيحة قدمها لي بعض الزملاء بالتخلي عن راتب المنحة وتحويله كمساعدة لجبهة التحرير العربية، خلاصاً من منتهم، ومع ذلك لم تتوقف المضايقات في السنة التالية، أما ما شكّل المضايقات فهو التحرش برموز الثورة الفلسطينية، وتخوين س و ص من الشخصيات الفلسطينية، كعملية إستفزاز لخلق مشادات ومشاحنات، وأقسم بالله العلي العظيم، أنني وإلى حد ذلك التاريخ لم أكن مدركاً بأن إتحاد طلبة الأردن يتبع حزب البعث، لكن أبشع صورة للمضايقات تكمن في التأثير على المستوى الدراسي، إذ وجدت نفسي أرسب لثلاث مرات في مواد كانت علاماتي فيها لا تقل عن خمسة وتسعين في المائة، وعندها اشار لي صديق بأن هذا يمثل الرد لعزوفي عن المشاركة في النشاطات الطلابية الحزبية، وكانت نصيحته (أن أهادن الوضع)، وبدأت السير فعلاً في هذا الاتجاه إتقاءاً لشرهم وحرصاً على مسيرتي الدراسية، ظناً مني بأن الأمر سيتوقف عند هذا الحد، وبالتالي أنجو بنفسي وأحصل على شهادتي الجامعية.. ويا ويلي إذ لم يخطر ببالي يوماً أنني لن أحصل عليها ! واستمرت سنوات الدراسة التالية دون مشكلات تذكر، سوى المماحكات والتعرضات من قبل مسؤولي الاتحادات الطلابية الذين كانوا ينعتونني بالقبلية والجهل والعشائرية وإلى ما غير ذلك، والأخطر في اتهامي بعدم استساغة فكر البعث، وعدم التحمس له كأيديولوجية، كان الأمر على هذا النحو خطيراً خلاف ما كنت أظن وأعتقد ! كانت لي حسابات خاصة مثل العودة إلى الأردن، ولا أريد خلق مشكلات مع السلطات الأردنية، فأحفظ خط الرجعة لنفسي وأخشى من المساس بأهلي أو حتى فقدان الأمل في العودة إليهم. ولما حدثت قصة مقتل ثلاث طالبات كرديات، بعد تعرضهن للاغتصاب، وقد تم العثور عليهن في منطقة صيداوة - غرب أربيل -، ضجت الجامعة بالمظاهرات، نما إلى علمي أن الحديث يدور عن أنني كنت العامل المحرك لهذه المظاهرات في كلية الآداب، والحقيقة أنني لست على هذه الفاعلية السياسية، ولست بقادر على تحريك الطلاب إلى هذه الدرجة التي يشيعونها إما عمداً أو جهلاً، أقول عمداً لأنهم يبيتون لي أمراً لا أعرف كنهة، ولا مداه، أو جهلاً من باب تضخيم الأمور لمجرد كوني غير موال لهم ولا متعاطف معهم.. وكانت نصيحة الأصدقاء مثلما هي دوماً: المشاركة في المسيرات التأييدية لإبعاد مثل هذه التهم عني.. وفعلت دون قناعة مني، والشيء الذي نفذته عن قناعة كان التبرع بالدم عن طريق المستشفى وليس الكلية لاعتراضي على طريقة الابتزاز التي يتبعونها. لم تكن لي في سنوات دراستي تلك من مخالفات -حسب تقديراتهم - سوى امتلاكي لوجهة نظر مغايرة لأساليب الإكراه التي يمارسونها، ولربما لم أكن مهيأً لأن أكون بوقاً لتوجهاتهم السياسية، ومع ذلك كله لم يخطر ببالي للحظة بأن هذا سيقودني إلى الجحيم وغياهب السجون، خاصة سجن “أبو غريب” الرهيب. ومضت سنوات الدراسة على هذه الشاكلة: الطريق الدراسي سالك، أما الطريق السياسي فهو سالك بصعوبة حتى هذه اللحظة، ما الذي سيجري لاحقاً ؟ سؤال لم يلح لي في الأفق لأنني لم أؤسس على هذه المشاحنات والمناكفات أمراً خطيراً سيصيبني، أو تهلكة تنتظرني، وبشكل عام وجدت نفسي ميّالاً للمطالعة والاستزادة بالقراءة فهل هذه أيضاً تهمة ؟ سرت في طريقي لا أعلم إلى أين وكل ظني أنني في المطار سأغادر.. ومن ثم ترافقني الوالدة “العجوز” كما نسميها، ولكن أوقفتني الدقائق الخمس (منذ منتصف الأول من تموز وحتى الحادي والعشرين من شباط 1998)، وحتى حين اقتادوني من المطار بعصابة سوداء على عيني، لم يدر بخلدي أنني في قبضة أجهزة أمنية، وتهيأ لي أن في الأمر أحقاداً شخصية أو قريباً منها مما يمكن تسويته خلال فترة قصيرة، أو أنه يمكن أن يماثل ما حدث لي في مرة سابقة، حين واجهت الطلبة الأردنيين (عفيف الروسان، منير حدادين، وحسام العمري) فقد اضطررت لضرب الأخير بآلة حادة بعدما أحكموا قبضتهم علي، وأذكر بعدها أنهم سعوا للمصالحة فرفضت كي يبتعدوا عن طريقي. ولكن الذي يجري اليوم مختلف، فأنا مساق إلى مكان مبهم ومن المسافة التي قطعناها يبدو أنه بعيد عن المطار، وبدأ سير الأحداث، أنزلوني من السيارة واقتادوني إلى غرفة حمراء، أدركت حينها فقط أنني في (مبنى مخابراتي) ومرت بي سريعاً الصور التي كان العراقيون ينقلونها لي عن هذه المباني.. توصيفات غريبة عجيبة.. وحكايات دامية، وها أنا الآن في أتونها ! مرت ثلاثة أيام طوال ومرهقة، في غرفة المحقق وأنا معصوب العينيين، أسمع: أنت تعرف ما نريده منك، ونحن لا نريد تعطيلك عن الذهاب إلى أهلك فتعاون معنا فعندنا كل شيء ! وفي مواجهة إنكاري قال: إذهب وفكر وعد إليّ بشكل آخر ! وبدأ الاستدعاء كل يوم لتتردد على مسامعي إهانات وطلبات بالاعتراف وسيل من التهم، ما هي علاقتك بالاكراد وما نوع الأسلحة التي هربتها لهم ولمن كنت تعطيها، ولمن وأين وزعت المنشورات ؟ وكم من مرة شتمت الرئيس ؟ ومع مواصلة إنكار أية علاقة لي بهذه التهم، كان التعذيب يزيد والأسئلة تزداد والخناق يضيق من حولي، ولما قلت: “إنك تكيل كل هذه الاتهامات لي لأنني لست بعثياً” قال منتصراً: “آه من هنا نبدأ.. لماذا أنت لست بعثياً ؟ على رأسك ريشة ؟ ونحن نضع فوق رؤوسنا أربعة الاف طالب فلسطيني، وأنت الوحيد الذي يتصور نفسه مختلفاً، ويطن نفسه بطلاً، لماذا تنازلت عن المبلغ المخصص لك كمنحة، وأنت تتنفس هواء العراق وتشرب ماء دجلة والفرات !”. وحاولت أن أشرح له بأنني إنسان بسيط، لا يقتنع بالانتماءات السياسية ولا يحب المزايدات، وبحسن نية وصفاء سريرة، قلت بأنني تبرعت بالدم ثلاث مرات لصالح المجهود الحربي، قال: “أنت تعيرنا بالدم الذي تبرعت به وقد اسأت للبلد بما يفوق الآف الليترات من الدم، وعليك أن تعترف على تنظيمك، وتقر بكل ما تعرفه عن التحركات السياسية للأكراد”، ولم تكن أجوبتي تجدي نفعاً لمثل عقلية هذا المحقق الذي أسرع لفتح الملف الساكن أمامه ليصرخ: “هاك التقارير التي تقول كذا كذا” قلت بأنني لم أطلق النار على رفيق حزبي، أو أفجر قنبلة في مركز شرطة حتى أكون على هذه الدرجة من الخطر.. توقفت الأسئلة والأجوبة كمادة حوارية وحلت محلها الضربات والفلقات والألفاظ النابية.. هذا هو منطق ولغة هؤلاء الذين هم ليسوا بشراً، ولا حيلة لي سوى الاستمرار في الصراخ والشتم والانكار، وبعد مضي إسبوعين.. قال لي المحقق: “ستقابل مسؤولاً مهماً وعليك أن تصرح له بكل شيء !”. قادتني السيارة المغلقة إلى مكان آخر، وإذا بي أمام فاضل البراك مدير المخابرات العامة آنذاك، وابتسمت أول ما وقع نظري عليه، فسألني عن السبب.. قلت أنا أعرفك من خلال محاضرة في جامعة البصرة، وكنت حينها أظن نفسي أمام شخص أكاديمي وليس مسؤولاً أمنياً، أجابني بنعم “ولكن هذا ليس موضوعنا”، وأضاف اسمعني جيداً أنت أمام المخابرات العراقية، ونحن نعرف بأنك على وشك الذهاب إلى أهلك، ولكننا نشرنا أخباراً بأنك مخطوف عند الأكراد، مع أخبار أخرى تقول بأنك قد قُتلت في أربيل، فلا مجال للتفكير، ولا مجال للتردد، بل عليك أن تختار: فإذا صرحت بكل ما لديك فستذهب إلى أهلك وإلا فلن يكون لك ذلك، ثم انك ما زلت لا تعرف المخابرات العراقية، ونحن نحترمك لأنك من قطر عربي شقيق، فاذهب وفكر جيداً. إنتهى اللقاء بعودتي إلى المكان الأول وبداية المرحلة السيئة: عمليات التعذيب من كابلات كهربائية وضرب وتشبيح وأساليب قاسية ووحشية، هذه العمليات استمرت لثلاثة أشهر ولمرتين في الأسبوع، كان معي شخص سويدي اسمه (وولف) وفتاة من النجف اسمها (ليلى)، عرفت أن وولف كان يدير شركة اتصالات اريكسون وقد اتهموه بالتعامل مع ايران وإسرائيل، ولهذا الشخص دور في حياتي، فزوجته وهي سيدة من (ترينداد) أبلغت أهلي بحالي حين كتب لها زوجها المعلومات باللغة الفلامنكية على صفحة من صفحات الانجيل، وزارتني والدتي بعدها، وصار معلوماً أنني في قبضة المخابرات العراقية، حيث كنت طوال الفترة الماضية مغيّباً حسب الحجج التي أطلقوها والأخبار التي نشروها. استمر التعذيب، وهم يتفننون في أساليبه وبدأت صحتي في التدهور، كانت العمليات التعذيبية بالكهرباء مؤلمة ووحشية، وتوصلني إلى مرحلة الهستيريا.. ولكن كل شيء الآن إنتهى، سوى آلام الكتفين جراء التعليق الذي كانوا يمارسونه، وكلما جاء برد الشتاء القاسي تضاعفت الأوجاع واشتدت علي الآلام. في نهاية الشهر التاسع، يستدعيني المحقق ليأمرني بالنظر إليه وفهم ما يقول: اسمع إن إعدام الفلسطيني لا يكلف الدولة العراقية سوى عشرة دنانير، قيمة الطوابع الملصقة على المذكرة حين أرفعها إلى قاضي التحقيق ! واستمرت جلسات التحقيق، وتتردد على مسامعي أوامر تقول: اعترف اعترف، ولما قلت لقاضي التحقيق بماذا اعترف ؟ قال بأنك شريف، ولما أجبته أنت القاضي وتخاطبني بهذا الشكل، وجه لي صفعة وقال: وقع. - على ماذا ؟ - عليك أن توقع على بياض ! ولأنني كنت في حالة من اليأس والبؤس، فقد وصلت إلى مرحلة التوقيع على أي شيء ! فقط، لكي أخرج من المكان، ولقد فكرت بالانتحار مرتين ولم أنجح، وكان حظي سيئاً حين اكتشفوا محاولتي الانتحار بحبل صنعته من بيجامتي، وهو الأمر الذي ضاعف من عذابي وتعذيبي (قواد تريد أن تموت قبل أن تصرح بما لديك)، ووضعوا معي شخصاً آخر في الغرفة، زارتني الوالدة وشرحت لها ما أنا فيه، ذهبت إلى هيثم أحمد حسن البكر، كي توكله محامياً للدفاع عني فاعتذر عن قبول التكليف. بدأت محاكمتي في محكمة الثورة.. التي تشبه ثكنة عسكرية، ولقد أصابني الرعب فيها أكثر مما كان عليه الحال في (الحاكمية)، وفي الصالة جلست إلى جانبي سيدة كردية.. أحضر العسكر المدججون بالأسلحة شباباً صغاراً في عمر 16 - 17 سنة، وكانوا يأخذون كل أربعة سوية، ومن المجموع لم يخرج سوى أربعة، سألت هذه المرأة باللغة الكردية: أين يذهب الآخرون ؟ فأجابت بأن الذي لا يخرج إلى هنا يذهب إلى الاعدام فهناك باب آخر. بدأت محاكمتي في قفص، وسألني القاضي عواد البندر: هل أنت متهم أم برئ ؟ فأجبته أنا طبعاً برئ.. فزاد القول بأن المحكمة هيأت لي محامياً، فإذا بالمحامي يقول (إن المجرم الماثل أمامكم) فاعترضت بالقول: اسمحو لي.. فأنا أدافع عن نفسي وقلت أنا طالب أردني جئت للدراسة في العراق، وربماكان الخطأ الوحيد الذي ارتكبته هو عدم الانتساب لحزب البعث، وهذا كل ما هنالك ! فقال لي القاضي: أهذا كل شيء ؟.. أنت متهم بالتآمر على البلد والتخريب ونحن نستطيع مداواتك ومداواة أمثالك.. واستكمل: حكمت المحكمة عليك حسب مادة 158أ، وأنا لا أعرف ما هي المادة 158أ، وبدأت أنظر حولي وأتطلع في وجوه الحراس الذين أخذوني إلى مبنى المحافظة أو أي مكان لا أعرف ! كان في القاعة حوالي خمسة وثلاثين شخصاً، وأُغلق الباب بأربعة أقفال، واقترب مني شخص ليسألني ما هي قضيتك ؟ فبادرته ما هو هذا المكان ؟ فقال لي إنه (قاطع الاعدامات)، وشعرت بنفسي لا أستطيع الحركة. جمدت في مكاني.. فأضاف الشخص: نعم، نحن هنا كلنا محكومون بالاعدام ! وننتظر التنفيذ.. واستطرد وأنت ماذا ما جرى معك ؟ قلت له: أنا لا أعرف، فقط حكموني حسب مادة 158أ، فاندفع الرجل إلى الخلف والدهشة تعتريه.. وقال على ماذا ؟ ثم أضاف: عادي هذا هو العراق ؟!! وصدقاً بدأت أفكر في أن ألحق نفسي، أن أصلي، وصليت دون أن أكون مقتنعاً بالوضع الذي أنا فيه.. اعترتني حالة من اليأس لا يمكن وصفها، وبدأت أرقب الناس من حولي، وكيف أنهم حين ينادون اسماً لشخص بيننا.. يبدأ هذا بالحركة ثم التثاقل.. ثم يقع ويسحبونه وو... يجرونه إلى مصيره.. تزامنت هذه الحالة مع تقديمهم لناطعاماً أفضل من الذي كان في مبنى المخابرات.. وظلت الوضعية على هذا النحو المرعب وأعداد الأشخاص تتناقص.. بقي حوالي أحد عشر شخصاً فقط، لا أعرف التاريخ، ولكن بعد ستة أيام من وصولي إلى المكان، نادوا عليّ وحلقوا لي شعر رأسي وذقني، وأخذوني إلى المحكمة نفسها، وأعيدت الديباجة ذاتها ولكن مع إضافة تقول “أنت لكونك من قطر عربي شقيق، خففناالحكم من درجة (أ) إلى (ب)، مع مصادرة أموالك المنقولة وغير المنقولة، فأنتقلت إلى السجن المؤبد، وأعادوني إلى مبنى المخابرات لحوالي شهر، وحينها زارتني والدتي، بدأوا باتباع أسلوب الحرب النفسية (الازعاج)، وهذا يتمثل في إخراج الموقوفين معصوبي الأعين في ممرات لساعتين، وهم يتعرضون للضرب من كل جانب وتنهال عليهم الشتائم والاهانات. تحولت إلى السجن الذي يغص بمختلف الجنسيات (سوريون وإيرانيون ومصريون وغيرهم) حوالي ثمانمائة أو الف سجين أغلبهم من المصريين، قواطع مختلفة ولكن السياسيين معزولون. بدأت والدتي تزورني بين الحين والآخر، ومن الذين انتقلوا معي إلى السجن إثنين من الفلبين وإثنين من بريطانيا، وأذكر وجود الطيار محمد مظلوم الدليمي في زنزانة مجاورة، وقد أوصاني بتوصيل رسالة إلى والدته (ميثا) وقد أوصلتها مع والدتي، أنا لا أعرف شيئاً عنه، كل ما قاله لي أنه كان مدير قاعدة جوية، وقد قام بثلاثة الاف غارة على إيران، وكان الذراع الأيمن لعدنان خير الله. كان رحمه الله متديناً وبطلاً في مواجهتهم، وأوصاني بتوصيل الرسالة إلى والدته. وكنت أعتبرها عبئاً وحمدت الله على أنني استطعت توصيلها. في السجن حاولت أن أبقى متحفظاً في علاقاتي، ومع ذلك لم أنجُ من خطر هذه العلاقات، فقد حدث أن تعرفت على سوريين مبعدين، وأحدهم كان يعمل بالتطريز والاشغال اليدوية (الخرز)، وفي أثناء زيارة لوالدتي اعطاها بعض هذه المشغولات، ولكنه ضمنها رسالة باسمي، وموجهة إلى الاردن لطلب المساعدة، وحين اكتشفوها سحبوني إلى مبنى المخابرات وابقوني لثلاثة أشهر تحت التعذيب، وبعد ذلك أعادوني إلى السجن، وبدأت المخابرات تعمل في داخل السجن على تجنيد الأشخاص للعمل معهم، فطلبوا مني العمل معهم، واذكر أنني قلت لأحد العاملين في السفارة الأردنية (من عشيرة الحويطات) وكان على معرفة بالأهل، قلت له حين زارني، يا أخي أحضر لي سماً كي أخلص من هذه الحياة، هؤلاء حكموا علي بالمؤبد والآن يريدونني أن أعمل لصالحهم، ما الذي يجري وهل الإنسان رخيص إلى هذه الدرجة ؟. بدأت فترات عصيبة في السجن جراء نقص الغذاء والدواء، وصار أسلوبهم هو المقايضة، كن معنا فنعطيك الدواء. كنا في هذه الفترة نخشى من الأمراض الصدرية (التدرن) وغيره، وكانت المضايقات تزداد وشدة الحياة تلفنا والمرض والجوع من حولنا، ولم يكن أمامي سوى الإنزواء والعنف، لا توجد أدوات حادة فكنت الجأ إلى قبضتي وأواجه استفزازاتهم بالضرب، مرة قمت بفك حديد السرير لإستعماله في الضرب، وسحبوني إلى مبنى المخابرات وبالغوا في الضرب والتشنيع، بعدها بقيت مع إثنين فلبينيين، و(بول سميث) الانجليزي و(يان ريختر) و(ولف السويدي)، وعلاقتي مع الأخير كانت هي الأقوى ومرة طرزت والدتي ثوباً فلسطينياً لابنته الصغيرة فكتوريا، وأذكر أن وولف خرج من السجن بمقايضة جرت مع طه محيى الدين معروف الذي كان يزو المانيا ثم السويد في ترتيب صفقات تكنولوجية، وكنت قد تراهنت مع وولف على أنه سيطلق سراحه، وكان رهاننا بمائة دولار، ومن ناحية أخرى وفيما يخصني لم تجر محاولات لمساعدتي، لا أحد يسأل عن أحد، والزيارات التي كانت تتم من أطراف رسمية، كانت لا تتجاوز نطاق الزيارة. والدتي هي الشخص الوحيد الذي سعى إلى مساعدتي والشخص الذي كان قد حاول مساعدتي بطلب من والدتي هو المرحوم عاكف الفايز الذي قال أنه على الرغم من أن علاقاته بالعراق سيئة إلا أنه سيحاول فعل شيء. مرت بي وجوه عديدة وعايشت حالات صعبة.. فنحن في مكان أقرب ما يكون إلى جهنم، فمثلاُ كنت أتمنى لو أن الأسرى الكويتيين الصغار الشباب ؟ والكبار في السن، النساء والأطفال، لو أنهم عادوا إلى أهلهم ولم ينتهوا بهذا الشكل المأساوي وأذكر أنه كان هناك اخوان سوريان، افتقدت احدهما يوماً فسألت عنه أخاه الذي قال بأنهم أعدموه بكل بساطة وسلموه لوالدته، كان هناك الكثير من الناس ومن جنسيات مختلفة، سعوديون وقطريون، وتهمهم تجاوز الحدود وأغلبهم رعاة غنم، لا يفقهون في السياسة وتوجه لهم التهم الكبيرة، والذاكرة لا زالت طرية وربما لو جاءت هذه التجربة متأخرة عن الوقت الحالي لاعتراها بعض الضعف، ولكني أحمد الله أنها جاءت الآن، لتجعلني في وضع نفسي مريح من حيث تفريغ هذه الشحنات المؤلمة والمؤذية التي كانت مختزنة في داخلي، هذه التجربة الرهيبة التي مررت بها عطلت حياتي بالكامل وغيّرت مساري، أنا لم استلم شهاداتي لحد الآن، وأذكر أن المحققين حاولوا ابتزازي مرة من خلال هذه الوثائق إذ قالوا لي بأنها موجودة لديهم وأنهم على استعداد لتسليمها لي لو أنني فقط تعاونت معهم ! وكان ردي بأنني لا أريدها ولست بحاجة إليها، وتبين لي فيما بعد بأنها مجرد لعبة، لأنني سألت زميلاً عن الأمر فأفاد بأن أوراقي ما زالت في الجامعة، وأنوي أن أذهب إلى اربيل قريباً لمتابعة وثائقي. بعد خروجي من السجن وعودتي إلى الأردن بدأت خطواتي للاستمرار في الحياة، وها أنا أدور من فلك إلى آخر، تزوجت بعد إلحاح الوالدة التي تعرضت للكثير من المعاناة خلال سنوات سجني الطويلة، فهي إمرأة عجوز ومتعبة كانت تقطع الطريق الطويل وتبحث كل يوم عن طريقة تساعدني فيها، وتنقذني من الهلاك الذي كنت فيه، وكانت تعتبر عودتي إليها كأنها هدية من السماء، وبالتالي فإن الزواج يرضيها ويمنحها السعادة والاطمئنان، ورزقت بطفلة. هي الآن صغيرة، هذه هي الحياة، ولا يمكنني أن أنسى عذاب أمي طوال هذه السنوات وما تعرضت له من اذلال على أيدي الحراس. وأذكر الأردنيين الأربعة الذين أُعدموا بحجة تهريب قطع غيار السيارات فقد نجا من المجموعة فتى صغير اسمه (عماد الدين)، وأول ما لفت نظري أن شعر الفتى أشيب، هذا الفتى استضافه السجين محمد زياد الزبن، وحكى لنا أن التهمة كانت أن الذين تم إعدامهم كانوا قد اشتروا سيارة ومعها قطع، غيار وأن السلطات العراقية عند التفتيش اتهمتهم بالتهريب، لكن الفتى قال إن الأمر هو غير ذلك، فإن في عجلات السيارة (ديسكات) كمبيوتر للتصنيع العسكري، وأنهم استعجلوا بإعدامهم، ونفى أن يكون الأردنيون الذين أعدموا على علم بهذه المواد في سيارتهم. بدأت مسألة الاعدامات تصل إلى مسامعي مبكراً فقد تم اعدام طالب اسمه (مفلح محمد الصانع) في السنة الرابعة كلية الإدارة، وكنا نعرف بهذه الحالات من خلال التعميمات الحزبية، وأُعدم طالب آخر من يعبد - جنين واسمه (عصام أحمد العبادي)، واختفى طالب اسمه (حسن قاسم) من إربد ولم نعرف مصيره، والأكراد كانوا يواجهوت الإعتقال والضرب والطرد وشتى أنواع الاضطهاد. كانت هناك مواجهات عديدة بينهم وبين سلطات الأمن العراقية، فقد كان الأكراد يقومون بعمليات مهاجمة للمقرات الحزبية والمراكز الأمنية، ويغتالون رجالات الحزب والمخابرات، ويختطفون الطلاب البعثيين ويقومون بتصفيتهم، بعض حوادث الخطف كانت تنال الطلاب العرب ولكنها لا تصل درجة القتل. أمور كثيرة عايشتها وذكريات لا تزال مختزنة، منها المفرح ومنها المؤلم، وفي كل الأحوال لم يكن يخطر ببالي يوماً أن أصل إلى درجة حكم الإعدام، ومن ثم العيش في السجن لسنوات طويلة تحت وطأة الحكم المؤبد، هذا المصير الأسود الذي لحق بي دون أن أعرف كيف، ولماذا بدأت خطواته سريعة ومتلاحقة، هل يمكنني التساؤل اليوم بأنه حظ عاثر ؟ الصليب الاحمر كان يزورنا بين الحين والآخر، وبشكل غير منتظم، ويحمل إلينا بعض المساعدات، ونسّرب من خلاله بعض الأخبار أيضاً، ولكن هذا الأمر كان ينقلب علينا في أحيان كثيرة، فقد وجدت أنّ أحدهم سّرب رسالة مني إلى المخابرات، فصدف أن كان أحد منتسبي المخابرات يمتلك “ضميراً”، إذ حفظ القضية عنده وحذرني من مغبة مثل هذا الأمر، الذي يفتح عليّ أبواب جهنم وتهماً أمنية خطيرة. كانت الرسالة آنذاك بخصوص الأسرى الكويتيين، وأذكر أنني فوجئت بمنظر بعض الأسرى الكويتيين، حين كنت أوزع الطعام على مجموعة من السجناء قيل لي بأنهم من حزب الدعوة الإسلامي المحظور في العراق آنذاك، منظر هؤلاء كان رهيباً أشبه بوحوش تائهة أو أناس من القرون الوسطى، أشكال بدائية اعتراها الهلاك والارهاق، ولما اقتربت من أحدهم وسألته قال لي بأنهم كويتيون، ومرة أخرى سمعت منه عن رحلات التنقل والتشتيت التي كانوا يسيرونهم فيها لاخفائهم عن أعين لجان التفتيش، فمرة في العمارة ومرة في كركوك وأخرى هنا، كان ذلك في آذار من عام 1995 . وأذكر كيف أن بعض الإيرانيين كانوا يموتون من الجوع على الرغم من أن الصليب الأحمر كان يبعث لهم الطعام، أنا وسجين آخر سجين وجَّهنا إثنين من الإيرانيين وجهة القبلة عندما ماتا، ومرة مات أحد السجناء السودانيين بعد أن تورم جسده جراء غياب العلاج. مسألة الموت في السجن طبيعية، لقد كنت دائم الخوف من المرض بعد أن انتشرت الأوبئة وخاصة التدرن، فلا إشراف طبي ولا أدوية ولا غذاء. لا شيء سوى الموت مصيراً محتوماً، ومع ذلك، وعلى الرغم من كل القسوة والوحشية، ودوماً كان عندي بصيص من الأمل في أن ينكسر الطوق من حولي وأعود للحياة مرة أخرى، اقول هذا وقد بدأت المشوار يائساً: نعم، فأنا في البداية فكرت في الانتحار ونفذت محاولتين لم تنجح واحدة منهما، فهل كان ذلك (حسن حظ أم أنه العكس) ؟ لا إجابة لدي سوى أنه كان مقدّراً لي التحرر من سجون الطغيان، لأروي تجربتي وقد يكون في الأمر ما هو (مقدّر) من الله كي أنوب في الحديث عن ألوف البشر الذين غيّبتهم الإعدامات والقتل والتعذيب، وما نطقوا.. وما كان لهم صوت في هذه الدنيا فقد تحولوا إلى أرقام وأسماء وذكريات أو هم جملة مآسي على صفحات كتاب.
عدنان محمد عبد القادر جبارين مواليد عام 1957 إلى روح الصديق ابن الخليل.. الشهيد محمود يونس عطيه.. لم تستطع أجهزة قمع صدام النيل منك.. ورحل النظام وتصر عصابات الديكتاتور على اغتيال حلمك وحلم كل الذين تنفسوا حرية الحياة بعد رحيل النظام البائد.. لتصعد روحك.. شهيداً في جنان الخلد. إلى أرواح الشهداء... الرجال: - محمد ثنيان الغانم - الكويت - ناصر عويهان العنزي - الكويت - كامل مصطفى الزبيدي - العراق - هيكل الجبوري - العراق - محمد مظلوم الدليمي - العراق - رائد الزوايدة - الأردن - الدكتور مروان النقشبندي - سوريا - سرمد هوشيار - كردستان - جليل مهدي النعيمي - السويد إلى أرواح كل الشهداء الشرفاء الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم لتكون قناديل تضيء دروب الظلام الصدامية.. حتى تُحرر العراق.. وتُحرر كل المظلومين. لقد كان فيكم أصدقاء تعاهدنا أمام الله، بأن من تكتب له النجاة، عليه أن يبلّغ الرسالة اللهم فاشهد، أنني بلغت الرسالة، وحملت الأمانة، ليطلع عليها كل البشر عن معاملة عدو البشر صدام وزبانيته لخيرة الرجال الذين لا يعرفهم إلا من عاش معهم في دهاليز أقبية النظام.. وسامح الله من كان ولا يزال ينتظر صورة صدام على القمر ليحرر القدس. عدنان جبارين وصلت العراق عام 1978، وأكملت دراستي عام 1981 في كلية الهندسة، جامعة بغداد، وعملت مباشرة بعد التخرج مع شركات كويتية: (شركة المنصور والعبدلي، الشركة الوطنية العالمية وغيرها)، حتى عام 1990، حين حدث لي ما لا أتوقعه في أعقاب غزو الكويت بيوم واحد، ففي صباح 3/8/1990 اعترضت سبيلي سيارة مخابرات، تحمل أربعة أشخاص طلبوا مني مرافقتهم لخمس دقائق (كما هي العادة لدى اعتقال أي شخص)، وقد تمتد هذه الدقائق الخمس لعشرين عاماً أو تقود إلى الإعدام، ولأول مرة اكتشفت أن المبنى الذي أمر من أمامه يومياً في شارع 52 هو عالم خفي لنظام صدام حسين القمعي، حيث يرى الإنسان فيه ما لا يعقل وما لا يصدقه بشر، وهذا المبنى يسمّى حاكمية بغداد.. أو كما هو متعارف عليه “الحاكمية” وهو المخصص للتحقيقات. ما أن تصل السيارة حتى تتلاقف الأيدي القذرة القادم الجديد، وتبدأ الاعتداءات، ويجري تعصيب عينيه إلى أن يموت أو يشاء الله له بالخروج.. هذه المواجهة أو هذا الاستقبال غير موجود في أي مكان في العالم أو لدى أي نظام.. فبمجرد دخول الشخص إلى المكان تنهال عليه الضربات ومن ثم يطلب منه نزع ملابسه ووضعها في كيس ليلبس بيجامة، هي لوحة فنية من كثرة الأسماء المكتوبة عليها، كم مسكيناً قبلي لبس هذه البيجامة القذرة ؟ وماذا حلّ به ؟ وأين هو الآن ؟ وينغلق ذهني عن التفكير أو التساؤل... فهل هذا وقته ؟ أعطوني نعالاً بلاستيكياً ممزقاً، وكل فردة منه بنمرة مختلفة ! وغالبية السجناء يمضون إلى مصيرهم حفاة، وقد ساقوني إلى محكمة الثورة حافي القدمين ؟ جرى الاستقبال الأول على هذا النحو، ليبدأ التعذيب النفسي ويقودني الحارس إلى زنزانة صغيرة قذرة، لها شباك حديدي عبارة عن فتحة في الباب، لون الزنزانة البني العفن يجلب الكآبة. بدأت السهرة ليلاً إذ قادوني إلى الطابق الأول، حيث توجد غرف المحققين، أجلسوني على الأرض، أسمع من حولي أصواتاً دون أن أميز شيئاً، وجاءني الصوت يقول: “أنت متآمر على العراق، لا أحد يمكنه فعل شيء لك ولن تتمكن من الخروج من هنا، لماذا أنت لا تبارك عودة الكويت إلى حضن العراق الأم ؟ وقد بارك ذلك كل العرب والفلسطينيين الشرفاء !” وزاد بالقول: “دخلت العراق وأنت لا تملك شيئاً، فهل طغت عليك مصالحك الشخصية وأعمالك مع الكويتيين إلى درجة أصبحت لا تميز فيها بين الحق والباطل ؟ لقد تحولت إلى عنصر فاسد يخرب كل ما حوله ومن حوله، والعراق قدم كل شيء من أجل فلسطين.. ويزيد ويعيد.. ويوجعني بالكلمات والأسئلة، واخترق مسامعي سؤال: من أين لك كل هذه الأموال ؟ ولماذا تنحصر أعمالك مع الكويتيين؟ ولما كنت لم أزل قادراً على الرد والعناد، وبكامل قواي البدنية على الأقل، وتتملكني قناعة بأنني قادر على الدفاع عن نفسي، رددت وقاومت، ولكنني كنت أتلقى الضربات من كل جانب وتنهال علي الشتائم القذرة وعبارات التجريح التي تقطر سماً وحقداً، وتناهي إلى سمعي الصوت الأول يقول: انزلوه إلى العمليات.. دون أن أدري ماذا تعني (العمليات) ؟! وضعوني أول مرة في تابوت، وانغلق الباب عليّ فشعرت بأن حياتي انتهت، لكن وجود ثقوب في التابوت تمنح الهواء فرصة التسلل إلي كانت كفيلة بإبقائي على قيد الحياة، أو تأخير الموت على أقل تقدير، مع أنني في تلك اللحظة كنت أتمناه سريعاً، وبدأت تطرق سمعي صرخات الآخرين تحت التعذيب، وآهات لا أدري من أين ؟ وما الذي يجري لأصحابها.. معاناة جنونية تدور من حولك فتحاول كسر التابوت، لكنهم فتحوه لأرى فتاة عارية معلقة على الجدار وكابلات الكهرباء تحيط بجسدها، وبدأت الركلات تصيبني من كل جانب ترافقها الضربات بالعصى والكرابيج والصوندات (أنابيب المياه)، وهذا اختراع مخابراتي عراقي، لم أعد في حالة من التوازن.. وتدريجياً أفقد طاقتي وقدرتي على التحمل.. يجري كل ذلك وهم يدفعون بي إلى غرفة مجاورة كي تبدأ حفلة التعذيب بالكهرباء.. ولم أفق من غيبوبتي، إلا وأنا في الزنزانة والطبيب يقف فوق رأسي وبالطبع، لا يوجد تقدير للزمن.. فكم بقيت في التابوت أو كم من الوقت استغرق تعذيبي بالكهرباء.. وكم وكم ؟ أفقت لأسمع نصيحة الطبيب لي بالإعتراف كي أخلص من هذاالعذاب ! وفي صبيحة اليوم التالي، قادني الحارس، وأنا معصوب العينيين، وأنزلني إلى غرفة المحقق، ليركلني كي آخذ مكاني في وسط الغرفة، وسمعت ضحكات الاستهزاء والسخرية من حولي، وقال أحدهم بكلمات نابية “أحضروا زوجته”، ووجدت نفسي أصرخ: لقد أضعنا فلسطين وتشردنا في بقاع العالم، ولم يتبق لنا إلا العرض والشرف، فاكتب ما تشاء، وأنا أوقع عليه.. والتهديد بأحد أفراد العائلة، هو كارثة حقيقية، وعامل ضغط لا يمكن لأحد أن يتحمله، وأما عن الزوجة أو البنت أو الأخت فهو المس بالشرف وهؤلاء لا يقيمون للأعراض وزناً. أوراق كثيرة وضعوها أمامي.. كل شيء جاهز.. أعطوني القلم ورفعت العصابة عن عيني فأعادوها، وبدأت التوقيع دون أن أدري على ماذا أنا أوقع ! أوراق لا يعلم ما بها إلا الله وسمعت صوتاً جهورياً يقول: “أذهبوا به إلى قاضي التحقيق لنفرغ منه، فقد بدأت جماعة الكويت بالوصول، وذهبت إلى قاضي التحقيق ليسألني: يا بني هل اعترفت بمحض إرادتك أم أنهم أجبروك ؟ هل أجبرك أحد على شيء ؟ - لا معاذ الله (قلت في نفسي) وقلت له لا، لقد فعلت ذلك دون إكراه ! كنت أريد إنهاء هذه المسرحية بأقصر وقت ممكن، ووقعت أوراقاً أخرى بذات الطريقة التي جرت سابقاً ليقودني الحارس إلى زنزانة يقبع فيها أربعة من الإيرانيين والأكراد، قالوا أنهم قد أُخلوا من الجناح المقابل ليسكنه مجموعة من القادمين من الكويت.. وهذه الزنزانة مربعة الحجم متر ونصف وليس فيها سوى ضوء صغير، وفي ساعة متأخرة من الليل سمعنا وقع أقدام تقترب من الباب وهذا بحد ذاته يثير الرعب، فمتى كان هناك وقع أقدام في الممر، فإن الأمر يعني أنهم سيأخذون أحدنا ! والكل يتسمّر متى توقف الصوت أمام باب زنزانته.. تمنيت الموت في تلك اللحظة.. فلماذا لم يخطفني الموت قبل أن أصل إلى هنا ؟! فتحت “الطاقة” لأرى وأسمع حواراً بين أحد الحراس، وفتاة اسمها (ندى)، قال لها: ماذا تريدين ياندى ؟ أجابت: أريد بنطالاً فالباب يُفتح عليّ في كل لحظة، كما أريد فوطاً نسائية، وهنا انهالت على مسامعنا كلمات وتعليقات تقشعر لها الأبدان ! نعرف الصباح من المساء من عربة الطعام، فالفطور عبارة عن الشاي وصمونتين، والغذاء شوربة العدس، وفي العشاء يقدمون لنا شوربة الملفوف، ولعلّ من حسنات هذه العربة أنها تعلمنا بالتوقيت، وهذا أكثر أهمية من طعامهم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ! مضت على هذه الحال أيام وأيام، فإذا أنا في صباح الثاني والعشرين من آب، وأسير برفقة الحارس معصوب العينيين طبعاً ومكبّل اليدين وفي طريقي إلى محكمة الثورة.. أوقفوني أمام “عواد البندر” رئيس محكمة الثورة، والذي عين فيما بعد محافظاً للرمادي، قال عواد البندر: لقد عينت لك المحكمة محامياً وأجرته ثمانية دنانير (هذه هي التسعيرة المتعارف عليها)، وشرع المحامي بالقول: إن هذاالمجرم الماثل أمامكم، يستحق حكم الإعدام لكن العراق لا يعدم الفلسطينيين، ولذلك أطالب بتنزيل حكم الإعدام إلى المؤبد !. هذا إيحاء بمنح الفلسطيني تشريفاً خاصاً.. ولكن كيف يتوافق هذا مع ما يقوله المحقق لكل فلسطيني يمر عليه “إن إعدام الفلسطيني لا يكلف الدولة سوى عشرة دنانير، هي قيمة الطوابع”. المهم.. أن عواد البندر نطق على الفور بالحكم: “حكمت محكمة الثورة بالسجن المؤبد على المجرم لمساسه بأمن العراق والتآمر على أرضه”، ومباشرة صعد أحد الحراس ليسجل كل ما لديه من أقوال وممتلكات ذلك أن أموالي المنقولة وغير المنقولة قد تمت مصادرتها ! الحارس يسجل والتعليقات المهينة تنهال عليّ من كل جانب وأقلها “فلسطيني خائن” و”جئت إلى العراق حافياً واليوم تملك ثروة، كل شيء سيعود إلى مكانه !”. وأذكر أن من ضمن الأوراق التي وقعتها شيكات لسحب أموالي في البنوك، أخذوني مرة أخرى لأجد نفسي أمام المحقق “محمد المعيني” المسمّى جزار الفلسطينيين والكويتيين، والذي قال لي: “مبروك أبو غريب، مبروك لقد انتهى كل شيء، وعليك أن تخلع ساعتك وخاتم الزواج فهذه من أموال العراق وأنت لاتستحقها ! ولما أجبت بأنها من تعبي وعملي، قال لقد أخذتها من عملك مع الكويتيين والكويت أرض عراقية، وكل ما عليها وما فيها هو للعراق !! أصبحت للمرة الأولى في مواجهة أصوات أرى أصحابها، وكنت من قبل اتخاطب مع أشباح وأذكر من أسماء المحققين “رعد ومحمد النداوي وجزار الحاكمية محمد يحيى هزاع التكريتي الذي كان سبباً في إعدام الكثير من الفلسطينيين، وصاحب القول المشهور “إعدام الفلسطيني لا يكلف الدولة العراقية سوى عشرة دنانير”، تسلمتني إدارة سجن أبو غريب في اليوم التالي وأودعوني في قسم العرب والأجانب - القسم رقم (1) الخاص بالقضايا الأمنية والسياسية، وفيه وقعت عيناي على أشباح بشر، هياكل آدمية تتشح باليأس والبؤس، وكأنها مخلوقات من العصر الحجري، مضى على وجودها في المكان سنوات طوال.. هنا أناس غريبون وغرباء عني، فليس المكان وحده هو الغريب.. وبدت الأجواء لي متوترة ومقلقة وقابلة للانفجار في أية لحظة.. وكان كل ما مررت به في الفترة الماضية قد أرهقني وسحق روحي ومحا إنسانيتي، ودار في ذهني أيضاً أن يكون المكان مزروعاً بالجواسيس لتبقى دائرة الاتهام مغلقة من حولنا قد يكون ذلك ممكناً.. فقد سمعت عن سجناء أعدموا من بعد محاكماتهم ووصولهم إلى أبو غريب، حيث رتبت لهم تهم جديدة ظلماً وعدواناً - مسبقاً أعرف أنني في دائرة جهنمية محكمة الاغلاق.. كيف أتصرف وماذا أفعل ؟ وكيف ستمضى أيامي ؟ ترى ما هي الطريقة التي يجب عليّ اتباعها لكي أتعامل مع الموجودين هنا سجناء وسجانين - كل هذه الأسئلة المقلقة تدور وتدور ولكن دون جواب، وفي هذه الأثناء عرفني أحد السجناء الفلسطينيين والذي كان قد “سكن” أبو غريب عام 1983، وكان يعيش بكلية واحدة ومعاناته مع المرض رهيبة، واسمه أبو عزيز القدومي توفي في شباط من هذا العام.. وكان من المفترض أن يروي حكايته في سجون النظام العراقي السابق، في هذا الكتاب، ولكن شهادته -رحمه الله- غابت معه، وقصة هذا الرجل غريبة، فقد كان يعمل مهندساً في شركة كويتية لها تعاملات مع شركة برازيلية لها أعمالها في العراق - فاتهموه بأنه عميل للبرازيل ! وحقيقة الأمر أن الرجل كان معارضاً لأسلوب النظام في العراق، هي مكيدة أوقعوه بها لتجريده من أمواله.. أما التهم فهي غريبة وعجيبة ولكنها دائماً جاهزة ومفصلة حسب قياس الشخص.. تهم لا يصدقها العقل والإعدام والمؤبد أحكام ليست بحاجة إلى مبررات، فقد يقع شخص في خانة “المغضوب عليهم” لمجرد انتقاد مسألة أو قرار لدى النظام. أخذوني بعد ذلك ليحلقوا لي شعر رأسي وذقني التي بقيت على حالها طوال هذه الفترة، وألبسوني ملابس جديدة، غير البيجامة “اللوحة التاريخية” وشربت أول فنجاني شاي وقهوة منذ أكثر من عشرين يوماً.. تمددت على الأرض وبدأت استفيق من حالة الذهول التي اعترتني، وقلت لا بد لي أن أنفض عن نفسي وقع الصدمة، وكان أول ما خطر ببالي هو مصير عائلتي، ما الذي حل بهم ؟ أين هم الآن ؟ وهل استطاعت زوجتي وأمي تحمل ما جرى لي ؟ وعلى الفور خطر ببالي سجين جزائري كان معي في الحاكمية، وقد قطعت عهداً على نفسي أن أذكر هذه الحادثة ما حييت، اجتمعت بهذا الشخص أمام قاضي التحقيق، وكان الرجل يتمتم بآي من الذكر الحكيم، فسأله المحقق: ماذا تقول له ؟ قال: أنا لأا أحدث أحداً فأعاد السؤالي علي: ماذا يقول لك ؟ قلت: إنني لا أعرفه ولا أرى أصلاً من هو بجانبي، وحين قال الجزائري بأنه يقرأ بعض سور القرآن وآية الكرسي، قال المحقق: هذه الآيات لربك، وربك لا يجرؤ على دخول هذا المكان فهنا لا يوجد ربنا ولا آية الكرسي ! وبدأت استعرض مسيرة حياتي وشريط ذكرياتي، فخطر ببالي ما كنت عليه في سنوات الدراسة الجامعية، وعملية الضغوط التي يمارسونها على الطالب لكي ينتمي إلى حزب البعث، وكيف أنني كنت أقول لهم لا يمكنني الانخراط في تنظيم سياسي وأهلي في الأرض المحتلة، وسلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعامل مع الطلاب الذين يدرسون في العراق بشكل قاسٍ، ولم أكن أشارك في الفعاليات الخاصة بالحزب ولا بأنشطة الاتحاد الطلابي، وكنت أحاول جاهداً الابتعاد عن الحلقات الفلسطينية المقربة منهم، ومعظم التنظيمات السياسية الفلسطينية آنذاك كانت متواجدة على الساحة العراقية، نعم كانت لي علاقات إجتماعية جيدة وواسعة النطاق، وهذه كانت وراء نجاحي في عملي، وأذكر أنني بدأت العمل مبكراً وأثناء دراستي من خلال مكتب استشارات هندسية يتبع الجامعة، ولكن عودة إلى نقطة التنظيم الحزبي، وهي مهمة جداً في حساباتهم، إذ يزعجهم ويقلقهم ألا ينتمي الطالب العربي بوجه عام، والفلسطيني بوجه خاص على اعتبار أن نظام العراق هو الوصي على القضية الفلسطينية. فهل كانت نقطة التقاطع معهم قد بدأت من الجامعة، أو هي بسبب رفضي لاحتلال العراق للكويت، وقد اصطدمت في هذه القضية مع كثيرين، وعبرت عن ذلك مراراً خاصة وأن الآفاً مؤلفة من شعبي الفلسطيني أصبحوا معلقين في الهواء، فقدوا مورد رزقهم وإمكانية تعليم أبنائهم وتشتت أسرهم وو... الخ، وأقلقني مصير هؤلاء، والأسوأ من ذلك أنني ولربما عرفت في السجن أموراً أكثر مما كنت أعرفه وأنا في الخارج، ومنها أن أي فلسطيني أختفى أو أعدم فإن ذلك تم في العراق، وأي عربي له مفقود فليبحث عنه في العراق ! وعدت أفكر بأن يكون سبب ما جرى لي هو انتقادي لعملية غزو الكويت، وكنت أقول ليقنعني أحد بجدوى هذه الفعلة ؟ هل دارت الكرة الأرضية وصارت القدس مكان الكويت ؟ من هنا بدأت المكيدة للايقاع بي، خاصة وأنني لم أكن من “المطيعين” في السابق،.. هواجس، أفكار، أسئلة، مراجعات للحوادث والأمكنة والمناقشات وغيرها كل هذا وأنا في يومي الأول.. فكيف ستمضي السنوات العشرون ؟ أساليب التعذيب متنوعة وتجري حسب مزاج المحققين فمنها ما يكون تسلية، ومنها الانتقام أو تصفية الحسابات الشخصية، فقد يحقد عليك أحدهم لما أنت عليه من حال النعمة أو المستوى الاجتماعي.. أو أي شيء فلا مقياس ولا اعتبارات كما أنه لا توجد حاجة للأسباب والمبررات في كل ما يفعلونه.. هم هنا يستطيعون فعل أي شيء وتجاه أي شخص، فلا يردعهم رادع. أما إذا نظرت حولك ووجدت أناساً مضى على وجودهم سنوات طويلة وعانوا الكثير من الويلات فإن اليأس ينتشر في عروقك إنتشار النار في الهشيم، وتفكر بنفسك.. وتعود إلى السؤال الأول: كيف سأمضي سنواتي هنا ؟ كل ما يجري من حولك غريب فترى وتسمع حالات وقصصاً رهيبة.. وكنت دوماً أتعرض للتعذيب بسبب ردودي على المحققين، ولا شيء أخاف عليه بعد اليوم.. وخاصة بعدما علمت بمغادرة أسرتي عن طريق مساعدة السفارة الأردنية، وقد جاءت والدتي في أواخر شهر أيلول لزيارتي، وهي في حالة يرثى لها. وكنت قبل زيارة والدتي لي، قد كلفت أهل أحد السجناء السوريين للذهاب إلى منزلي ولما عادوا في الزيارة التالية ليقولوا أن البيت مقفل بالسلاسل وان سكان المنزل قد رحلوا.. ارتاح بالي، أما توصيل الخبر لأهلي فقد كان عن طريق أحد الأصدقاء الذي زارني مرة وحيدة، فقد كانت الزيارة وبالاً عليه وتعرض للمساءلة. وتأتي والدتي المسكينة إليّ محملة بالهم والقلق.. ابنها الوحيد يقبع في أقبية السجن وتحكم عليه قبضة أجهزة القمع الأمنية، كما أنها هي الأخرى عانت في رحلة قدومها إليّ، إذ ذهبت إلى معارف لنا فاعتذروا عن استقبالها، واضطرت للمبيت في فندق حتى يطلع الصباح، ونصحتها بالعودة سريعاً خشية بطش هؤلاء الجلاوزة.. روت لي الوالدة رحيلهم السريع من بغداد وسرقة المنزل في أعقاب ذلك.. واستمرت والدتي في زيارتي مرة كل شهر ثم كل شهرين، ولما ازداد الارهاق المادي على العائلة، باتت توافيني مرتين في العام وفي أحيان أخرى مرة واحدة، وتطورت خبرتها في ذلك فباتت ترسل لي المعونات مع أهالي السجناء الآخرين القادمين لزيارة أبنائهم، كانت الرحلة، أو الزيارة بالنسبة لها مشقة وهي أساساً تعاني من متاعب صحية، كما أنها كانت تعود في كل مرة مريضة، والأسوأ أن أحداً في العائلة -غيرها- لم يكن يجرؤ على القدوم إليَ مخافة أن يتعرض لمشكلات، وجهاز المخابرات لا يتورع عن فعل شيء على هذا الصعيد. كنت عرضة للعقوبات مثل الحبس الانفرادي والحرمان من الزيارة، وغيرها من العقوبات بسبب مواجهتي لبذاءة المحققين، وقد ازددت شراسة من بعد زيارة الصليب الأحمر عام 1992 . كانت المرة الأولى التي يزورنا فيها ويسجل اسماءنا، وهذا شيء مطمئن، لقد حزت على رقمٍ دولي ومع العلم بأن هذا ليس كافياً عند النظام أو مانعاً له عن تصفية أي سجين، ولكنه يعني وجود جهة دولية تسأل عنا كلما زارت السجن، وكان الصليب الأحمر يهتم بالسجناء ذوي التهم الأمنية والسياسية، كان الوضع المعيشي داخل السجن أفضل مما هو عليه في الحاكمية، أو أي مقر آخر للمخابرات، والسجناء فيما بينهم يتعاونون على الشقاء، ويتبادلون المواد التموينية فيما بينهم، وخاصة المحظوظين الذين يزورهم أهلهم.. فهناك من ليس له أهل، وأغلب هؤلاء من الفلسطينيين والإيرانيين الذين يضطرون للعمل داخل السجن ليحصلوا على وجبة طعام أو يتمكنوا من شراء شيء، والعمل يتضمن الحياكة والأشغال اليدوية أو القيام بأعمال النظافة، والبعض من السجناء يمتلك موارد مالية من أعمال خارج السجن، فتعينهم هذه الموارد على ما هم فيه، وإلى هنا والأمور المعيشية نوعاً ما هي أما معقولة أو مقبولة، ولكنها بدأت في التدهور بعد حرب تحرير الكويت، وبدأ السجين يدفع ثمن الأقفال والتصليحات داخل السجن ويجبر على دفع الرشاوي للسجانين وإلا فإنه عرضة للإذلال والضرب، وتعدى الأمر ذلك إلى دفع أثمان الكهرباء والماء والصابون، وحتى السرير الذي ينام عليه السجين، فهذا له ثمن وإلا فإنه مضطر للنوم على الأرض. السجانون يطلبون المال والطعام والهدايا منا.. وكل من يأتي أهله لزيارته عليه أن يدفع ويعطي مما لديه من مواد وأطعمة ! وكان من ضمن العقوبات، نقل السجين إلى وسط السجناء غير الأخلاقيين المحكومين بتهم الزنا بالمحارم واللواط والاجرام والمخدرات وغيره، وهذه عقوبة مزعجة جداً، علاوة على أن السجين يشعر بالطمأنينة وسط جماعته، وفي المكان الأول الذي وصل إليه، فألفة المكان والرفقة والقواسم المشتركة تمنح نوعاً من الأمان، ولذلك فإن عقوبة النقل هذه على أقل تقدير تزعزع الأمان الشخصي، ونتيجة تدهور الأوضاع المعيشية ونقص الرعاية الصحية انتشرت الأمراض بين السجناء، وخاصة التدرن الرئوي وفقر الدم والأمراض النفسية، وأمام الأمراض ونقص الغذاء والدواء وتفاقم اليأس من تحسن الأوضاع، انتشرت الصراعات والانحرافات وهذا ما يريده السجانون ويشجعون عليه، فهم يغذون هذه الصراعات ويبثون أعوانهم لإثارة الفتن والمشكلات غير الأخلاقية. وجدير بالذكر أن إدارة السجون كانت تتبع وزارة العمل مع وجود مكتب ارتباط للمخابرات في داخل السجن، هذا الضابط يرتبط به السجناء السياسيون في تسيير أمورهم، وكان المتنفس الوحيد هو إدعاء المرض والذهاب إلى المستشفى، وهذا ما كنا نعده “سياحة” يتيح لنا رؤية الدنيا والاختلاط بالباعة والناس في الطريق ومعرفة الأخبار، رحلة المستشفى تستغرق نصف ساعة مشياً على الأقدام، وأبو غريب عبارة عن مدينة صغيرة مغلقة، لكن المؤسف في الموضوع أن بعض الحراس يرفضون مرافقة السجين السياسي خوفاً من هربه، وهذا يكلفهم ثمناً غالياً.. والثمن هو حياتهم، ولذلك كان علينا أن نسترضي هؤلاء الحراس على الدوام كي يرافقونا ويطيلوا الرحلة في الطريق، وكذلك الحال مع العاملين في المستشفى كي يمددوا الوقت باجراء فحوصات وتحليلات أو صور للأشعة، وبهذه الطريقة زرنا قسم الإعدامات والأقسام المغلقة التي يسمونها “الأحكام الثقيلة”، وشاهدنا بشراً مضى على وجودهم سنوات دون أن يروا الشمس، هناك طوابق تحت الأرض تعج برجال الدين من الشيعة وآخرين من كبار الحزبيين، إضافة إلى الكويتيين، وهؤلاء قصتهم قصة فقد كانوا ينقلونهم من مكان إلى آخر، من ربيعة في شمال العراق إلى العمارة في جنوبه، ومن الشرق إلى الغرب. وفي أثناء الاستعداد العراقي لحرب الخليج الثانية، أي مواجهة أميركا والتحالف الدولي، سرت الشائعات بالافراج عنا ولكن ما جرى هو الآتي: تأتي لجنة من المخابرات تطلب منا التطوع في الجيش العراقي من أجل التصدي لجيوش التحالف، التي أنذرت العراق بالانسحاب من الكويت، وهددت بشن الحرب عليه إن لم يفعل، نحن السجناء الذين سحقوا تحت كرابيج المخابرات وزهقت كرامتهم يُطلب منا التطوع للدفاع عن العراق ! هل هي مسرحية أم مهزلة أم ماذا ؟ وأذكر أنني قلت للسجين الكويتي “عبد الواحد حنظل الشمري”، أنا وأنت لو قلنا لهم سنهزم لكم أميركا فلن يصدقونا، فأرح نفسك”، وفجأة صدر قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن المحكومين باستثناء القضاياالأمنية والسياسية، أي أنه قام باطلاق سراح المجرمين الفعليين، وهنا استلمت المخابرات ادارة السجن، وفي أثناء الحرب حصلت تحركات كثيرة داخل السجن، فوصلت معدات وأجهزة وأشياء لا نعرف كنهها، ولم تقصف الطائرات الاميركية السجن (وكنا نتمنى لو أنها فعلت ذلك) فلربما كانت تقديراتهم بأن القابعين فيه هم من ضحايا النظام، ولكن المضحك المبكي أن جلاوزة النظام احتموا بنا، وكان أبو غريب المكان الأكثر أمناً في كل العراق، وصار ضباط المخابرات يظهرون لنا التودد على غير العادة، ولا أحد يعلم إلا الله بما وضعوا داخل السجن، لكن المعادلة انعكست بمجرد انتهاء الحرب، وبتنا دون ماء ولا طعام، ليس لدينا سوى الحشائش، وحفرنا حفراً في الأرض لتجميع مياه الشرب، وغابت عنا الشمس لأيام طويلة، إذ لم تفتح لنا البوابات فما رأينا الشمس ولا عرفنا بما يجري حولنا، ولكن الأمل في الخلاص كان يحدونا، وتمنينا هزيمة النظام وسقوطه، لكن الأولى تحققت وفشلت الثانية، فعادت إلينا القبضة الحديدية الشرسة، وازدادت حدة التعذيب ووحشية المعاملة، واستشرس الضباط في إخضاعنا للعقوبات، منها الحبس الانفرادي والرمي في بركة الماء القذر وسط ساحة السجن في جو بارد، وغيرها الكثير، لكن فرض العقوبات الدولية على النظام كان عامل تغيير مهم بالنسبة لنا فسمح للصليب الأحمر بزيارتنا، وكانوا في البداية قد زاروا الإيرانيين فقد أنكر السجانون وجودنا، لكننا سربنا الخبر للصليب الأحمر عن طريق زملائنا الايرانيين، وحينها أصر الصليب الأحمر على زيارتنا وتسجيل أسمائنا ونقل المواد والأغذية إلينا والمسألة الأخيرة تخضع لمزاج المخابرات، وهنا يبدأ فصل آخر من فصول مأساتنا، إذ يسرقنا الضباط علانية فيأخذون كل ما يحمله إلينا الصليب الأحمر. وفي أواسط عام 1994، بدأنا نبعث الرسائل مع أهالي السجناء، وجهنا الرسائل للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وللملك حسين وللمنظمات الدولية والصحافة، وكنا نناشد الجميع العمل على إطلاق سراحنا، زارنا السفيران الأردني والفلسطيني وبعض السفراء العرب، وبدأت تجري محاولات لمساعدتنا مما زاد في شراسة معاملة المخابرات لنا وخاصة بعد زيارات لجان التفتيش، ولسخرية القدر أو عبثية هذا النظام، أو جهنمية تفكيره، كانوا يطلبون منا مواجهة لجان التفتيش والهتاف لصدام حسين ولعن بوش، وذلك لكي نوقف لجان التفتيش عن مواصلة عملها والدخول إلى المكان، في الوقت الذي كانت فيه هذه الأخيرة تصر على دخول السجن ومتابعة عملها، كان رجال المخابرات يستغلون ضعاف النفوس باقناعهم بالتصدي لهذه اللجان مع اغراء يقول بأن القيادة ستطلق سراح كل من يقف في طريق هذه اللجان ويمنعها من متابعة عملها ! بدأت الحلقات تنفرج من حولنا، كما بدأنا نرقب أموراً غريبة وهي قدوم أجانب مخطوفين بالقرب من الحدود العراقية، فقد كان رجال المخابرات يتنكرون على أنهم رعاة أغنام، ويخطفون الأجانب من مناطق حدودية، وأذكر منهم بريطانيون وأميركيون أصدروا بحقهم أحكاماً جائرة تصل إلى اثنى عشر عاماً. التقيت بضابط عراقي روى لي كيف أنه كان مكلفاً ضمن مجموعة بنقل العائلات الكردية من مناطق الشمال وقتلهم ودفنهم في مقابر جماعية في الجنوب، وقد حاول هو إنقاذ طفل صغير انتزعه من أمه كي يتبناه، خاصة وأنه لم يرزق بطفل، لكن الضابط الذي يرافقه رمى بالطفل من شباك السيارة، فما كان منه إلا أن نزل وأفرغ رصاصاته في الطفل، واضاف أنظر ماذا كان مصير الطفل وماذا كان مصيري ؟ ولم يذكر القصة إلا بعد أن الححت عليه بالصلاة مراراً، وفي كل مرة كان يرفض.. حتى حكى لي ما حكى وقال: هل تريدني أن أصلي وهل يقبل الله لي صلاة ؟! في السجن أيضاً حكايات ومصائر وقصص خرافية، جاورنا الطيار محمد مظلوم الدليمي، وروى لنا زملاؤنا العراقيون كيف أنهم اطلقوا الكلاب الشرسة لتنهش لحمه وتمزقه تمزيقاً. نظام بطش وارهاب، وحفنة من الجهلة القتلة.. ولقد ذكرت السجناء الأجانب، ولكني هنا أود أن أتذكر كيف أن معاملة المخابرات وإدارة السجن مع الأجانب لم تكن تشبه معاملتهم لنا على الإطلاق، فهؤلاء يزورهم طارق عزيز ويتفقد إحتياجاتهم، إضافة إلى أن سفاراتهم تبعث لهم بوجبات خاصة، والسجين الأميركي (كينيث بيتي) ظلت سيارة الاسعاف في باحة السجن لخدمته منذ اليوم الأول لاعتقاله وحتى مغادرته، بينما لم يكن السجين العربي يحظى بالعلاج، فلم يكن مسموحاً للمرحوم (القدومي) أن يتلقى علاجاً وهو المريض بالقلب، كما لم يسمحوا لي بإكمال دراستي، لقد سحبونا إلى المخابرات لأننا تقدمنا بطلبات للدراسة أو بعثنا برسائل للصحافة أو المنظمات الدولية نطالب بتأمين محاكمات عادلة وإعادة ممتلكاتنا إلينا. لم ألقَ في سجون صدام حسين فلسطينياً تم اعتقاله لأنه جاسوس لإسرائيل، أو ليست إسرائيل عدوه الأول ؟ وسجناؤه الفلسطينيون هم طلاب مساكين ضاعوا في غياهب السجون، وكم منهم أُعدم دون ذنب، وتبين لي أن العدو الأول في التسلسل الأمني للمخابرات العراقية هو أجهزة الأمن الفلسطينية، ومن ثم الأردن وسوريا ثم إيران، وإسرائيل ليست واردة على الإطلاق فأمن فتح مثلاً هو أخطر من الموساد، وأذكر من السجناء السوريين، وهم كثر، راعي غنم أمي بسيط فرت منه أغنامه في (الحصيبة) على الحدود السورية العراقية فقبضوا عليه بحجة أنه جاسوس لسوريا ويهرب أسلحة إلى داخل العراق، وتحت الضغط وجراء التعذيب، اعترف المسكين بأنه دفن الأسلحة، وكانوا في كل يوم يأخذونه ليكشف عن مكان الأسلحة، وعندما لا يجدون شيئاً يعيدونه للضرب والتعذيب، ولهذا الرجل حكاية عفوية وبسيطة، فقد طلبه المحقق ليلة كي يتسلى عليه، فأخذه الحارس في المصعد، لكن المحقق غيّر رأيه وأشار عليه بالعودة بعبد اللطيف، الذي سألناه: ماذا فعلوا بك، قال (قبنونا) أي أخذوني للميزان ! وعبد اللطيف هذا حكمته محكمة الثورة بتهمة التجسس ! وآخرون تلبسهم التهمة وهم لم يسبق لهم دخول العراق، أما كيف ؟ فعن طريق الخطف، يخطفهم أعوان النظام من على الحدود أو من الأردن، ومن ثم يحكمون عليهم بالتجسس،ولقد قابلت في السجن مختلف الجنسيات العربية، والاغرب أنه مر علي تونسي متهم بالتجسس لصالح ارتيريا ! لم يسلم من شر المخابرات العراقية إلا القليل. كانوا يتبعون أساليب جهنمية للايقاع بالبشر تقابلها أساليب الإغراء والتضليل ورسم صورة للنظام مغايرة للحقيقة القائمة على الأرض، أو القابعة في السجون، وكل شيء كان يجري بتصميم مخابراتي مسبق، فعلاقات النظام بدول الجوار سيئة ولذلك يلجأون لخطف الناس وتعذيبهم ليكونوا بمثابة رسائل موجهة لدولهم، هذا فيما يخص السجناء العرب من السوريين والسعوديين والعرب الأحواز، أما البشر الذين يعيشون في الداخل، داخل العراق فحياتهم على كف عفريت ومصائرهم مجهولة -لا أمان ولا اطمئنان- وأذكر أنني قرأت قولاً للإمام علي كرم الله وجهه يقول: “والله والله والله إن القاعد فيها بذنبه والخارج منها فبرحمة الله”. وفيما يخص حياة البشر ومصائرهم أذكر هنا ما كان يسمى مجلس قيادة الثورة والذي أصدر قراراً عسكرياً برقم 61 في 17/1/1998 ينص على إعتبار الجرائم الماسّة بشخص الرئيس صدام حسين وأمن الدولة هي جرائم مخلة بالشرف وتصادر الأموال المنقولة وغير المنقولة لمرتكبها، فتمزيق صورة صدام حسين هي جريمة تقود مرتكبيها إلى الإعدام ومصادرة أموالهم ! عبد الاله سليم الحجاوي مواليد عام 1951 بدأت خطواتي الأولى في العراق عام 1971، بحثاً عن العمل كأي فلسطيني في هذا العالم ينشد لقمة العيش، ويبحث عن الاستقرار، ولم يكن الأمر سهلاً لا في البداية ولا في النهاية ! خضت غمار الحياة بالعمل في مجالات متعددة، وكانت محطتي الأخيرة “عمل إداري في جريدة الثورة” العراقية، وهي الناطقة باسم حزب البعث الحاكم. كان ذلك عام 1974 في مكتبة البعث في منطقة الباب الشرقي، والمكتبة تتبع الصحيفة، أي أنها تبيع المنشورات والكتيبات الحزبية، وبعد أن تم اغلاق المكتبة لأسباب لا أعرفها، ربما مالية فكثير من المؤسسات أو المشروعات الحزبية كانت تنتهي بالتوقف لأنها غير منتجة، كما أن ذلك يتبع سياسات المسؤولين، ومع تغيرهم تتغير هذه السياسات والتوجهات. انتقلت لعمل إداري في جريدة الثورة، في الحسابات ثم في قسم الاعلانات ثم المخازن، ومن هنا بدأت مسيرتي العملية في الاستقرار لفترة طويلة، لكنها انقلبت في عام 1990 مع غزو الكويت وما حدث من نهب مبرمج لممتلكات هذه الدولة، فقد كان كل قطاع في الدولة العراقية يأتي بمسروقاته من القطاع المماثل في الكويت، وجريدة الثورة مثلاً نهبت جريدة القبس الكويتية بكامل معداتها ومواردها من ورق الطباعة والأحبار وكل شيء، ولم يكن بمقدوري إلا أن أنفذ ما هو مطلوب مني في عملي، أي الإشراف على إدخال هذه المسروقات إلى المخازن وتسجيلها، استمر هذا الوضع على ما هو عليه حتى قامت الحرب في أواسط كانون الأول عام 1990، حرب تحرير الكويت التي آلت إلى هزيمة النظام العراقي وطرد الجيش العراقي من الكويت. عشنا أحداث الحرب من قصف ودمار للمؤسسات والمنشآت داخل بغداد كما عاشها الشعب العراقي، ولكن ما جرى بعد ذلك، كان الأقسى بدأت علامات الحصار تظهر في كل شيء يحيط بنا، وتمس الحياة اليومية وتضرب عصب المعيشة، هذا إضافة للفوضى العارمة في مؤسسات الدولة وكيانها، وفي تخبط المسؤولين في قراراتهم وإدارتهم للمؤسسات، كانت أحداث الجنوب العراقي المأساوية تطغى على كل شيء، أحاديث الناس ومشاعرهم والأخبار التي تأتي سوداوية، مثل دمار في كربلاء والنجف والبصرة، وذلك في أعقاب إخماد ما أسماه النظام تمرد الجنوب مرة، وحركة الغوغاء مرة أخرى، وذلك أنه في أعقاب هزيمة الجيش العراقي في الكويت، قامت إنتفاضة المدن والمحافظات الجنوبية والتي أطلق عليها إنتفاضة آذار، ولكن فيما يخص عملي بدأت أتلمس حصول سرقات في المخازن، المسروقات تتعرض للسرقة مرة أخرى ! وما قلت بأنه “فوضى عارمة” في بغداد فهو حقيقي لأن العبث بالممتلكات والنهب انتقل من الكويت إلى داخل العراق، وكل الذين عاشوا هذه المرحلة الصعبة يعرفون بأن بيوت الناس الآمنة لم تتعرض للسرقة في أيام الحرب، رغم أن عدداً كبيراً منهم تركها إلى أماكن أخرى، توزعوا في المحافظات عند أقاربهم ومعارفهم طلباً للأمان، ولكنهم سرعان ما عادوا بعد أن أدركوا أن الحرب والقصف يشمل العراق كله، وما أقصده هو أن مرحلة أخرى بدأت في بغداد، مرحلة تفشي الجريمة وانتشار السرقات والاعتداء على حياة الناس وممتلكاتهم، وبدأت مسيرة سرقة السيارات مثلاً، وكأن الأمر “موضة” فاليوم السيارات وغداً اطاراتها وهكذا ! حين أدركت حدوث السرقة ونقصان المواد في مخازني، أعلمت مديري المسؤول، فكان جوابه الذي يتكرر في كل مرة “مالك دخل” أي لا دخل لك، ولكنني لم أتوقف عند هذا الرد فالمسؤولية ثقيلة، وأنا مدرك للتعقيدات التي تحدث في مثل هذه الحالات، وعلى علم بما يجري في أجهزة الأمن لأصحاب القضايا الاقتصادية، والقوانين قاسية في هذه القضايا، كتبت تقريري إلى رئيس التحرير آنذاك صباح ياسين - الذي أصبح فيما بعد سفير العراق لدى الأردن - والذي قال لي “أنت مبرّأ من المسؤولية ولقد أديت واجبك بتبليغك عما يحدث” ووعدني بالوقوف إلى جانبي بعد أن حوّل القضية إلى المسؤولين، بدأت حلقات المؤامرة تحيط بي وتضيق عليّ، شعرت بأنني وقعت في فخ عصابة، وأذكر في هذه الأثناء أن موظفاً عراقياً هو الوحيد الذي وقف إلى جانبي، وساندني حين كتب هو الآخر تقريراً عن السرقات والتجاوزات التي تحدث في المخازن، تطورت القضية فيما بعد وعندما أصبحت بين يدي القضاء، أوقفوني مع المجموعة التي كنا قد أشرنا إليها بأصابع الاتهام، كان مكان التوقيف قرب ملعب الشعب، وفيه أدليت بالمعلومات حسب المطلوب مني، أي أنني قدمت إفادتي، وكان الجميع من حولي مؤيدين ومؤازرين لي، ويطمئنوني باستمرار على أساس أنني قمت بواجبي وأبلغت بما أعرفه، وبالتالي فإن المسؤولية القانونية لن تطالني، ولكن عصابة السلب والنهب يقف وراءها مسؤولون بعثيون وهؤلاء ذوي نفوذ، طبعاً كان الأمر يخيفني، ومجرد التفكير به يرعبني، ومع ذلك لم أتصور للحظة أنهم سيوقعون بي، ويقلبون الطاولة على رأسي ما زلت أحمل قناعة في داخلي بأن القضاء سيبرئني، ولماذا يبرئني ؟ لماذا هذه الكلمة بالذات، فأنا لم أسرق ولم أفعل شيئاً، أنا مجرد شاهد في القضية ّ لكن مسموعاتي بقدرة هؤلاء المسؤولين على الوصول إلى أهدافهم ونفوذهم كان يرعبني وأنا في هذا الموقف، تخونني الذاكرة حقيقة، وربما بسبب ما جرى نسيت الأسماء، فقط أذكر مدير الطبعة، وهذا الرجل كان وراء كل شيء إذ كانت الأمور تجري على النحو التالي: مدير المطبعة وعدد من العاملين فيها يتسترون على مدير المخازن، ولذلك وجهوا التهمة إلى طرف ثالث وأنا مع هذا الطرف وتحولت القضية إلى المحكمة، وكانت أوراقي، أو ملفي على انفراد كوني شاهداً وليس متهماً إلا أن الأمر سرعان ما تحول باتجاه آخر، وبقدرة الرشاوي المقدمة إلى الحاكم تمّ دمج ملفي مع الطرف المتهم، وهنا تحول المسار بالنسبة إلي مائة وثمانين درجة، فبدلاً من أن أكون شاهداً وبريئاً، صرت على العكس من ذلك متهماً ماذا أفعل وأنا لا حول لي ولا قوة.. وهؤلاء يمتلكون النفوذ وقد تمكنوا من إمتلاك الحاكم والعاملين في القضية ككل بالوساطات والرشاوي، هل هو سوء حظي الذي أوقعني في شراك هؤلاء أم هو الزمن الرديء الذي وصل فيه الفساد إلى ساحات القضاء، وأنا الآن في غابة لا قانون ولا أخلاق ولا مبادئ، وانتهى الأمر بتلبيسي حكماً بالسجن لسبع سنوات، وما قضيتي إلا غيض من فيض، فالذين قابلتهم في السجن بعد ذلك رووا لي ما تعرضوا له، ورأيت أناساً حكموا ظلماً وعدواناً، ذلك أن المرحلة الشرسة تغلغلت في العراق، فاستشرى الفساد في كل مرافق الدولة، وبات الإنسان دون حماية والأجهزة الأمنية تتسلط على أي مواطن ولأي سبب، فيسرقون المال من شخص مثلاً ويلبسونه تهمة حمل أوراق نقدية مزورة، لقد قابلت سجيناً حكموا عليه خمسة عشر عاماً بحجة سرقته لإسطوانة غاز ! وكثيرة هي التهم الباطلة والجاهزة لديهم، والناس لا حول لهم ولا قوة تحت وطأة الجبروت والطغيان الجهنمي، والأجهزة الأمنية تمتلك سلطات واسعة في اعتقال الناس وتهديدهم بالطرق الجائرة وغير القانونية. بدأت رحلتي في سجن أبو غريب، وأقول إنها رحلة إلى مدينة مسوّرة يسودها الظلم والعدوان ويحكمها قانون الغاب، وتضم العديد من البشر بحكايات مختلفة، أبو غريب مكان جهنمي لا تدخله أو حتى لا تتسلسل إليه نسائم الإنسانية، وعائلتي كيف أفكر بها وماذا أستطيع أن أفعل تجاهها ؟ وماذا تستطيع أن تفعل لي ؟ هم في الخارج يعانون شظف العيش حالهم حال العراقيين الذين أطبق عليهم الحصار، وأنا من داخل سجني أرثي لحالهم وهم يرثون لحالي.. عائلتي وبعض الأصدقاء حاولوا اللجوء إلى المحامين ولكن دون جدوى.. تستوقني مسألة الحصار كثيراً، فقد كانت مرحلة صعبة لملايين البشر في الوقت الذي كان فيه رجال السلطة والأجهزة الأمنية ينعمون بحياة مترفة، وليس هذا فقط، بل الأسوأ منه حيث تتسلط الشرطة والمخابرات على الناس المسحوقين، فتسرق ممتلكاتهم والويل لهم إن هم أعلنوا عن ذلك.. دائرة جهنمية مغلقة تطبق على الناس وهؤلاء يدوسون كرامتهم ويسرقون أموالهم وينتهكون أعراضهم.. كان هؤلاء في الداخل أشد وطأة على الناس من الحصار في الخارج، والأجهزة الأمنية والتنظيمات الحزبية لم يكن الحصار يطالهم، بل كان مظلة ربما لتجاوزاتهم وللبطش بالناس واللعب بمصائرهم. السجن في العراق، تجربة ليست كمثلها تجربة، فهو كمسمى وحياة وتعامل ليس له مثيل.. وإن قلت بأن المعاناة في داخله رهيبة.. فهذه كلمات بسيطة واعتيادية ولا تعنى شيئاً بالقياس للحقيقة التي عشناها. التقيت في السجن بكثير من العرب المساكين الذين وقعوا ضحايا التآمر عليهم للاستيلاء على أموالهم، وقد اتهموهم بتهم مختلفة ومختلقة، فما أسهل الاتهام بالتجسس والعمالة والخيانة، وكنت دائم البحث عن أناس طالتهم محاكمات عادلة وحقيقية فوصلوا إلى السجن بطرق قانونية، وهم قلة أمام جمع غفير من البشر الذين أرغموا على الاعتراف تحت وطأة التعذيب فاستسلموا لمحققيهم وقالوا “نعترف بكل ما تريدون”. ويطول الحديث عن أساليب التعذيب الوحشية التي يستخدمونها، ولكن الأسوأ فيها ما هو غير أخلاقي، و”غير الأخلاقي” يشمل الاعتداء الجسدي الجنسي والتهديد بالمحارم والاقارب، ثم الابتزاز بدفع الأموال، هل يصدق أحد في هذا العالم أن الرشاوى والوساطات يمكن أن تغير الأحكام بالغاء التهمة عن شخص والصاقها بآخر أو بتخفيف العقوبة، وحتى في التعامل مع السجين، فجلاوزة السجن يطلبون “الرشوة” كي يرحموك من الضرب وجلسات التعذيب ! والقادر على الدفع مادياً يمكن أن يشتري نفسه بهذا الشكل والذي لا يقدر تنصب عليه لعنات الجلادين ! إنه يُضرب لأنه لا يستطيع الدفع، ويتعاون السجناء والأصدقاء فيما بينهم لافتداء بعضهم البعض اتقاءً للعنف وجلسات التعذيب التي كانت تجري “تسرية” لنفوس السجانين، فأبسط ما يكون منها أن يأتيك الضابط من إجازته متعباً أو منتعشاً، وفي الحالتين يطلبك لينفس عن نفسه، في الأولى “فشة خلق” وفي الثانية “ترويح عن النفس” ! ولقد مات كثيرون تحت التعذيب، لم تحتمل قلوبهم صعقات الكهرباء، ولم تعنهم صحتهم على الصبر حتى آخر المشوار، وحتى القدرات العقلية كانت تتأثر بالتعذيب، فكثيرون هم الذين فقدوا ذاكرتهم واختلت قواهم العقلية، وإن خرجوا من السجن فإلى مستشفيات الأمراض العقلية أو إلى الشوارع هائمين على وجوههم، وكان التدرن سبباً في موت الكثيرين أيضاً.. تعددت الأسباب في السجن والموت واحد، وتسجيل حالات الموت في السجن إعتيادية بالنسبة لسلطات النظام، والقهر والتعذيب والممارسات اللاأخلاقية هي غذاء يومي للباقين على قيد الحياة في أقبية النظام التي تفوق أية ديكتاتورية في العالم، والعرب والعراقيون في الظلم على حد سواء وكلنا في الهم في قبضة السجّان. كانت أعداد العراقيين في السجن القريب منا لا تقل عن أربعين أو خمسين ألفاً، وربما كان الاربعون الفاً كرقم ثابت يزيد كثيراً ولا ينقص إلا القليل، واعتقد من تجربتي أنه ما كان ينقص ابداً، أتذكر جيداً أن الكثيرين منهم حين كنا نسألهم: ما هي تهمكم ؟ يقولون: لا نعرف، وآخرون يتمنون تنفيذ حكم الاعدام للخلاص من هذا الضيم، وكنا نصحو لصلاة الفجر على صوت (القطاعة) الآلة التي تقطع الرؤوس في تنفيذ أحكام الاعدام ونعد الضربات، الواحدة تلو الأخرى، ومع كل ضربة هناك إنسان يغادر الحياة ! كان علينا بين الحين والآخر أن ننظف صالة الاعدام.. ولك أن تتخيل ما فيها من دماء وروائح ومشاهد تقشعر لها الأبدان، ولكن أصعب ما كنا نمر به، هو سحب المحكومين بالاعدام من وسطنا.. هؤلاء كانوا يعيشون بيننا، وحسب الدور يطلبونهم فنعرف أنهم لن يعودوا.. ومنهم من كان يقع في الطريق أو يتجمد ويسحبونه أو يزحلقونه فوق صابونة ! ذكريات من الزمن المؤلم.. قسوة لا متناهية ووحشية.. لا أعرف لها تسمية.. عشت هذه السنوات دهوراً من القهر ولكنني كنت بالطبع محظوظاً إذ أفرج عني بالعفو الذي حصل عليه ليث شبيلات عام 1998 .. ما مصير من بقي بعدي ؟ وما الذي كان يجري ؟ لا أدري.. لا أدري.. عماد محمد عبدالله مواليد عام 1966 ذهبت إلى العراق عام 1989 كتاجر، وكنت في البداية أتنقل بين الأردن والعــراق، ثم استقرت بي الحياة هناك. فتحت مكتباً في منطقة الدورة - بغداد، بالإضافة إلى محل لبيع الملابس في الكرادة، كانت أوضاع العمل جيدة بالنسبة لي، ولم يكن ينغص علي سوى نظرة الحقد والكراهية الدفينة، التي كان بعض العراقيين يكنونها لنا من باب الغيرة والحسد أولاً، وهذا يتضاعف ويتضاعف بالنسبة للفلسطيني (هذا المشرد من أين له المال وأبسط ما يقولونه أن خيرك من عندنا). واجهت مضايقات كثيرة وحالات ابتزاز عديدة من الأجهزة الأمنية، وأبسط كلمة كان يطلقها “يا الفلسطيني” وكأنها شتيمة وليست للتمييز مثلاً، لا لم تكن منطوقة بحسن نية وإنما للتجريح والتحقير، بدأت قصتي مع هذه الأجهزة بعودتي من السفر مرة في أواخر عام 1994 حين فوجئت بالاستخبارات العسكرية، تطوق منزلي وتنتشر في المنطقة وقد ألقوا القبض على كل من في المنزل، وقعت في كمين نصبوه لي وأخذوني في سيارة تابعة لهم وتركوا عائلتي (أنا متزوج من عراقية ولي بنت) وأول تهمة وجهوها لي أنني متزوج من عراقية ! وتعرضت للتعذيب والضرب لهذا السبب.. كلام بذيء جداً وجهوه إلي وأنا في موقف لا حول لي فيه ولا قوة ! شعرت بكرامتي تتعرض للتجريح وبكل كياني كنت أتألم.. وأصرخ في أعماقي ما الذي يجري لي ؟ ماذا فعلت حتى أكون أمام هؤلاء ؟ وما هي جريمتي وأسئلة كثيرة وكثيرة.. حين خرجت من المنزل، أو بالأصح حين أخذوني عنوة أو إختطافاً أو إعتقالاً.. سمّه ما شئت، كنت معصوب العينين ولم أعرف الجهة التي أخذوني إليها ولا أين أنا ؟! والفاجعة التي أنا فيها والعنف الذي تعرضت له، لم يسمحا لي حتى بقياس المسافة أو معرفة الطريق. يمكن أنهم ساقوا بي خمس دقائق أو أربع ساعات.. لم أكن أعرف. وهذه أول مرة في حياتي أتعرض فيها لمثل هذه المعاملة، ولأول مرة أواجه أجهزة أمنية، وضعوني في غرفة فيها أشخاص (أحسست ذلك من الأصوات والأنفاس) وبعد قليل من الوقت أخذوني إلى مكتب ورفعوا العصابة عن عيني، فقلت: “خير، ما الأمر” ؟ هذه بمجرد أن نطقتها وجهت لي ركلة من قدم أحدهم على وجهي، فسال الدم وتكسرت بعض أسناني ! هذه كانت المواجهة الأولى.. أمامي أفراد لا أعرف من هم ولا شيء يمكن أن يميزهم لي، وتخيلت لثوان بأنني لست في قبضة أجهزة أمنية، وإنما أفراد عصابة خطفتني ولسبب لازلت أجهله! أُعيدت العصابة إلى عينيّ بعد أن جاء أحدهم وقال: “لماذا رفعتموها عن عيني هذا الكلب ! أعيدوها”.. وبدأ سيل من الألفاظ البذيئة ينهال على مسامعي، ألفاظ لا يمكنني اليوم أن أعيدها مع نفسي، وأحاول قدر الإمكان نسيانها، ترافقها الكثير من اللكمات والإهانات وأشياء أصبحت فيما بعد بسيطة جداً أمام التعذيب الذي تعرضت له.. الضرب الذي كنت أتلقاه من كل الجهات ويصيب كل أنحاء جسدي، أصبح لا شيء مع التعذيب المنظم والمبرمج فيما بعد ! هذا كله في الليلة الأولى ! ومن ثم نقلوني إلى غرفة مظلمة لا أرى فيها إصبعي.. وفي الصباح أخذوني إلى مكتب آخر للتحقيق، وكنا نعرف الصباح من الليل لمجرد مرور ساعات بين الإستدعاء الأول والإستدعاء الثاني، أو بين حفلة الضرب والإهانات السابقة واللاحقة، هذا الفاصل الزمني بين الإستدعاءين هو الذي يعيننا على معرفة التوقيت ! المحقق الجديد يريدني أن أعترف، ولما قلت له لا شيء عندي أعترف لك به، قال خذوه ! وبعد جولة أخرى من التعذيب، محقق آخر يعيد عليّ نفس الطرح وأعيد عليه إجابتي نفسها.. أنتقل إلى ضابط آخر، محقق يقول لي: “أنت تُهرّب أدوية للعراق”، وبعد إنكاري وإستغرابي لهذه التهمة تبدأ جولات من التعذيب، لأفاجأ بمحقق آخر يقول: “أنت مسؤول عن التفجيرات التي حدثت في وزارة الصناعة أو التصنيع.. حتى أنني لا أعرفها.. المهم أنها قريبة من فندق (ميليا المنصور)..وهنا وجدت نفسي أمام اتهام آخر.. غريب أسمعه للمرة الأولى.. أنكر وأنكر وأدافع عن نفسي ولكن دون جدوى ! طلب مني المحقق أن أكشف له عن أسماء جماعتي، ولا حل وسط أمامي فإما أن أقول نعم أو لا، في الأول عليّ أن أعترف وأكشف وفي الثانية سأتعرض للتعذيب، فماذا أفعل ؟ كلمة لا وأنا صادق فيها تعني الويل ! وبعد العديد من حفلات التعذيب قلت بالحرف الواحد “يا عمي، نعم، أنا الذي قام بالتفجيرات” فقال لي: “وقع” طبعاً كلمة توقيع هذه ليست سهلة.. واسأل نفسي إلى أين وصلت.. هل أعترف بتهمة لم أقم بها ؟ فيكون الجواب خذوه وإلى الجحيم ردوه ! ويا ويل الذي أخذوه، يا ويلي. أخذوني إلى مكان “هو معسكر مخصص للتعذيب، ويديره محترفون”، وهؤلاء يعملون بطرق غير طبيعية، وعلمت من آخرين حين انتهى بي المطاف في سجن أبو غريب، أن هؤلاء يمتلكون صلاحية قتل الآخرين تحت التعذيب، يحق لهم ذلك دون مساءلة ! ولهم مكافأة توزع على كل منهم، فلكل واحد منهم خمسة الاف دينار عراقي. وعدد العاملين في هذا المكان عشرة (القائد وتسعة ضباط)، يعملون بنظام المناوبة، في كل يوم يتناوب ثلاثة ضباط على عمليات التعذيب ! القائد وأذكر أنهم كانوا ينادونه “التكريتي”، والمكان عبارة عن بيت فيه صالة كبيرة، وحديقة مبلطة، في وسطها شجرتان واحدة مخصصة للتعذيب، كان هناك أشخاص معي ولم نكن نجرؤ على الحديث مع بعضنا البعض، فمجرد سماع الهمسات يعني دورة تعذيب جديدة على الجميع، هذا يحدث في وقت الإستراحة التي قد تكون نصف ساعة أو ساعة. لا أذكر اسم المكان ولكنني أتذكر تفاصيله، والبداية تكون أن سيارة تدخل الكراج وتسلم القادم الجديد إلى الجلاوزة القابعين في الداخل، وطبعاً يكون القادم إليهم معصوب العينيين.. هو سجن مصغر والتعذيب فيه مكثف ويجري على أيدي مختصين، هو قريب من مبنى وزارة الداخلية، هكذا أعتقد كما أنه من الممنوع علينا أن نرفع أنظارنا إلى الأسوار والمنع ليس لفظياً بل هو عملية كسر العنق ! ويزيد اعتقادي من أنه قريب من وزارة الداخلية بسبب وجبة الطعام التي كانت تقدم إلينا.. إذ أنهم أدخلوني إليه في اليوم الأول أو الثاني من رمضان، والوجبة تتضمن أرزاً وتقدم لنا تقريباً الساعة الثانية عشرة ليلاً، هو بقايا الذين أكلوا في المبنى المجاور لنا، وهو الذي كان يعطينا الطاقة على تحمل ما نحن فيه ! ولم يكن هناك طعام مخصص لنا، فقط قطعة خبز (صمونة) بحجم علبة السجائر، فلم يكن وارداً في حساباتهم أن يقدموا لنا الطعام - ونحن في حال من النزف الدموي والتعرق والهلاك ! الماء فقط هو المسموح به، يضاف إلى هذه الخبزة الصغيرة بعض المكرونة أحياناً أو قطعة صغيرة من الدجاج، وأعني بقطعة صغيرة (جلدة أو عظمة بحجم الاصبع الصغير من اليد)، ومع ذلك كنا نأكلها.. وعلى استعداد في هذا الوضع أن نأكل أي شيء، فمسألة التوزيع كانت تتم على النحو التالي: نصف دجاجة تقسم على أربعين موقوفاً ! وأنا بطبيعتي لا أحب اللحوم وخاصة جلد الدجاج، وفي يومٍ حصلت على هذه القطعة فأكلتها وكأنها العسل ! وأذكر أن بعض الذين كانوا يخدمون في المكان وزعوا علينا أجزاء من قشور البرتقال، وهذه عملية تهريب في حسابات المعذِّبين، ومرة وقعنا في أيديهم ونلنا عقاباً بسبب هذا التهريب !! أخذوني إلى مكان آخر لا يُنسى، وقابلونا بأهلاً وسهلاً “إصطفوا على الجدار وإنزعوا كل ملابسكم، أياديكم مرفوعة إلى فوق”، ومن ثم تنهال علينا الكرابيج - وهي عبارة عن كابلات محشوة بالنحاس أو الحديد، ويا ويل الذي يتأوه ! يا ويل من تصدر منه صرخة ! والجلد يمتد من أسفل العنق إلى نهاية الظهر، ولا يمكن لأحد ألا يصرخ، فالضربة الواحدة كفيلة بأن تطيح بالإنسان عاجزاً لشهر في المستشفى.. أجزاء من اللحم تنسلخ من الجسد مع الضربات.. ولا زالت علاماتهم منقوشة على ظهري ! هذا هو حفل الاستقبال الذي لا أتذكر كم إستغرق من الوقت.. توقفوا بعد أن نزفنا ونزفنا.. ربما كان الوقت منتصف الليل.. أعادوا إلينا ملابسنا شرط أن نلبس منها قطعة واحدة إذا كانت (دشداشة) أو قميصاً وبنطالاً فقط بدون ملابس داخلية ! أنا قميصي كان أبيض فتحول إلى الأحمر من الدم والعرق وو.. وعند الصباح هناك حفلة تعذيب جماعية، تبدأ بالتعداد ويتم بطريقة الضرب على الرأس وكل من يتلقى ضربة يذكر الرقم (1، 2، 3)، وهكذا مرت عليّ فترة عشرين يوماً، لم أدخن وكان بإمكاني ترك التدخين آنذاك، ولكنني لم أفعل من الهم والويل الذي أنا فيه.. فطلبت من أحد الحراس أن يشتري لي علبة سجائر مقابل القميص الذي ألبسه، وبالطبع هم سرقوني منذ البداية، من البيت، وفي مرة وبعد حفلة تعذيب فوق الشجرة، صوّب الضابط المسؤول عن التعذيب بندقيته إليّ وقال: اعترف، ألِّف لي قصة، أنا أعرف أنك ستكذب ولكن ألِّف لي قصة يا ابن الكذا والكذا.. تريد أن تستريح قبل أن تعترف بما عندك، أنت فلسطيني وقتلك لا يكلفني شيئاً بل يمنحني مكافأة ! أما التعذيب فوق الشجرة فهو رواية بحد ذاتها: ربطوني إلى جذع الشجرة وانهالت الضربات عليّ.. ثم جر الأكتاف من الخلف وربطها إلى فرع من الشجرة، وهذه العملية تدير مفصل الكتف الواحد نصف دورة معاكسة، عمليات مخترعة لا تعرفها غالبية سجون العالم، ومن ثم نقلوني إلى سجن أبو غريب بعد حكم بالمؤبد وحكمين بالإعدام ! وبدأت زيارات أهلي، لتبدأ عمليات الابتزاز والسرقة المكشوفة، إذ يأخذون منا الأموال التي يأتينا بها الأهل، وكنت أوصي من يزورني بأن لا يذكر الرقم صحيحاً حتى يتبقى لي شيء منه ومع ذلك لا يفيد، كان يصلني مبلغ ثلاثمائة دينار، وأقول إنها مائتان فقط فيأخذ المائة، ويعودون بعد أسبوع لطلب المائة الأخرى، مع أنهم يعلمون بأن أهلي لن يأتوا مرة أخرى إلا بعد شهر أو شهرين وهكذا، ليست مشكلة بالنسبة له حتى إذا لم يأت أهلي يقولون لي: دبِّر، ودبِّر تعني أن تستدين، وما أجعله احتياطياً ينفد، والكل كان يدفع ويضطر للدفع، زميلنا أحمد يونس كانوا يبتزونه بشكل رهيب لمعرفتهم بأن أحواله المادية كانت جيدة، والمطلوبات كانت تتجاوز آلاف الدولارات، والصرف على الولائم وتنفيذ صور وجداريات لصدام حسين، ولكي يطلقوا سراحه طلبوا منه مليون دولار ! مساومات مكشوفة. أيام السجن، عذاب نفسي وأمراض التدرن منتشرة، وبصعوبة وربما بالصدفة نجونا منها.. كان علينا أن نتحصن بالتغذية الجيدة، وهذا أمر صعب، وربما كانت لدينا القدرة نوعاً ما على التحمل ومن ثم كان لنا أهل أو معين في الخارج بينما لم يتوفر ذلك لأشخاص عديدين ماتوا بسوء التغذية أو الأمراض، عرب وفلسطينيون وعراقيون، مرحلة قاسية ولا يمكن أن يطلق عليها وصف.. التدرن الرئوي حصد عدداً كبيراً من السجناء، أما مساعدات الصليب الأحمر فقد كانوا يأخذونها منا ومن ثم نشتريها منهم، مثلاً بطانية يمنحها لنا الصليب الأحمر تصادر، نبتاعها منهم من جديد، هذا إضافة إلى الرقابة المفروضة علينا فيا ويل الذي يُصرّح بشيء للصليب الأحمر، يأخذونه من جديد لتلصق به تهمة أمنية عند المخابرات، وفي أقل التقديرات يمكن أن يخرج بعاهة مستديمة إن نجا من الإعدام، ومن تأخذه المخابرات، يعود بعد ستة أشهر أو أقل، ومن المستحيل أن يعود طبيعياً.. كثيرون فقدوا عقلهم أو ذاكرتهم، خوف رهيب يحيط بنا ولا فائدة من زيارة الصليب الأحمر أو السفارات.. ما تجلبه لنا السفارات يصادرونه، والمشكلة الحقيقية كانت المرض الرئوي، وربما كنا أحسن حظاً بكثير من الذين لا أهل لهم، هناك سجناء أهاليهم في فلسطين وممنوع عليهم الوصول إلى العراق، وبالطبع كنا نساعد بعضنا البعض ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال مساعدة الجميع.. أعداد غفيرة في السجن، خرجت مع زملاء لي بالعفو الذي حصل عليه ليث شبيلات. أجبروني على تطليق زوجتي وأنا في السجن، وقابلت زوجتي أثناء ذلك في محكمة بداخل السجن وكانت تبكي وليس أمامي سوى أن أنفذ ! ولي طفلة عمرها شهور، أتذكر الضرب والتعذيب بالطبع. لكن أقسى ما أتذكره هو الاهانات والشتائم التي تمس الشرف والعرض.. حاولت نسيان كل شيء ولا يمكن أن يتم ذلك.. أنا والدي سجن عندما زارني، سجنوه لإثنى عشر يوماً مع صديق لي لأنهما حاولا اللجوء إلى المحامين للدفاع عني، وضعوا والدي في توقيف التسفيرات، وعندما عاد إلى الأردن حمل معه إحدى (صمونات) السجن وهي مملوءة بالحجارة ولذلك استمر والدي المسكين في مساعدتي بالطعام خاصة، لأنه عاش التجربة القاسية، كان الطعام في السجن لا يوصف، شوربة عبارة عن بركة مياه، وكنا نحاول تحسينها بأن نتبرع بكيس من الأرز ليضيفوا منه كمية أكبر للشوربة، كي تصبح صالحة للأكل، هذه الشوربة كان البعض يقتات عليها فلا شيء لديه غيرها، السجن قذارة ومجاعة وتعذيب وسلب ونهب وابتزاز، هل يتصور أحد في الكون أن الذين لم يكونوا يمتلكون المال من السجناء، كانوا يضربون حتى يرغمهم الضابط وإدارة السجن على الإستدانة، أو أن يدفع أحد عنهم أو .....، وكلنا في الهم سواء فالذي يملك المال أو المعونات يجبر على إعطائها لهم، والذي لا يملك يدفع الثمن عذاباً.كنا نعين بعضنا البعض بشتى الوسائل.. مثلاً أنا عاونت أحد السجناء الفلسطينيين بأن أفتديته ببعض المال كي لا يضرب وهو أساساً مكسور اليدين والرجلين، والطبيب ممنوع أن يأتي إلا في اليوم التالي.. وكان هذا السجين وأسمه أحمد قد تعرض للضرب في اليوم السابق وفوق الجبس ! والضابط كان يناديه للتعذيب كي يتسلى عليه، لأن محكوميته قد أشرفت على الإنتهاء ! طلب الضابط خمسمائة دولار مقابل إعفاء الرجل من الضرب، قلت له لا أملك المبلغ كاملاً، وبدأت بتدبير الأمر، عندي مائتان وعند الرجل مائة، أعطيته إياها كي يكفّ عن ضربه، بعدها خرجنا من السجن وخرج هو بعدنا.. وأقول إن الإنسان منا مهما كان قادراً على التحمل، يمر بمواقف لا يمكن تحملها فهذا رجل مهشم العظام في اليدين والرجلين ويتعرض للضرب ! هذا الرجل لم يكن بقادر على الوصول إلى الحمام وكان رفاقه يقلبونه من جنب إلى آخر.. وكل ذنبه أنه لما كان يعمل مراسلاً في مكاتب إدارة السجن، تجاهل طلب هذا الضابط باحضار كوب من الشاي له ! والله العظيم هذه هو ذنبه !والشباب الواردة شهاداتهم في هذا الكتاب يعرفون قصته، وكان عدنان الاقرب منا إليه، علاقتي بأحمد كانت بسيطة فهو صموت منعزل ولا يتدخل بأحد، وربما ظن بعض الشباب أن الإعفاء كان بسبب كسوره ولكن الحقيقة انها الرشوة ! ماذا أقول عن عذاب لا زال ساكناً في دواخلي.. هو جمع من الأشواك ينخزني كلما تحرك أحمد إبراهيم عايد مواليد عام 1952 بدأت العمل سائقاً على خط بغداد - عمان في عام 1982، ولكنني بعدها قررت الاقامة في بغداد والعمل أيضاً. أنشأت عملاً تجارياً في منطقة البياع - شارع العشرين، عملي كان بيع الأدوات الكهربائية. تزوجت من فتاة عراقية (من عشيرة الدليم) وفي شهر أيار عام 1992، وبالتحديد 2/5/1992م أُعتقلت من قبل المخابرات العراقية ووجهت لي تهمة الإساءة للنظام، تمّ توقيفي في شعبة الحاكمية، وفي أثناء التحقيق كانت الإتهامات الموجهة لي تتمثل في أنني أُسيء للنظام، ولم أنتمِ لحزب البعث على الرغم من محاولات زوجتي التي كانت قد عرضت الأَمر علي مراراً وتكراراً، وكانت إجاباتي أن الأمر يمثل اختياراً فكرياً وسياسياً ولكنهم واجهوني بالضرب والتعذيب، وبعد توقيف دام إثنى عشر شهراً، جرت محاكمتي وصدر الحكم علي بالاعدام بتاريخ 24/3/1993، وذلك في محكمة ليلية في المخابرات ومن ثم تم تحويلي إلى سجن أبو غريب، محكمة المخابرات الرهيبة لا دفاع ولا قانون فيها ولا حتى أسماء للأشخاص وإنما مجرد أرقام، ولا محاكمات تجري في النهار، رقمي (1650) وتقرأ لائحة الأرقام ويصدر الحكم في دقائق، حاكموني في مخابرات المنصور، والتهم التي وجهت إلي هي كراهية البعث والتهجم على النظام، والتصريح بالقول أن البلد يشهد اضطهاداً وأن هناك معلومات من خلال الناس عن هذه الأفكار التي أبثها، حسب إدعاءاتهم، وما كان يجري في العراق في ظل النظام السابق هو خارج نطاق العقل والتصور، هناك حكومات متعددة، الجمارك، الشرطة، عدي أو قصي، مخابرات أو جهاز الأمن الخاص وأطراف متعددة وغيرها، والذي يقع بين أيدي هذه الأجهزة لا يمكن معرفة مكانه أو مصيره، ومن ضمن التهم التي وجهت لي هي “قدح مقامات” أي ذم المسؤولين وأعضاء النظام، والكثير الكثير من هذا القبيل، هذا إضافة إلى رفض الإنتماء لحزب البعث ومعاداة توجهاته، وكنت أقول لهم بأنني لا أستطيع الإنضمام إلى الحزب لكي أكون كاتب تقارير عن الآخرين وعن تحركاتهم، لا أذكر أنهم كانوا يذكرون أدلة موثقة ضدي وهو يحققون معي.. لا أذكر سوى أنهم واجهوني بحديث جرى في منزلي مع أناس كنت أظنهم أصدقاء، وأعتقدت أيضاً أن ما كان يدور هو عبارة عن دردشات عادية، لكن الحديث انتقل على أساس أنه معاداة للحزب والثورة والنظام وتسبّب لي بحكم بالإعدام تم تخفيفه إلى السجن المؤبد، بسبب أنني من قطر شقيق وأنني فلسطيني.. الخ هذه الديباجة. بقيت في سجن أبو غريب إلى حين العفو الذي حصل عليه لليث شبيلات. كنا حوالي الواحد والسبعين شخصاً وكان منا عشرون شخصاً مسجونين بدعاوى أمنية ومن هؤلاء ضيف الله وخالد صالح وعدنان عبد القادر وقدير قدري طلوزة، وكان هناك حوالي 48 سورياً حكموا بالتهمة ذاتها، وأذكر قصة طالب من الضفة الغربية وقع فريسة في أيديهم بسبب أنه عبر عن رأيه في موضوع حر في الجامعة، حين كتب “لماذا تم غزو الكويت ؟” هذه الكلمة أوصلته إلى نيل حكم الإعدام الذي تمّ تخفيفه إلى المؤبد، كان هذا الطالب يدرس في جامعة البصرة، وبقي في السجن لمدة عام حين خرج بواسطة مرسوم، فقد عملت والدته مختلف الوساطات ودفعت نقوداً وأنا لا أعرف قيمة ما دفعت بالضبط، ولكني أعرف أنها حصلت على مرسوم بالعفو من صدام حسين. زوجتي (آنذاك) كان لها دور في الموضوع، فقد ساهمت بشكل أساسي في توصيلي إلى حبل المشنقة، وكونها حزبية فمن واجبها أن تعرض عليّ المشاركة في تنظيم حزب البعث هذا أولاً، وثانياً لابد لها أن تكتب تقارير عن المقربين منها فهذا يعتبر واجباً عليها تجاه الحزب، إضافة إلى الترقيات الحزبية التي ينالونها جراء ذلك وهي من هذا المنطلق نقلت لهم الصورة، وأنا أعتقد أن هؤلاء الحزبيين هم عبيد لذلك الحزب، فصدام حسين كان يقول لهم “إذا لم تجد شيئاً تكتب عنه فأكتب عن نفسك” فكيف لا تكتب زوجتي عني ؟ وبالطبع حصلت على ترقية فكل من يكتب عن أحد أو يخبر عن قضية أو يسلم عسكرياً هارباً ينال الترقية، درجة حزبية. لم تكن بيينا أية مشاكل، ودوافعها كانت مادية، كانت تريد الحصول على مكاسب شخصية، وهذا الحال لا يقتصر علي فقط، فأنا أعرف مفوضاً في الشرطة أسمه (عادل) قتل أباه وأخاه، وحين سئل لماذا فعلت ذلك ؟ قال: لقد شتما صدام حسين فاستحق نوط الشجاعة إضافة إلى صلاحيات واسعة تؤهله لمخاطبة وزير الداخلية وبالتالي يفعل مايريد، هذه إحدى القصص التي عرفتها وأنا في العراق، وهي كثيرة وغريبة. أذكر مرة أن أحد الأشخاص الذين كانوا على علاقة بالحزبيين ورجال النظام أَسرّ لي بالقول: أنا كنت (ملازم أول) في حراسة صدام حسين ودخلنا مرة إلى بيت هيثم أحمد حسن البكر، بقيت في الحديقة وعلى مقربة منهم أستمع إلى حديثهم، دار النقاش بين صدام حسين وعدنان خير الله وزير الدفاع ونسيبه - شقيق ساجدة زوجة صدام حسين، وكان الموضوع أن صدام طلب من هيثم أن يطلق زوجته، فكان عدنان خير الله يقول لصدام بأن هذا الأمر غير معقول فهي أم لأربعة أطفال، فقال صدام: هذا ما يريده النظام وعلى هيثم أن يفعل ذلك على الفور ! وإلا قتلته”.. وانتهى الأمر بتطليق المرأة ومن ثم تزويجها من (وطبان) الذي كان وزير الداخلية وهو في الحقيقة اسمه (زبلان) وبالطبع قام بتغيير اسمه منعاً للحرج، هذه قصة حقيقية جرت فلا تستغربوا أن يحدث معي ما حدث، وقياساً للجرائم المروعة التي حدثت في العراق فإن موضوعي بسيط، وأي إنسان عاش مع الشعب العراقي وتلمس معاناته عن قرب يدرك حجم العذاب والخراب الذي سببه هذا النظام للبلد والناس، أما الوضع في السجون العراقية فهو صعب للغاية، مستوى متردٍ من الخدمات وعلى السجين أن يدفع ثمن القفل والكهرباء والماء وكذلك السرير الذي ينام عليه وثمنه خمسة وعشرون الف دينار، أما السجناء العرب فهم مطالبون بتقديم الرشاوى إلى الضباط ومخصصات مالية خاصة بعد كل زيارة يقوم بها الأهالي إليهم وبحجج تحسين السجون والتبرعات وبالطبع هم يأخذون هذه الأموال والعطايا لجيوبهم. والذي لا يعطي من السجناء يتعرض لشتى صنوف العذاب. كان أهلي يأتون إليّ في زيارات متباعدة طبعاً، لأنهم سيسافرون من الأردن إلى العراق، والدي ووالدتي كانا يقومان بزيارتي وقد توفيا. بعد ذلك، الحياة في داخل السجن كانت أكثر من جحيم ولا وجود لكلمات من مثل “حقوق إنسان أو معاملة جيدة أو لمسة ضمير أو أي شيء من هذا القبيل”، كنا نتعرض لعقوبات قاسية مثل البقاء تحت الشمس في أيام الصيف القائظ لنهار كامل أو البقاء في وضع القرفصاء من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءاً، والعلاج كانوا يصادرونه منا بعد أن يقدمه لنا الصليب الأحمر، وكذلك المساعدات التي كانوا يقولون لنا أعطونا كل ما وزعوه لكم فهذا من أموال العراق ! كان هناك سجناء أجانب أيضاً وأذكر منهم واحداً أسمه (ديفيد) وآخر أسمه (مايكل)، أحدهما قبضوا عليه وقد دخل بدراجة هوائية إلى الموصل واتهموه بتجاوز الحدود، وحكموه لثماني سنوات، ولكن تم الافراج عنه بعد أربع سنوات، بواسطة زوجته التي استطاعت الحصول على مرسوم بالعفو عنه لأسباب إنسانية، والثاني كان سائقاً في الكويت وقد اختطفه أفراد الجيش العراقي بالقرب من الحدود، أما ما كانوا يفعلونه بنا في السجن فلا يوصف، وأنواع التعذيب يصعب تعدادها والخوض فيها، ربما الآن بعد أن تجاوزت التجربة وباتت بالنسبة لي ماضياً مؤلماً فإنه من المثير للألم تذكرها، وأذكر سجيناً كويتياً كان معنا واسمه (عبد الواحد)، بقي في السجن بعد أن خرجنا نحن ولا ندري مصيره، لم يكن (عبد الواحد) يستطيع التصريح بأنه كويتي أمام الصليب الأحمر، كان هناك ستة أو سبعة كويتيين متهمين بتجاوز الحدود ولكن هؤلاء تم اطلاق سراحهم في سنوات سابقة لسنة 1998، التي اطلق سراحنا فيها وأذكر من الكويتيين (أبو غازي) وآخر اسمه (المطيري) وآخر هو (مشعل الشمري)، بالاضافة إلى سجين قطري، وحدثني مرة أحد المصريين، عن مجموعة أخرى من الكويتيين الموجودين في سجن الرضوانية، حيث قال أن هذا السجن عبارة عن أربعة طوابق تحت الأرض، وتهمة المصري كانت تبديل دولارات في البصرة، إدّعوا عليه بأنها مزورة واقتادوه إلى سجن الرضوانية حيث التقى السجناء الكويتيين، كان ذلك في العام 1991، وأضاف بأنه لولا ثقته بي لما صرح لي بذلك فقد هددوه بالإعدام إن سرب خبر وجود الكويتيين، وقال أيضاً بأن هؤلاء السجناء كانوا يتوسلون بأي شخص يقابلونه لإيصال خبر وجودهم في هذا المكان إلى أهاليهم، وحدثني أيضاً عن سجناء عراقيين من سكان (السماوة) حين خرجوا من السجن ونشروا خبر وجود الكويتيين في سجن الرضوانية، أعادوهم إلى السجن مرة أخرى، وكان الكويتيون الموجودون في سجن أبو غريب لا يستطيعون التصريح أمام لجان الصليب الأحمر ولجان التفتيش بأنهم كويتيون خوفاً من العذاب الذي سيلقونه فيما بعد، من ضرب بالكهرباء وتشبيح، وكان السجانون يبلغونهم مسبقاً بأوامر تنص على عدم التصريح بأنهم كويتيون، وأغلب السجناء الخليجيين كانوا يخطفونهم بطرق شيطانية. حدثني مرة مهندس مصري بأنه كان في الصحراء الكويتية المحاذية للحدود العراقية برفقة مهندس أجنبي وآخر كويتي، وقابلتهم فتاة عراقية نادتهم فظنوا أنها بحاجة للمساعدة ولما ذهبوا إليها وقعوا في الكمين واتهموا بتجاوز الحدود، أما عن مسألة إتصال السجناء بأهلهم كي يعرفوا مكانهم، فقد كانت تتم غالباً عن طريق مساعدة السجناء لبعضهم البعض، حيث يقوم الأهل الذين يزورون إبنهم بتوصيل الأخبار لأهالي الباقين.. وهكذا، حتى رسائل الصليب الأحمر كان ممنوعاً علينا فتحها فبعد أن يغادر أعضاء لجنة الصليب الأحمر السجن، يصادر السجانون جميع الرسائل، وقد نما إلى علم الصليب الأحمر بأن المساعدات لا تصل للسجناء ولا الرسائل، فاتخذ طريقة أخرى هي التسليم المباشر من طرفه، ولم يكن الضباط الصغار فقط هم الذين يقومون بهذه الأعمال، مدير السجن واسمه المقدم (محمد العساف) كان يفرض على المساجين دفع الرشاوى، وهؤلاء لا حول لهم ولا قوة، ولم يقتصر الأمر على هذا بل تجاوزه إلى أن المخابرات تعمل على تجنيد عناصر لها داخل السجن، وكانوا يستعملون كل الوسائل من إجبار أو ترغيب وترهيب، ولقد تعرضت لهذا فقد رزحت تحت وطأة الإضطهاد لعام كامل، وقلت لنفسي فيما بعد عليّ أن أسايرهم حتى أخلص من هذا الوضع، فبدأوا معي عن طريق عقد جلسات لتدريبي وقد كان ذلك في العام 1994، ثم كان لي لقاء بأربعة ضباط مخابرات طلبوا مني التوقيع على “الانتساب للمخابرات العراقية وتنفيذ المهمات التي تطلب مني والبقاء على العهد” وكان هناك تسجيل أيضاً، فيما بعد تم رفع وسائل الضغط عني واعطائي وضع مراقب على السجناء، واخبروني أنني “تحت الاختبار”، ولما سألتهم بأي شيء سأفيدكم وكيف اتصل بكم إذا خرجت من السجن ؟ قالوا نحن نعرف ما الذي نريده منك وستعلم عن ذلك في حينه، نحن نعرف أيضاً كيف نتصل بك، هذه مهمتنا، وبعد فترة طلبوا مني أداء القسم. لم يتصلوا بي طوال السنوات التي أعقبت عودتي إلى الأردن، وكنت بدوري قد أخبرت الحكومة الأردنية بما جري معي في سجن أبو غريب الرهيب حين عدت إ‘لى الأردن، أما ما كنا نتعرض له في ذلك السجن من إضطهاد وقسوة ووحشية فهو يفوق التصور، إستفزازات منتسبي المخابرات وتعذيبهم لنا بالعصي الكهربائية أو بالماء في الليالي الباردة أو بالشمس والتعرض للحرارة الشديدة في الصيف.. وغيرها الكثير.. ما الذي يمكنه أن ينسيني تلك الأيام السوداء والعذابات الرهيبة والجوع والمرض، وجبة بائسة واحدة في اليوم تسمى شوربة هي عبارة عن حفنة أرز في الف ليتر من الماء، ومن أساليبهم أنهم يدعون خراب السيارة التي تنقل الخبز إلينا، كي يجبرونا على شرائه منهم، وكان نصيب السجين (صمونة) كل ثلاثة أيام، وكنا نستيقظ جوعى على صوت عجلات سيارة الخبز وهي قادمة من بعيد ! فتنطلق الصرخات “جاءت سيارة الخبز”. كان الدبلوماسيون حين يزوروننا يصرحون لنا بالقول: أن لكل بلد قوانينها ونحن لا نستطيع التدخل، وكان البعض منهم يضطر لإستخدام لغة الإشارة أو يكتب لنا على ورقة “لا أستطيع الكلام”، ومن ثم يتلف الورقة، وكانت مخصصة لنا زيارة مرة في الشهر، ولكن القادم إلينا لا يكون بمفرده فمعه ضابط من المخابرات ! حتى السفير الأردني (حمود القطارنة)، بقي لعامين متواصلين يبحث عن سجين أردني اسمه (عبد اللطيف خالد أحمد الدعجه)، وهو تاجر سيارات اختطفوه بحجة أنه يعمل لصالح المخابرات الأردنية وبرتبة عميد، وحين إعتقلوه كان معه إبنه الذي تمكن من الهرب وبالتالي أخبر أهله بما حدث، بقي عبد اللطيف في الحاكمية عاماً كاملاً والسفير الأردني لا يحظى بجواب عن مكان أو مصير الرجل ! ليس من جواب سوى الإنكار، وأهل الرجل دفعوا آلاف الدنانير للبحث عن إبنهم في العراق. تمّ الحكم على عبد اللطيف فيما بعد بالسجن ست سنوات، وقالوا له أنه مرة تحدّث مع أحد السائقين وهو في طريق الحصيبة قريباً من الحدود السورية عن أنه لا وجود للجيش العراقي في هذه الصحراء فكيف تكون الحدود محمية على هذا النحو ؟ وقالوا له لماذا تسأل عن الجيش إذاً أنت مخابرات أردنية، هذه هي التهمة الموجهة لرجل في الستين من عمره، ولقد تعرض الدعجة لصنوف العذاب وأشكال التعذيب، هذا الرجل يمتلك كراجاً اليوم في منطقة رأس العين في عمان، هذا واحد من الآف، أذكر أيضاً طالباً أردنياً اسمه (رائد) كان يدرس في جامعة الموصل ويسكن برفقة طالب أردني آخر اسمه (معن الطراونة)، وقع في فخ صاحب البيت الذي كان يستأجره منه، وقد أراد الأخير طرده من البيت فلفق له تهمة الإنتماء للمخابرات الأردنية عن طريق دس صورة لمبنى مخابراتي عراقي في أوراقه وكتبه، وكان جزاء هذين الطالبين الحكم بالسجن لعشرين عاماً. لقد كان صدام حسين ونظامه ضد العرب والفلسطينيين، فلم يسلم من شره إلا القليل من الطلاب الذين درسوا في الجامعات العراقية، كما لم تسلم بيوت وممتلكات الفلسطينيين من المصادرة، وكثيرة هي قصص العذاب والأموال التي عاناها الفلسطينيون في العراق، والذاكرة تفيض بما فيها.. أذكر أن طالباً فلسطينياً حصل معه حادث سيارة في الرمادي واصطدم بصورة صدام حسين، فقالوا له إنك متعمداً ضربت الصورة ! وقد اضطر أهله لدفع عشرين الف دولار لإنقاذ إبنهم الذي تولت الدفاع عنه محامية كردية، عن طريق إدخاله إلى مستشفى الأمراض العقلية لإنقاذه من حبل المشنقة بإدعاء الجنون، ولقد قابلت هذا الطالب في السجن. وفي زمن نظام صدام حسين كانت عمليات السلب والقتل التي تجري على طريق عمان بغداد يقوم بها رجال الأمن العراقيون، إذ يقوم هؤلاء على نصب سيطرات عسكرية وهمية لتفتيش السيارات وسلب ممتلكات الناس، وفي مواقع أخرى كانت السيارات العسكرية تعترض سبل الشاحنات والسيارات وتسلبها، هذا غيض من فيض، فرجال الأمن العراقيون، لم يكونوا حماة أمن المواطن العراقي ولا العربي، بل أداة قمع، إن العراقيين، ومن عاش في العراق من العرب، يعرفون ما حدث للمصريين من تسفيرات ومطاردات ومصادرات لأموالهم وممتلكاتهم، وتطليق زوجاتهم العراقيات. لقد تشردت آلاف العائلات وإنهدمت كثير من الأسر، وكم منهم دخل معسكر الفضيلية - منطقة بغداد الجديدة - الكمالية - بعد المشتل، هذا المعتقل كان للعرب والأجانب وهو عبارة عن مبنى قديم غير مسقوف، ومحاط بالرعاة وقاذورات الغنم والبقر. كانت تتجمع فيه أعداد كبيرة تتجاوز السبعمائة والثمانمائة ولمدد طويلة. كان المعتقلون المساكين يصرخون على الدوام في وجه جلاوزة النظام، “يا أخي ما تريدني سفِّرني” ولم يكن لصراخهم هذا فائدة فقد كانوا يبقونهم لستة أشهر أو سبعة ومن ثم يسفِّرونهم، بعد أن يفلسوهم تماماً، وأنا أعرف واحداً اسمه (إبراهيم رفقي)، كان يمتلك ثلاثة نواد ليلية في شارع الرشيد، وواحد آخر اسمه (زغلول) عنده محلات تجارية وآخر هو (بيومي) كان يمتلك فندقاً، وكانوا يقولون لهم ستخرجون من العراق مفلسين كما جئتم إليه، لن تخرجوا من هنا ومعكم أية أموال ! وكل حاجة يضطر لها المعتقل تكلفه مالاً كثيراً، فإن أراد علاجاً أو طعاماً دفّعوه ثمنه الكثير، وكانوا يبتزونهم بزيارة أهلم تحت الحراسة، وهذا كله يتم بعلم المسؤولين الكبار، وتبقى هذه العمليات الإبتزازية مستمرة إلى أن تنتهي أموال المعتقلين، ومن بعدها يجرى تسفيرهم. وأقول لكل من يظن بأن النظام العراقي كان داعية القومية العربية بأن الحقيقة هي غير ذلك، لقد أساء هذا النظام إلى القومية العربية وإلى العرب إساءات كثيرة، وأبواق الدعاية لهذا النظام مشتراة بالمال والهدايا والغنائم، وطريقة هذا النظام في استضافة الوفود والشخصيات معروفة، فهم يزورون فندق الرشيد ويعيشون في أعلى مستوى، ويعودون محمّلين بالدولارات في الوقت الذي يجوع فيه العراقيون حتى الموت، ناهيك عن الإرهاب والإضطهاد الذي يعيشونه، وهؤلاء يعودوا للهتاف لصدام حسين في المظاهرات فصدام، هو بطل العروبة الذي سيحرر لهم فلسطين ! كيف يحرر فلسطين ولا يحرر شعبه. لقد شهدت في العراق أحداثاً وحالات، لا أتصور أنها تحدث في أي مكان في العالم، كأن تحدث سرقة مواطن في الشارع أمام مركز أمن السعدون في شارع السعدون، إنعدام الأمن داخل المدن العراقية، كان أمراً مدروساً من النظام لخلق حالة من الهلع والخوف بين الناس. هذا غير القصص الخرافية عن إختفاء أعداد كبيرة من البشر، وخطف النساء، وجنازات الموتى التي يخيم عليها الصمت، والموت المجاني في مناطق الأكراد والشيعة. أذكر مرة أن أحد الشباب الذي نجا من الإعتقال في الجنوب العراقي حدثني عن أحد هذه المعتقلات، التي كانت تشهد حفلات الإعدامات الرهيبة على أيدي عدي وقصي ووطبان وطه ياسين رمضان، الذين كانوا يقتلون المئات وهم يرددون “أنتم تريدون أخذ الحكم منا”، هذا الشاب الذي روى لي هذا نجا منهم بأعجوبة. من جانب آخر روى لي شاهد عيان حضر موقعة “الدجيل” القرية التي كان صدام حسين في طريقه لزيارتها، ونُصب له كمين على الطريق، وقد نجا صدام لأنه نزل من سيارته لزيارة خالة له قبل الوصول إلى الدجيل، وبعد أن استأنف المسير لم يستخدم سيارته الأولى، إذ قام بإستبدالها فلما قدمت السيارة الأولى بدأ اطلاق النار عليها، فوقف صدام وقال لأهالي الدجيل: “وين ستفرون مني سأمسك بكم”، وأكّد الرجل الذي شاهد الحادثة بأنه في خلال ربع ساعة، حملت طائرات الهيلوكبتر ثلاثمائة عائلة لم يعرف مصيرها إلى اليوم، ومن ثم أُحرقت المنطقة بمزارعها ونخيلها وتحولت إلى معسكرات. هذه مصائر عائلات ومئات من البشر، وأذكر قصة شاب فلسطيني اسمه (محمد محمود رجب أبو زينة) متزوج من عراقية، حدث أن أخاها أضاع مسدسه، فسألوه أين مسدسك فقال ضاع مني عند أختي، فأخذوا المرأة وبناتها إلى السجن، البنت الصغرى وعمرها أربعة أشهر تقبع في زنزانة ! والمصريون حين كانت لجنة حقوق الإنسان تبحث عنهم كان صدام حسين يضعهم في الباصات وينقلهم إلى أماكن أخرى حتى ترحل اللجنة ! تبقى الباصات تجوب الشوارع طولاً وعرضاً، ومن ثم ينقلهم إلى معتقل آخر (تسفيرات الشعب)، إلى أن تخرج اللجنة من العراق بعد شهرين دون التوصل إلى نتائج ! وأحياناً ينقلونهم إلى معسكر التاجي ويلبسونهم الملابس العسكرية ليظنوهم جنوداً عراقيين ! وبعض هؤلاء جاءوا به إلى سجن أبو غريب فقصوا علينا هذه الحكاية العجيبة. السجون في العراق كثيرة. الحاكمية، الشعبة الخامسة، التسفيرات، الأمن، الجمارك، جهاز الأمن الخاص، الرضوانية، نقرة السلمان في الصحراء في السماوة، وهذا السجن الأخير بدون اتصالات وفي مكان مقطوع عن العالم والذي يريدون نفيه يذهبون به إلى هناك !. إذ من المستحيل أن يصل أحد إلى منطقة هذا السجن، هذا النظام الذي يقول (أرض العرب للعرب) يحول العراق إلى سجن للعراقيين وللعرب، ولا بد لي أن أذكر قصة شاب مصري، قتلوا زوجته العراقية الجميلة الشابة لأنها لم تستجب لرغباتهم الجنسية، وكيف قتلوها ؟ أغار عليهم فدائيو صدام وقطعوا رأسها بحجة (الدعارة)، واختطفوا الطفلين وحكم على الرجل بالسجن في أبو غريب لست سنوات، قال لي هذا الرجل بأنه لا يعرف عن مصير الطفلين شيئاً، وأذكر أيضاً قصة صاحب مطعم الساعة وهو مصري واسمه (أبو وليد)، هذا الرجل كان صدام حسين في مصر يسكن في بيته وهو الذي استدعاه للاقامة في العراق، فلبى الدعوة وافتتح مطعم الساعة هذا الرجل تعرض لكارثة إذ فقد إبنه على يد عدي الذي سعى لإمتلاك المطعم من أبي وليد، وعلى هذا الصعيد وغيره، فلو بقيت أتحدث عشر سنوات عن جرائم هذا النظام فلن أقول كل شيء، وقصص السجناء الذين عايشتهم وقابلتهم في سنوات سجني هم الف وسبعمائة سجين من العرب والأجانب، “350 إيراني، 45 سوري، ووصل عدد الفلسطينيين والأردنيين إلى 101، والمصريون 650، و 11 - 12 كويتي، وسيريلانكيان وأربعة من الروس وجنسيات أخرى”. سجن أبو غريب هو مكان يستمر فيه التعذيب، طوال السنوات التي يقضيها السجين كمحكومية، يعني من غير المنطقي أن يتم الحكم على شخص لعشرين عاماً ويستمر تعذيبه، طوال الفترة، هذا لم يكن يحدث إلا في العراق في ظل نظام الطاغية صدام حسين. الشهادة السادسة أحمد إبراهيم عايد مواليد عام 1952 بدأت العمل سائقاً على خط بغداد - عمان في عام 1982، ولكنني بعدها قررت الاقامة في بغداد والعمل أيضاً. أنشأت عملاً تجارياً في منطقة البياع - شارع العشرين، عملي كان بيع الأدوات الكهربائية. تزوجت من فتاة عراقية (من عشيرة الدليم) وفي شهر أيار عام 1992، وبالتحديد 2/5/1992م أُعتقلت من قبل المخابرات العراقية ووجهت لي تهمة الإساءة للنظام، تمّ توقيفي في شعبة الحاكمية، وفي أثناء التحقيق كانت الإتهامات الموجهة لي تتمثل في أنني أُسيء للنظام، ولم أنتمِ لحزب البعث على الرغم من محاولات زوجتي التي كانت قد عرضت الأَمر علي مراراً وتكراراً، وكانت إجاباتي أن الأمر يمثل اختياراً فكرياً وسياسياً ولكنهم واجهوني بالضرب والتعذيب، وبعد توقيف دام إثنى عشر شهراً، جرت محاكمتي وصدر الحكم علي بالاعدام بتاريخ 24/3/1993، وذلك في محكمة ليلية في المخابرات ومن ثم تم تحويلي إلى سجن أبو غريب، محكمة المخابرات الرهيبة لا دفاع ولا قانون فيها ولا حتى أسماء للأشخاص وإنما مجرد أرقام، ولا محاكمات تجري في النهار، رقمي (1650) وتقرأ لائحة الأرقام ويصدر الحكم في دقائق، حاكموني في مخابرات المنصور، والتهم التي وجهت إلي هي كراهية البعث والتهجم على النظام، والتصريح بالقول أن البلد يشهد اضطهاداً وأن هناك معلومات من خلال الناس عن هذه الأفكار التي أبثها، حسب إدعاءاتهم، وما كان يجري في العراق في ظل النظام السابق هو خارج نطاق العقل والتصور، هناك حكومات متعددة، الجمارك، الشرطة، عدي أو قصي، مخابرات أو جهاز الأمن الخاص وأطراف متعددة وغيرها، والذي يقع بين أيدي هذه الأجهزة لا يمكن معرفة مكانه أو مصيره، ومن ضمن التهم التي وجهت لي هي “قدح مقامات” أي ذم المسؤولين وأعضاء النظام، والكثير الكثير من هذا القبيل، هذا إضافة إلى رفض الإنتماء لحزب البعث ومعاداة توجهاته، وكنت أقول لهم بأنني لا أستطيع الإنضمام إلى الحزب لكي أكون كاتب تقارير عن الآخرين وعن تحركاتهم، لا أذكر أنهم كانوا يذكرون أدلة موثقة ضدي وهو يحققون معي.. لا أذكر سوى أنهم واجهوني بحديث جرى في منزلي مع أناس كنت أظنهم أصدقاء، وأعتقدت أيضاً أن ما كان يدور هو عبارة عن دردشات عادية، لكن الحديث انتقل على أساس أنه معاداة للحزب والثورة والنظام وتسبّب لي بحكم بالإعدام تم تخفيفه إلى السجن المؤبد، بسبب أنني من قطر شقيق وأنني فلسطيني.. الخ هذه الديباجة. بقيت في سجن أبو غريب إلى حين العفو الذي حصل عليه لليث شبيلات. كنا حوالي الواحد والسبعين شخصاً وكان منا عشرون شخصاً مسجونين بدعاوى أمنية ومن هؤلاء ضيف الله وخالد صالح وعدنان عبد القادر وقدير قدري طلوزة، وكان هناك حوالي 48 سورياً حكموا بالتهمة ذاتها، وأذكر قصة طالب من الضفة الغربية وقع فريسة في أيديهم بسبب أنه عبر عن رأيه في موضوع حر في الجامعة، حين كتب “لماذا تم غزو الكويت ؟” هذه الكلمة أوصلته إلى نيل حكم الإعدام الذي تمّ تخفيفه إلى المؤبد، كان هذا الطالب يدرس في جامعة البصرة، وبقي في السجن لمدة عام حين خرج بواسطة مرسوم، فقد عملت والدته مختلف الوساطات ودفعت نقوداً وأنا لا أعرف قيمة ما دفعت بالضبط، ولكني أعرف أنها حصلت على مرسوم بالعفو من صدام حسين. زوجتي (آنذاك) كان لها دور في الموضوع، فقد ساهمت بشكل أساسي في توصيلي إلى حبل المشنقة، وكونها حزبية فمن واجبها أن تعرض عليّ المشاركة في تنظيم حزب البعث هذا أولاً، وثانياً لابد لها أن تكتب تقارير عن المقربين منها فهذا يعتبر واجباً عليها تجاه الحزب، إضافة إلى الترقيات الحزبية التي ينالونها جراء ذلك وهي من هذا المنطلق نقلت لهم الصورة، وأنا أعتقد أن هؤلاء الحزبيين هم عبيد لذلك الحزب، فصدام حسين كان يقول لهم “إذا لم تجد شيئاً تكتب عنه فأكتب عن نفسك” فكيف لا تكتب زوجتي عني ؟ وبالطبع حصلت على ترقية فكل من يكتب عن أحد أو يخبر عن قضية أو يسلم عسكرياً هارباً ينال الترقية، درجة حزبية. لم تكن بيينا أية مشاكل، ودوافعها كانت مادية، كانت تريد الحصول على مكاسب شخصية، وهذا الحال لا يقتصر علي فقط، فأنا أعرف مفوضاً في الشرطة أسمه (عادل) قتل أباه وأخاه، وحين سئل لماذا فعلت ذلك ؟ قال: لقد شتما صدام حسين فاستحق نوط الشجاعة إضافة إلى صلاحيات واسعة تؤهله لمخاطبة وزير الداخلية وبالتالي يفعل مايريد، هذه إحدى القصص التي عرفتها وأنا في العراق، وهي كثيرة وغريبة. أذكر مرة أن أحد الأشخاص الذين كانوا على علاقة بالحزبيين ورجال النظام أَسرّ لي بالقول: أنا كنت (ملازم أول) في حراسة صدام حسين ودخلنا مرة إلى بيت هيثم أحمد حسن البكر، بقيت في الحديقة وعلى مقربة منهم أستمع إلى حديثهم، دار النقاش بين صدام حسين وعدنان خير الله وزير الدفاع ونسيبه - شقيق ساجدة زوجة صدام حسين، وكان الموضوع أن صدام طلب من هيثم أن يطلق زوجته، فكان عدنان خير الله يقول لصدام بأن هذا الأمر غير معقول فهي أم لأربعة أطفال، فقال صدام: هذا ما يريده النظام وعلى هيثم أن يفعل ذلك على الفور ! وإلا قتلته”.. وانتهى الأمر بتطليق المرأة ومن ثم تزويجها من (وطبان) الذي كان وزير الداخلية وهو في الحقيقة اسمه (زبلان) وبالطبع قام بتغيير اسمه منعاً للحرج، هذه قصة حقيقية جرت فلا تستغربوا أن يحدث معي ما حدث، وقياساً للجرائم المروعة التي حدثت في العراق فإن موضوعي بسيط، وأي إنسان عاش مع الشعب العراقي وتلمس معاناته عن قرب يدرك حجم العذاب والخراب الذي سببه هذا النظام للبلد والناس، أما الوضع في السجون العراقية فهو صعب للغاية، مستوى متردٍ من الخدمات وعلى السجين أن يدفع ثمن القفل والكهرباء والماء وكذلك السرير الذي ينام عليه وثمنه خمسة وعشرون الف دينار، أما السجناء العرب فهم مطالبون بتقديم الرشاوى إلى الضباط ومخصصات مالية خاصة بعد كل زيارة يقوم بها الأهالي إليهم وبحجج تحسين السجون والتبرعات وبالطبع هم يأخذون هذه الأموال والعطايا لجيوبهم. والذي لا يعطي من السجناء يتعرض لشتى صنوف العذاب. كان أهلي يأتون إليّ في زيارات متباعدة طبعاً، لأنهم سيسافرون من الأردن إلى العراق، والدي ووالدتي كانا يقومان بزيارتي وقد توفيا. بعد ذلك، الحياة في داخل السجن كانت أكثر من جحيم ولا وجود لكلمات من مثل “حقوق إنسان أو معاملة جيدة أو لمسة ضمير أو أي شيء من هذا القبيل”، كنا نتعرض لعقوبات قاسية مثل البقاء تحت الشمس في أيام الصيف القائظ لنهار كامل أو البقاء في وضع القرفصاء من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءاً، والعلاج كانوا يصادرونه منا بعد أن يقدمه لنا الصليب الأحمر، وكذلك المساعدات التي كانوا يقولون لنا أعطونا كل ما وزعوه لكم فهذا من أموال العراق ! كان هناك سجناء أجانب أيضاً وأذكر منهم واحداً أسمه (ديفيد) وآخر أسمه (مايكل)، أحدهما قبضوا عليه وقد دخل بدراجة هوائية إلى الموصل واتهموه بتجاوز الحدود، وحكموه لثماني سنوات، ولكن تم الافراج عنه بعد أربع سنوات، بواسطة زوجته التي استطاعت الحصول على مرسوم بالعفو عنه لأسباب إنسانية، والثاني كان سائقاً في الكويت وقد اختطفه أفراد الجيش العراقي بالقرب من الحدود، أما ما كانوا يفعلونه بنا في السجن فلا يوصف، وأنواع التعذيب يصعب تعدادها والخوض فيها، ربما الآن بعد أن تجاوزت التجربة وباتت بالنسبة لي ماضياً مؤلماً فإنه من المثير للألم تذكرها، وأذكر سجيناً كويتياً كان معنا واسمه (عبد الواحد)، بقي في السجن بعد أن خرجنا نحن ولا ندري مصيره، لم يكن (عبد الواحد) يستطيع التصريح بأنه كويتي أمام الصليب الأحمر، كان هناك ستة أو سبعة كويتيين متهمين بتجاوز الحدود ولكن هؤلاء تم اطلاق سراحهم في سنوات سابقة لسنة 1998، التي اطلق سراحنا فيها وأذكر من الكويتيين (أبو غازي) وآخر اسمه (المطيري) وآخر هو (مشعل الشمري)، بالاضافة إلى سجين قطري، وحدثني مرة أحد المصريين، عن مجموعة أخرى من الكويتيين الموجودين في سجن الرضوانية، حيث قال أن هذا السجن عبارة عن أربعة طوابق تحت الأرض، وتهمة المصري كانت تبديل دولارات في البصرة، إدّعوا عليه بأنها مزورة واقتادوه إلى سجن الرضوانية حيث التقى السجناء الكويتيين، كان ذلك في العام 1991، وأضاف بأنه لولا ثقته بي لما صرح لي بذلك فقد هددوه بالإعدام إن سرب خبر وجود الكويتيين، وقال أيضاً بأن هؤلاء السجناء كانوا يتوسلون بأي شخص يقابلونه لإيصال خبر وجودهم في هذا المكان إلى أهاليهم، وحدثني أيضاً عن سجناء عراقيين من سكان (السماوة) حين خرجوا من السجن ونشروا خبر وجود الكويتيين في سجن الرضوانية، أعادوهم إلى السجن مرة أخرى، وكان الكويتيون الموجودون في سجن أبو غريب لا يستطيعون التصريح أمام لجان الصليب الأحمر ولجان التفتيش بأنهم كويتيون خوفاً من العذاب الذي سيلقونه فيما بعد، من ضرب بالكهرباء وتشبيح، وكان السجانون يبلغونهم مسبقاً بأوامر تنص على عدم التصريح بأنهم كويتيون، وأغلب السجناء الخليجيين كانوا يخطفونهم بطرق شيطانية. حدثني مرة مهندس مصري بأنه كان في الصحراء الكويتية المحاذية للحدود العراقية برفقة مهندس أجنبي وآخر كويتي، وقابلتهم فتاة عراقية نادتهم فظنوا أنها بحاجة للمساعدة ولما ذهبوا إليها وقعوا في الكمين واتهموا بتجاوز الحدود، أما عن مسألة إتصال السجناء بأهلهم كي يعرفوا مكانهم، فقد كانت تتم غالباً عن طريق مساعدة السجناء لبعضهم البعض، حيث يقوم الأهل الذين يزورون إبنهم بتوصيل الأخبار لأهالي الباقين.. وهكذا، حتى رسائل الصليب الأحمر كان ممنوعاً علينا فتحها فبعد أن يغادر أعضاء لجنة الصليب الأحمر السجن، يصادر السجانون جميع الرسائل، وقد نما إلى علم الصليب الأحمر بأن المساعدات لا تصل للسجناء ولا الرسائل، فاتخذ طريقة أخرى هي التسليم المباشر من طرفه، ولم يكن الضباط الصغار فقط هم الذين يقومون بهذه الأعمال، مدير السجن واسمه المقدم (محمد العساف) كان يفرض على المساجين دفع الرشاوى، وهؤلاء لا حول لهم ولا قوة، ولم يقتصر الأمر على هذا بل تجاوزه إلى أن المخابرات تعمل على تجنيد عناصر لها داخل السجن، وكانوا يستعملون كل الوسائل من إجبار أو ترغيب وترهيب، ولقد تعرضت لهذا فقد رزحت تحت وطأة الإضطهاد لعام كامل، وقلت لنفسي فيما بعد عليّ أن أسايرهم حتى أخلص من هذا الوضع، فبدأوا معي عن طريق عقد جلسات لتدريبي وقد كان ذلك في العام 1994، ثم كان لي لقاء بأربعة ضباط مخابرات طلبوا مني التوقيع على “الانتساب للمخابرات العراقية وتنفيذ المهمات التي تطلب مني والبقاء على العهد” وكان هناك تسجيل أيضاً، فيما بعد تم رفع وسائل الضغط عني واعطائي وضع مراقب على السجناء، واخبروني أنني “تحت الاختبار”، ولما سألتهم بأي شيء سأفيدكم وكيف اتصل بكم إذا خرجت من السجن ؟ قالوا نحن نعرف ما الذي نريده منك وستعلم عن ذلك في حينه، نحن نعرف أيضاً كيف نتصل بك، هذه مهمتنا، وبعد فترة طلبوا مني أداء القسم. لم يتصلوا بي طوال السنوات التي أعقبت عودتي إلى الأردن، وكنت بدوري قد أخبرت الحكومة الأردنية بما جري معي في سجن أبو غريب الرهيب حين عدت إ‘لى الأردن، أما ما كنا نتعرض له في ذلك السجن من إضطهاد وقسوة ووحشية فهو يفوق التصور، إستفزازات منتسبي المخابرات وتعذيبهم لنا بالعصي الكهربائية أو بالماء في الليالي الباردة أو بالشمس والتعرض للحرارة الشديدة في الصيف.. وغيرها الكثير.. ما الذي يمكنه أن ينسيني تلك الأيام السوداء والعذابات الرهيبة والجوع والمرض، وجبة بائسة واحدة في اليوم تسمى شوربة هي عبارة عن حفنة أرز في الف ليتر من الماء، ومن أساليبهم أنهم يدعون خراب السيارة التي تنقل الخبز إلينا، كي يجبرونا على شرائه منهم، وكان نصيب السجين (صمونة) كل ثلاثة أيام، وكنا نستيقظ جوعى على صوت عجلات سيارة الخبز وهي قادمة من بعيد ! فتنطلق الصرخات “جاءت سيارة الخبز”. كان الدبلوماسيون حين يزوروننا يصرحون لنا بالقول: أن لكل بلد قوانينها ونحن لا نستطيع التدخل، وكان البعض منهم يضطر لإستخدام لغة الإشارة أو يكتب لنا على ورقة “لا أستطيع الكلام”، ومن ثم يتلف الورقة، وكانت مخصصة لنا زيارة مرة في الشهر، ولكن القادم إلينا لا يكون بمفرده فمعه ضابط من المخابرات ! حتى السفير الأردني (حمود القطارنة)، بقي لعامين متواصلين يبحث عن سجين أردني اسمه (عبد اللطيف خالد أحمد الدعجه)، وهو تاجر سيارات اختطفوه بحجة أنه يعمل لصالح المخابرات الأردنية وبرتبة عميد، وحين إعتقلوه كان معه إبنه الذي تمكن من الهرب وبالتالي أخبر أهله بما حدث، بقي عبد اللطيف في الحاكمية عاماً كاملاً والسفير الأردني لا يحظى بجواب عن مكان أو مصير الرجل ! ليس من جواب سوى الإنكار، وأهل الرجل دفعوا آلاف الدنانير للبحث عن إبنهم في العراق. تمّ الحكم على عبد اللطيف فيما بعد بالسجن ست سنوات، وقالوا له أنه مرة تحدّث مع أحد السائقين وهو في طريق الحصيبة قريباً من الحدود السورية عن أنه لا وجود للجيش العراقي في هذه الصحراء فكيف تكون الحدود محمية على هذا النحو ؟ وقالوا له لماذا تسأل عن الجيش إذاً أنت مخابرات أردنية، هذه هي التهمة الموجهة لرجل في الستين من عمره، ولقد تعرض الدعجة لصنوف العذاب وأشكال التعذيب، هذا الرجل يمتلك كراجاً اليوم في منطقة رأس العين في عمان، هذا واحد من الآف، أذكر أيضاً طالباً أردنياً اسمه (رائد) كان يدرس في جامعة الموصل ويسكن برفقة طالب أردني آخر اسمه (معن الطراونة)، وقع في فخ صاحب البيت الذي كان يستأجره منه، وقد أراد الأخير طرده من البيت فلفق له تهمة الإنتماء للمخابرات الأردنية عن طريق دس صورة لمبنى مخابراتي عراقي في أوراقه وكتبه، وكان جزاء هذين الطالبين الحكم بالسجن لعشرين عاماً. لقد كان صدام حسين ونظامه ضد العرب والفلسطينيين، فلم يسلم من شره إلا القليل من الطلاب الذين درسوا في الجامعات العراقية، كما لم تسلم بيوت وممتلكات الفلسطينيين من المصادرة، وكثيرة هي قصص العذاب والأموال التي عاناها الفلسطينيون في العراق، والذاكرة تفيض بما فيها.. أذكر أن طالباً فلسطينياً حصل معه حادث سيارة في الرمادي واصطدم بصورة صدام حسين، فقالوا له إنك متعمداً ضربت الصورة ! وقد اضطر أهله لدفع عشرين الف دولار لإنقاذ إبنهم الذي تولت الدفاع عنه محامية كردية، عن طريق إدخاله إلى مستشفى الأمراض العقلية لإنقاذه من حبل المشنقة بإدعاء الجنون، ولقد قابلت هذا الطالب في السجن. وفي زمن نظام صدام حسين كانت عمليات السلب والقتل التي تجري على طريق عمان بغداد يقوم بها رجال الأمن العراقيون، إذ يقوم هؤلاء على نصب سيطرات عسكرية وهمية لتفتيش السيارات وسلب ممتلكات الناس، وفي مواقع أخرى كانت السيارات العسكرية تعترض سبل الشاحنات والسيارات وتسلبها، هذا غيض من فيض، فرجال الأمن العراقيون، لم يكونوا حماة أمن المواطن العراقي ولا العربي، بل أداة قمع، إن العراقيين، ومن عاش في العراق من العرب، يعرفون ما حدث للمصريين من تسفيرات ومطاردات ومصادرات لأموالهم وممتلكاتهم، وتطليق زوجاتهم العراقيات. لقد تشردت آلاف العائلات وإنهدمت كثير من الأسر، وكم منهم دخل معسكر الفضيلية - منطقة بغداد الجديدة - الكمالية - بعد المشتل، هذا المعتقل كان للعرب والأجانب وهو عبارة عن مبنى قديم غير مسقوف، ومحاط بالرعاة وقاذورات الغنم والبقر. كانت تتجمع فيه أعداد كبيرة تتجاوز السبعمائة والثمانمائة ولمدد طويلة. كان المعتقلون المساكين يصرخون على الدوام في وجه جلاوزة النظام، “يا أخي ما تريدني سفِّرني” ولم يكن لصراخهم هذا فائدة فقد كانوا يبقونهم لستة أشهر أو سبعة ومن ثم يسفِّرونهم، بعد أن يفلسوهم تماماً، وأنا أعرف واحداً اسمه (إبراهيم رفقي)، كان يمتلك ثلاثة نواد ليلية في شارع الرشيد، وواحد آخر اسمه (زغلول) عنده محلات تجارية وآخر هو (بيومي) كان يمتلك فندقاً، وكانوا يقولون لهم ستخرجون من العراق مفلسين كما جئتم إليه، لن تخرجوا من هنا ومعكم أية أموال ! وكل حاجة يضطر لها المعتقل تكلفه مالاً كثيراً، فإن أراد علاجاً أو طعاماً دفّعوه ثمنه الكثير، وكانوا يبتزونهم بزيارة أهلم تحت الحراسة، وهذا كله يتم بعلم المسؤولين الكبار، وتبقى هذه العمليات الإبتزازية مستمرة إلى أن تنتهي أموال المعتقلين، ومن بعدها يجرى تسفيرهم. وأقول لكل من يظن بأن النظام العراقي كان داعية القومية العربية بأن الحقيقة هي غير ذلك، لقد أساء هذا النظام إلى القومية العربية وإلى العرب إساءات كثيرة، وأبواق الدعاية لهذا النظام مشتراة بالمال والهدايا والغنائم، وطريقة هذا النظام في استضافة الوفود والشخصيات معروفة، فهم يزورون فندق الرشيد ويعيشون في أعلى مستوى، ويعودون محمّلين بالدولارات في الوقت الذي يجوع فيه العراقيون حتى الموت، ناهيك عن الإرهاب والإضطهاد الذي يعيشونه، وهؤلاء يعودوا للهتاف لصدام حسين في المظاهرات فصدام، هو بطل العروبة الذي سيحرر لهم فلسطين ! كيف يحرر فلسطين ولا يحرر شعبه. لقد شهدت في العراق أحداثاً وحالات، لا أتصور أنها تحدث في أي مكان في العالم، كأن تحدث سرقة مواطن في الشارع أمام مركز أمن السعدون في شارع السعدون، إنعدام الأمن داخل المدن العراقية، كان أمراً مدروساً من النظام لخلق حالة من الهلع والخوف بين الناس. هذا غير القصص الخرافية عن إختفاء أعداد كبيرة من البشر، وخطف النساء، وجنازات الموتى التي يخيم عليها الصمت، والموت المجاني في مناطق الأكراد والشيعة. أذكر مرة أن أحد الشباب الذي نجا من الإعتقال في الجنوب العراقي حدثني عن أحد هذه المعتقلات، التي كانت تشهد حفلات الإعدامات الرهيبة على أيدي عدي وقصي ووطبان وطه ياسين رمضان، الذين كانوا يقتلون المئات وهم يرددون “أنتم تريدون أخذ الحكم منا”، هذا الشاب الذي روى لي هذا نجا منهم بأعجوبة. من جانب آخر روى لي شاهد عيان حضر موقعة “الدجيل” القرية التي كان صدام حسين في طريقه لزيارتها، ونُصب له كمين على الطريق، وقد نجا صدام لأنه نزل من سيارته لزيارة خالة له قبل الوصول إلى الدجيل، وبعد أن استأنف المسير لم يستخدم سيارته الأولى، إذ قام بإستبدالها فلما قدمت السيارة الأولى بدأ اطلاق النار عليها، فوقف صدام وقال لأهالي الدجيل: “وين ستفرون مني سأمسك بكم”، وأكّد الرجل الذي شاهد الحادثة بأنه في خلال ربع ساعة، حملت طائرات الهيلوكبتر ثلاثمائة عائلة لم يعرف مصيرها إلى اليوم، ومن ثم أُحرقت المنطقة بمزارعها ونخيلها وتحولت إلى معسكرات. هذه مصائر عائلات ومئات من البشر، وأذكر قصة شاب فلسطيني اسمه (محمد محمود رجب أبو زينة) متزوج من عراقية، حدث أن أخاها أضاع مسدسه، فسألوه أين مسدسك فقال ضاع مني عند أختي، فأخذوا المرأة وبناتها إلى السجن، البنت الصغرى وعمرها أربعة أشهر تقبع في زنزانة ! والمصريون حين كانت لجنة حقوق الإنسان تبحث عنهم كان صدام حسين يضعهم في الباصات وينقلهم إلى أماكن أخرى حتى ترحل اللجنة ! تبقى الباصات تجوب الشوارع طولاً وعرضاً، ومن ثم ينقلهم إلى معتقل آخر (تسفيرات الشعب)، إلى أن تخرج اللجنة من العراق بعد شهرين دون التوصل إلى نتائج ! وأحياناً ينقلونهم إلى معسكر التاجي ويلبسونهم الملابس العسكرية ليظنوهم جنوداً عراقيين ! وبعض هؤلاء جاءوا به إلى سجن أبو غريب فقصوا علينا هذه الحكاية العجيبة. السجون في العراق كثيرة. الحاكمية، الشعبة الخامسة، التسفيرات، الأمن، الجمارك، جهاز الأمن الخاص، الرضوانية، نقرة السلمان في الصحراء في السماوة، وهذا السجن الأخير بدون اتصالات وفي مكان مقطوع عن العالم والذي يريدون نفيه يذهبون به إلى هناك !. إذ من المستحيل أن يصل أحد إلى منطقة هذا السجن، هذا النظام الذي يقول (أرض العرب للعرب) يحول العراق إلى سجن للعراقيين وللعرب، ولا بد لي أن أذكر قصة شاب مصري، قتلوا زوجته العراقية الجميلة الشابة لأنها لم تستجب لرغباتهم الجنسية، وكيف قتلوها ؟ أغار عليهم فدائيو صدام وقطعوا رأسها بحجة (الدعارة)، واختطفوا الطفلين وحكم على الرجل بالسجن في أبو غريب لست سنوات، قال لي هذا الرجل بأنه لا يعرف عن مصير الطفلين شيئاً، وأذكر أيضاً قصة صاحب مطعم الساعة وهو مصري واسمه (أبو وليد)، هذا الرجل كان صدام حسين في مصر يسكن في بيته وهو الذي استدعاه للاقامة في العراق، فلبى الدعوة وافتتح مطعم الساعة هذا الرجل تعرض لكارثة إذ فقد إبنه على يد عدي الذي سعى لإمتلاك المطعم من أبي وليد، وعلى هذا الصعيد وغيره، فلو بقيت أتحدث عشر سنوات عن جرائم هذا النظام فلن أقول كل شيء، وقصص السجناء الذين عايشتهم وقابلتهم في سنوات سجني هم الف وسبعمائة سجين من العرب والأجانب، “350 إيراني، 45 سوري، ووصل عدد الفلسطينيين والأردنيين إلى 101، والمصريون 650، و 11 - 12 كويتي، وسيريلانكيان وأربعة من الروس وجنسيات أخرى”. سجن أبو غريب هو مكان يستمر فيه التعذيب، طوال السنوات التي يقضيها السجين كمحكومية، يعني من غير المنطقي أن يتم الحكم على شخص لعشرين عاماً ويستمر تعذيبه، طوال الفترة، هذا لم يكن يحدث إلا في العراق في ظل نظام الطاغية صدام حسين. محمد الإدريسي مواليد عام 1940 بدأ مشواري مع المخابرات العراقية بمكالمة هاتفية، وردت إليّ من بغداد من إمرأة عراقية، لا أدري يومها من أين حصلت على رقم هاتفي في عمان، لم تكن معرفتي بها جيدة، وكل ما أعرفه عنها إنها زوجة (حنفي) صاحب فندق نادر الذي كان له عمل مشترك مع ولدي بشير، وهو مدين لابني بثلاثمائة دينار. أبلغتني المرأة بأنها ستدفع لي المبلغ المطلوب والمتبقي بذمته لبشير، وقد سبق لي أن ذهبت إلى بغداد واتصلت بحنفي، الذي وعدني بسداد المبلغ بعد أسبوعين، لكنني عندما عدت فوجئت بزوجته تقول لي أن (حنفي) موقوف لدى دائرة الإقامة (قسم من أقسام المخابرات) وأنها ستبلغه بمجيئي إلى الفندق، جاءت مكالمتها لي بعد أسبوعين من عودتي إلى عمان فإستبشرت خيراً لتحصيل حق إبني، وأذكر أن المرأة طلبت مني أن أشتري لها بعض المواد التموينية التي كانت شحيحة في بغداد آنذاك، في ظل الحصار. غادرت عمان بتاريخ 12/10/1993، متوجهاً إلى بغداد، وأخذت معي ما طلبته المرأة، وفي الموعد المقرر للقاء وهو العاشرة صباحاً، كنت أمام الفندق وداخلني الشك من إقتراب رجلين بسرعة مني، ووجود سيارتين من نوع تويوتا، وإقترب مني أحد الرجلين مرحباً بشكل ينم عن السخرية، وإدّعى أنه يعمل لدى صاحبة الفندق وأنه علينا الذهاب لمقابلتها.. سارت بنا السيارة من ساحة فندق (نادر) في شارع النضال بإتجاه الكرادة، وفي الطريق كان الآخر يسألني عن الشعر وأحوال الشعراء، بعد أن إدّعى أنه يعرفني كشاعر وهو شاعر أيضاً ! ولكنه حين سألته لم يقدم إسماً واكتفى بالقول: أنا شاعر شعبي، لكن المعلومة التي أعطاني إياها فيما بعد أثارت الريبة في صدري. وشعرت بأنني في مصيدة، فقد قال إننا قرأنا الشعر سوية في مهرجان القوى الشعبية، وأنا لم أفعل.. وأذكر أن شاعراً سودانياً شارك في هذا المهرجان ! ولما طلبت النزول، سارع بالقول “نحن نريدك في الإقامة لخمس دقائق” ! مبنى الإقامة من قلاع المخابرات، وإن اختلفت الأسماء، وزيادة على ذلك فإن جميع منتسبيها من حزب البعث. حافظت على هدوئي وحاولت التصرف بحكمة كأي إنسان يدخل العراق ويتحاشى الوقوع في الخطأ، لأن هذا يعني الموت المحقق مهما كانت الأسباب، وأياً كان الشخص فلا شيء يشفع له، وإن كان حزبياً ! المهم تركني الرجلان في الإستعلامات وقد أعطيا إشارة بالعيون وأنا شخص دقيق الملاحظة، إعتاد هذه المواقف وعلمته إياها السنون. ضابط الإستعلامات الذي يلبس الملابس المدنية يحدق بي، وعيون أخرى كثيرة غيره، ما الذي يجري ؟ ولقد إمتد الانتظار من خمس دقائق إلى ما يقرب الساعة، أجلس تارة وأمشي تارة أخرى، مشعلاً سيجارة ومفتعلاً الهدوء وعدم الاكتراث، لكن بدأت أشعر بالقلق، بعد أن مضى من الوقت نصف ساعة أخرى، في هذه الأثناء دخلت إمرأة تلبس عباءة وتعمدت المرور من أمامي ثم دخلت المصعد.. حاولت التذكر إن كنت أعرفها أو رأيتها من قبل. ولما تذكرت أخيراً إنها (أم نادر)، أحسست بأنني فعلاً في مصيدة. ما هي إلا دقائق حتى حضر الشخصان، وإقتاداني إلى سيارتهما ثم سألاني عن جواز سفري، فأخبرتهما بأنه داخل سيارتي في منطقة العامرية. فتوجهنا إلى هناك وكان الحديث هذه المرة مقتضباً وجافاً، ومن سيارتي، أحضر أحدهم حقيبتي وفيها جواز سفري وبعض النقود الأردنية والعراقية، وفيها ما هو أهم من ذلك بكثير، مخطوطان يحتويان على نحو ثلاثين قصيدة لا أملك نسخة أخرى منها، ولا أحفظ منها بيتاً واحداً. ذهبن مع كل محتويات الحقيبة -التي تسلمتها من مكتب النقل البري في الفلوجة عند خروجي- فارغة إلا من بعض الملابس القديمة. توجها بي إلى حي المنصور، وعندما إقتربنا من الحي دفع أحدهم رأسي إلى الأسفل بقوه ولخمس دقائق، كدت أختنق خلالهن.. وصلنا المكان وسلّماني إلى رجل يجلس خلف الطاولة، قام بالتوقيع على ورقة، ومن ثم الترحيب بي من باب الإدعاء أنه يعرفني كشاعر، لكنه وصل إلى المطلوب حين قال: إسمع شاعرنا، أنت هنا تحمل الرقم 864، ولا أحد هنا يعرفك بغيره، وعليك أن تحفظه، قلت له: هل أنا موقوف ؟ ولماذا ؟ قال: نعم ولا أدري لماذا فأنا هنا فقط للإستلام. إن من أحضرك فقط يعرف لماذا، فإختر لك بطانيتين من الخارج لتتدبّر أمر نومك. آه، قلت لنفسي، هذه هي جهنم وبئس المصير، هذا هو المسلخ، هذا هو المطبخ، من هنا يبدأ الذبح ثم السلخ ثم التقطيع حسب الطلب، ومن ثم الطبخ فلا يخرج أحد من هنا إلا وهو جاهز، والعودة إلى هنا ثانيةً من أحد المستحيلات، لا فالعودة تعني أن هناك نقصاً ما في التحقيق، وهذا طبعاً يكلف المحقق حياته أو مصيره، وهو يعرف هذا جيداًً. أخذت البطانيتين، ومن ثم دخل هو والحارس الذي يحمل بيده عُصابة توضع على العينين، كي لا أرى من أين أسير أو إلى أين سأذهب، ولكنه لم يثق بأن أضع العُصابة بنفسي حين وضعتها أول مرة، فأمسك بيدي وأبعدها، ثم أخذ يصلح من وضعها بشكل محكم، وقادني عبر طريق تتخلله بعض درجات صعوداً ونزولاً لمدة زادت على الخمس دقائق. بعدها أوقفني ونزع العُصابة، ووضعها على المزلاج الذي بواسطته يغلق الباب من الخارج. كان رقم الزنزانة (1) وهي إنفرادية. دفعني إلى داخلها وكانت لا تتسع لأكثر من نصف شخص. طأطأت رأسي وأنا أدخل من الباب، فالسقف لايرتفع عن مستوى الباب كثيراً، والمساحة كلها لا تزيد على متر ونصف مربع. أغلق الباب خلفي بالمزلاج فأطبق الظلام بعد ذلك. رحت أتحسس المكان وأفكر في إبتكار القدرة على إحتقار الإنسان، وهل هؤلاء الذين يتعاملون معنا بشر مثلنا ؟ يفرحون ويحزنون وكيف يتعاملون مع أبنائهم وزوجاتهم ؟ ما هو تكوينهم ؟. المهم وجدت كيساً مملوءاً بأشياء صلبة خلتها حجارة. تهاويت عليه منهكاً منهاراً لا أشعر بما هو تحتي وإن كانت مسامير . تبين لي فيما بعد أن ما أجلس عليه هو بديل الخبز هنا.. لا أدري كيف جاءني النوم لكني نمت. وفي صباح اليوم التالي سمعت من ينادي على رقمي.. أنا صرت (864) دون أن أدرك بعد ماذا يعني ذلك ؟ قادني الحارس من بعد حفلة تعنيف لأنني لم أرد، قادني والعُصابة على عينيّ إلى أعلى بضع درجات، ثم أنزلني بضع درجات أخرى، يخيل إليّ بعد طول هذه المسافة أنني لم أبتعد عن زنزانتي إلا بضعة أمتار، ولكن هذا كله كان للتمويه. ثم أوقفني قرب أحد الأبواب، وقال: أدر رأسك إلى الحائط، ففعلت. أمرني بالجلوس مقرفصاً ففعلت، تركني بعدها لأكثر من ربع ساعة. لقد غاب عني متعمداً ليترك لي مجالاً لرفع القناع عن عيني بعض الشيء، فهو يعلم تماماً، وهذه عملية غريزية، أن المرء يتفحّص ما حوله، ففعلتها، لأجدني أجلس أو أقرفص على بضع قطرات من الدم، وُضعت أو جُعلت أو تُركت بشكل أو بآخر وبأسلوب مكشوف وساذج، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على الإفلاس الفكري أو الإستخفاف بمن يتعاملون معهم، فليس كل الناس أغبياء مثلما يفترضون. هم لم يكونوا مفلسين، فمن يعمل مع المخابرات يجب أن يكون حاضر البديهة، ويتمتع بذكاء خارق وحاد؛ أي سوبرمان، فهذه هي مقومات عمله، بالإضافة إلى كونه، سليط اللسان وغليظ القلب، أما العلم والأدب والإنسانية فهي غير مطلوبة في عمله، مددت يدي إلى بقع الدم التي قرفصني فوقها الغبي، لمسته بأصابعي ثم فركته ما بين الإبهام والسبابة، فلم أجد به لزوجة. وما هذه إلا مجرد مادة الميكروكروم المطهرة، والعملية عملية ترهيب، إنه أسلوب رخيص ومكشوف وفاشل. قادني الحارس مرة أخرى إلى غرفة مجاورة، وأجلسني على كرسي.. إنه لا يزال يتناسى إحكام العُصابة على عينيّ.. جلت بنظري إلى المكاتب فوجدت جواز سفري على الطاولة، رفعت رأسي للأعلى فرأيت وجه المحقق عندما أدار رأسه ناحيتي، واكتشف وضع العُصابة غير السليم، فبادرني بصفعة على وجهي وأعادها إلى الأسفل، فحجب عن عينيّ كل شيء وأعادني للظلام ثانية. ومن الجوار بدأت تصلني أصوات الإستعطاف والإسترحام وآهات الألم وصرخات البكاء، وقد تركني المحقق بعض الوقت أستمع إليها عن قصد، فأدار وجهه إليّ بعد أن شغل الكاميرا حيث سمعت أزير صوتها. قال لي أنت في المخابرات العراقية. فقلت مع الأسف. فزاد بالقول: “ليش ولك مع الأسف، أنت محظوظ لأنك في زنزانة لا ينزلها إلا العظماء أمثال الشاعر شفيق الكمالي، ثم أنا نزلت بها، ومدير المخابرات السيد سبعاوي حين غضب عليه الرئيس نزل بيها، وكذلك منيف الرزاز وعلماء وشعراء، أنت لازم تحمد ربك!”. حاولت التكلم فقال: اسكت، أنت هنا موجود بتهمة تهريب، كونك شاعراً فهذا شيء وهذا شيء آخر، الحسنات لا يذهبن السيئات، نحن نحفظ لك مواقفك، لكنك أنت هنا اليوم لتحاسب على جريمة التهريب، تهريب أشخاص للعراق (وهذه جريمة عقوبتها خمسة عشر عاماً إذا كان الشخص سورياً أو إيرانياً وخمس سنوات إلى سبعة إذا كان مصري الجنسية، وثلاث سنوات إذا كان أردنياً أو سعودياً)، وإستطرد بأن الشهود موجودون، والأشخاص الذين هربتهم هم مصريون ليس لهم أي نشاط سياسي وغير خطرين على الأمن، لكنهم مبعدون عن العراق، لأن عملهم كان في النوادي الليلية وهذه النوادي مُنعت، لذلك وجب تسفيرهم. ولكنهم أو غالبيتهم حقيقةً لا يستطيعون الإبتعاد عن العراق، فمنهم من تزوج عراقية، ومنهم من لا يستطيع العودة إلى مصر لأسباب عدة، وهي أنهم حصلوا على الجنسية العراقية وشاركوا في الحملة الإعلامية المناهضة للسياسة المصرية في إنحيازها ضد العراق في حرب الخليج، وغالبيتهم شاركوا مع العراق في الحرب ضد إيران، وهؤلاء تم تسفيرهم بطريقة تعسفية؛ إذ أُقتلعوا من منازلهم ووضعوا في السجون كي يتنازلوا عن ممتلكاتهم وأموالهم، ومن ثم نقلتهم سيارات حكومية إلى الحدود الأردنية دون أن تكون معهم أجرة الطريق، وكنت قد سمعت عن التسفيرات في المعتقل سيء الذكر. المصيبة الكبرى التي حلّت بهؤلاء هي تخليهم عن جنسيتهم المصرية والحصول على الجنسية العراقية، وهم اليوم لا هذا ولا ذاك ! هذا هو الضياع بعينه.. بعد أن لاحظ المحقق شرودي وإنشغال فكري، بادرني بلطمة على وجهي كي أفيق من غفلتي، تحسست مكان اللطمة وقد أصبحت خبيراً. فعرفت أن الضربة كانت بفردة حذاء ! وما أن فعلت ذلك حتى بادرني بالأخرى في الجهة الثانية.. تأتي الضربة مفاجئة' ويعاجلني بالسؤال: رضا عبد العزيز وآخرون، ألم تهربهم إلى الأردن ؟ ولما أنكرت، نصحني بالتفكير حتى مساء الغد، فالإعتراف وحده ينهي كل هذه المعاناة. وأضاف بأنه وعد المدير بإنهاء الموضوع سريعاً ومساعدتي لأنني شاعر ولا تجوز الإساءة لي في السجن، فما هذه إلا مجرد إجراءات روتينية !، وأعطاني المحقق (الرؤوف) حتى الساعة الرابعة من مساء الغد موعداً، وما بينها فرصة للتفكير ! قادني الحارس هذه المرة إلى زنزانة أخرى تحمل رقم (8). وجدت فيها ثلاثة أشخاص. بدأوا يعرفونني بأنفسهم، فالأول اسمه (أبو عبد الحكيم الزوبعي) وهو من إحدى العشائر المشهورة القاطنة حول بغداد. عشائر زوبع في منطقة (أبو غريب) أما الثاني فهو شاب سوري، والثالث شاب مهزوز إسمه (عليوي حسين الدليمي)، سألت الأول عن تهمته فقال بأنه اشترى بندقية رشاشة من شخص ما، فتبين أنها مسروقة من الحرس الجمهوري. أما عليوي فقد أودع عنده أحد أصحابه بعض النقود وتبين فيما بعد أنها مزورة. أما الشاب السوري فقال إنه فار من سوريا، حيث كان يعمل شرطياً في منطقة حلب قريباً من الحدود، وسلّم نفسه لأنهم في سوريا كما يقول إكتشفوا بأنه موالٍ للعراق. أصعب لحظات هذا المكان اللعين ساعات ما بعد الظهر، فالكل يكون مشدود الأعصاب مرتعباً. من فترة التعذيب، لا التحقيق حسب إدعائهم، والعودة منها تكون مصحوبة عادة بكسر أحد الأطراف أو أحد الأضلاع، أو الأسنان أو الحروق الناجمة عن الكهرباء أو النار. والكهرباء لها دور كبير في إنتزاع كل ما يريدونه من أقوال، إن لم يكن في الجلسة الأولى فسيكون في الجلسات التي لا تنتهي، إلا بعد أن يصلوا إلى ما يريدون فليس المهم الحقيقة، المهم أن يحصلوا على أكبر عدد من المدانين بالتهم التي تجلب لهم رضا المسؤولين وتبرز مدى نشاطهم. أما الدور الثاني الذي لا يقل عن الكهرباء. فهو تعليق الرجل على الحائط مع تجميع أكتافه إلى الخلف، وهذه تخرج من موضعها منذ اللحظة الأولى، يرافقه الضرب بالعصي والهراوات، وإنه إما الإعتراف وإما.. وحتى بعض الحالات يجري التحفظ عليها حتى بعد الإعترافات بالصورة والصوت والتوقيع وهذه تبقى بعيده عن كل مراجعة ودون محاكمة أو خروج، كثيرون هم الذين قضوا نحبهم قبل التحقيق أو أثناءه ممن عندهم مضاعفات صحية أو مشاكل في القلب. والحالات التي يجري التحفظ عليها طويلاً من الصعب إكتشافها، فالأرقام تتغير كل عام، والرقم يبدأ عادة من واحد إلى ما لا نهاية حتى آخر يوم في السنة ثم يبدأ من جديد. مع بداية العام الجديد. وإحدى هذه الحالات شقيقان من مدينة (مادبا) الأردنية تم إغراؤهما بالعمل في العراق من قبل المستفيدين فأوقعوا بأحدهما ليحاول الثاني القيام بالوساطات فاعتقله رجال المخابرات، ووضعوا كل واحد منهما في طابق من المبنى كي لا يلتقيا. المهم أنني بدأت التعايش مع الجو المحيط بي واسترحت كثيراً للبدوي الزوبعي الذي نصحني بالإعتراف، لإنهاء المعاناة وذكر لي كيف أن أخاً له سبق وأن خدم في هذا المكان اللعين كمحقق، وهو الآن ضابط في الأمن برتبة مقدم، ومسؤول عن قسم الدورة (من أحياء بغداد)، ولأنه لم يكن بارعاً في التحقيق حسب ما يريدونه، نقلوه إلى الشرطة، ولما قلت له كيف أعترف بما لا أساس له من الصحة ؟ قال لي: إعترف هنا، وعندما تخرج للمحاكمة إشرح لقاضي التحقيق بأنك إعترفت من جراء التعذيب (قاضي التحقيق هو تحقيق آخر يأخذ الإفادة قبل أن تدخل القضية إلى القاضي بشهر تقريباً). وتبدأ أسراب القمل بالزحف من الجوار، للقمل عدة أشكال وألوان وأحجام، وهناك البق والبعوض ولكل دوره في التعامل مع القادم الجديد، وعن ماذا يمكنك الحديث في السجن.. قذارة المكان أم عذاب الناس.. رداءة الطعام أم ترقب الذبائح لذابيحها، والذبائح أول الأمر تقاوم بكل ما أوتيت من قوة، رافضة اقتيادها للذبح.. ولكن شيئاً فشيئاً تضعف مقاومتها والقائمون على الذبح يفضلون (النعم) فهي الكلمة المفضلة عندهم، يجب أن يسمعوها، فمن يقول (لا) لن يقولها طويلاً، وهم أيضاً لا يحبون (اللا) ولا يحبون سماعها، والسؤال عند التحقيق يبدأ بكلمة أنت فعلت كذا وكذا، صح ؟ طبعاً صح، إن لم يكن الآن فإنه صح ومليون صح لاحقاً. أما الإعدام وأماكنه فكثيرة وطرقه أيضاً متعددة، إما في معسكر الرشيد وإما في سجن أبي غريب، وإما في مبنى المخابرات أو في مبنى الأمن الخاص، وعلى أية حال يتم دفن الذي يتم إعدامه، بعد أن تؤخذ منه بعض الأعضاء مثل العينين: إحداهما أو كلتاهما، ففي أغلب الأحيان إن كان عراقياً وسيسلم إلى ذويه تؤخذ إحدى عينيه. شاهدت هذا عندما أعدم صديق لي عام 1992 إذ أعدم في الحي الذي يسكنه، لا أحد يلمسه حيث يسلم إلى أهله مباشره وهذه الحالات فقط للعسكريين، حيث يتم ربطه إلى أحد الأعمدة ويطلق عليه الرصاص أمام أهل حيه وأهله. قصتي الطويلة وأنا في قبضة أبناء الجحيم، بدأت تتشابك خطوطها، وتتعقد جراء ما أدعوه من شهادة (عصام العامل في الفندق والموقوف لديهم أيضاً) و(أم نادر) التي كانت تآمرت مع رجال الإقامة على زوجها لتجريده من ممتلكاته، والمحقق بعد هاتين الشهادتين يسعى لتركيعي، وأمام إنكاري، ينصب الويل فوق رأسي والضرب كالمطر ينهال عليّ لتبدأ حفلة تعذيب من نوع آخر، تعذيب جنسي من بعد التعذيب الجسدي والنفسي، وبدأت حفلة بعد حفلة، وبدأ التسجيل بواسطة كاميرا الفيديو، إنها حفلة إعترافاتي: نعم نعم لكل سؤال، إلى آخر الحلقة فإكتفى (السجّان) من كثرة النعم وتكرارها، لأنه سينال رضا مسؤوليه، وكان قد أقسم لي (وهذا راس صدام يوم الأربعاء إنت مو هنا).. عدت إلى زنزانتي نفسها الزنزانة رقم (8)، لتقابلني مواساة وتعاطف ساكنيها، وهم أشخاص بالكاد أعرفهم، وإن عرفتهم فلا أعرف عنهم إلا القليل.. كنت في هذا الموقف بحاجة إلى العاطفة التي لم أرها في هذا الزمن، فقد فقدت والدتي قبل عشرين عاماً.. في هذه الأثناء أحضرو لنا شخصاً آخر مصري الجنسية، يعمل حارساً لعمارة قيد الإنشاء، إفتعلوا معه مشاجرة لجره وإبعاده عن مادتي الإسمنت والحديد اللتين يحرسهما. أحضروه بتهمة شتم الرئيس، وهذه تهمة عقوبتها الإعدام بشهادة ثلاثة أشخاص، وهي عقوبة منصوص عليها في القانون، ولما أخبرناه بذلك إنهار.. أخذ يبكي ويضرب على رأسه ويتبول ويتبرز في ملابسه.حالات إستغلال البسطاء والمساكين ليست جديدة على غالبية رجال الأمن، فهم الذين يمتلكون صلاحيات إستثنائية وقوانين خاصة تحمي تصرفاتهم وسلوكياتهم المزاجية. الساعة الآن هي الرابعة واليوم هو الأربعاء على أغلب الظن، ولا أدري ما هو التاريخ.. فتحت الزنزانة وطلبني الحارس بالرقم.. لم أستطع أن أودع من معي، لأنه ممنوع.. ودعتني أعينهم بدعاء صامت وفرحة لا تخلو من الحسد الحميد المحبب، فالخروج من هنا، مجرد الخروج، ولو إلى حبل المشنقة هو الخلاص بعينه.. قادني الحارس دون أن يغمض لي عينيّ هذه المرة، والمكان هو المكتب الأول الذي إستبدل بإسمي رقماً.. إستلمت أشيائي (أي ملابسي)، وكان معي في المكتب نفسه شخص آخر مفرج عنه، هو عراقي الأب وإيراني الأم، لكنه نزيل هذا المبنى لأكثر من مرة، لكون أمه إيرانية. رآني وأنا أستغني عن ثلاث علب سجائر لأعطيها للحارس، فطلب مني متوسلاً علبة واحدة، أتبع طلبه بتنازلات للحارس لأنها أصبحت ملكه حتى وصلت التنازلات لطلب سيجارة واحدة، لكنه لم يأخذ شيئاً. قال له الحارس (هل يؤخذ من جهنم حطب ؟ شو أنت مخبل ؟ (مجنون)). هذا المسكين أُبعد إلى إيران أكثر من مرة مع أمه، ولكنه في كل مرة يعود فيها إلى مدينة بعقوبة شمالي بغداد حيث يعيش والده واخوانه من أبيه، وحيث ولد هو وأبوه، يلقى المصير نفسه بتهمة تجاوز الحدود بإعتباره أجنبياً يتبع والدته وليس والده، وكان يحكم مدداً قصيرة وأحياناً يبعد دون محاكمة. هذه المرة إدعى الجنون وأُودع (الشماعية) مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يصبح مجنوناً بالفعل وإن كان من أعقل العقلاء. تم نقلنا أنا وإياه من مبنى المخابرات بالمنصور إلى معتقل الفضيلية، إنه معتقل بناه الانجليز في عهد الاستعمار، وهو سراديب تحت الأرض أقيم فوقها ثلاثة عشرة غرفة، فيما استعملت السراديب لجر المياه العادمة، فإذا نزل المطر امتلأت السراديب وأخذت المياه تتدفق منها إلى ما يسمى بغرف المعتقل حيث يبقى الموقوفون وقوفاً أياماً وليالي، فالمكان يصبح كالمستنقع حتى يتوقف المطر. وهل يتوقف مطر بغداد أيام الشتاء إلا لماما. لم أدعُ ربي بوقف المطر طوال حياتي إلا في هذا المكان اللعين. الحديث المستفيض والإحصاء الكامل لكل ما حدث ومتابعة كل قضية أو شخص كان موجوداً معنا أمر صعب. الأحداث كثيرة والأشخاص كذلك، وهذا ما يحتاج لمجلدات كبيرة جداً لتدوينه. ففي كل يوم يحضر أشخاص جدد وقضايا جديدة، منها المهم ومنها غير الملفت للنظر لتفاهتها. وهناك أشخاص من دون قضايا، مثل شاب من بنغلاديش حضر للعراق من أجل زيارة مقام الإمام عبد القادر الجيلاني، فهو ينتمي إلى طائفة القادرية الإسماعيلية، التي لا أدري ولا أعرف عنها شيئاً. حضر في مركب مع آخرين من إيران، وبينما هم في شط العرب صادفتهم إحدى الدوريات ولم يستجيبوا لنداءاتها بالتوقف وتسليم أنفسهم، تم إغراق مركبهم ففقدوا كل شيء حتى جوازات سفرهم، أحدهم توفي بعد أيام في سجن البصرة والثاني حُوّل إلى (الشماعية). والباقون غرقوا .. طالت إقامته، فأصيب، كغيره ممن تطول اقامتهم هنا، بخلل عقلي نتيجة للضغط النفسي، وحولوه إلى مستشفى الشماعيــة (مستشفى الأمراض العقلية) الذي لم يكن صدفة وجوده بالقرب من هذا المكان، فمعظم نزلائه من خريجي السجن الخطير العظيم ومن المقيمين فيه سابقاً. جرت محاكمتي صباح 22/11 في قفص خشبي قبالة ثلاثة قضاة فوق رأسهم صورة لصدام تعلوها آية كريمة {وإن حكمتم فأحكموا بالعدل}، ولم ينهض المحامي الموكل بالدفاع عني إلا ليقول جملة واحدة “أرجو من محكمتكم الموقرة تخفيف الحكم والرأفة بموكلي فلان”. الموقف لا يحتاج إلى تخاذل، فالمسألة مسألة حياة أو موت، ولماذا احتاج المحامي، فلست عاجزاً وسلاحي أنني بريء فلماذا التخاذل ؟. وقفت ودافعت عن تفسي، لأنها كانت فرصتي الأخيرة ولن أجعلهم ينجحون في ظلمي كما فعلوا في التحقيق، كشفت للقاضي عن آثار التعذيب الذي كنت أخفيه عن أعين المسؤولين والموقوفين كي لا يؤخروا محاكمتي، ثم أحضروا الشاهد (رضا المصري) الذي شهد لصالحي، ونطق القاضي ببراءتي.. صحت بأعلى صوتي: يعيش العدل يعيش العدل، ودفعت الباب الخشبي للقفص لأخرج، لكن عباس وهو الاسم الحركي للمسؤول في أثناء المحاكمة والحارس أمسكا بيدي، فقلت ماذا وقد نطق القاضي بالبراءة، قال عباس: نعم، قال براءة ولكنه لم يقل إفراج ! وسألته ما الفرق ؟ فقال: الفرق كبير فالآن نحن نريد أن نميز عليك الحكم، فإذا جاء التمييز إيجابياً نظرنا في مسألة خروجك، ثم أعادوني إلى المعتقل ونقلوني من الغرفة مرتين، ووضعوا قربي جاسوساً له ضحايا كثيرون، حاول الإيقاع بي وإستخدام آلة التسجيل ليحصل على دليل، خاصة وهو يفتعل النقاش السياسي في شخص صدام، أو يعيد عليّ أبياتاً من شعري كان قد حفظها من أجل التهمة ! هذا الجاسوس حاول الإيقاع بشخص ليثبت عليه الإنتماء لمنظمة (شهود يهوه)، كما قاد شاباً نجفياً إلى الإعدام. هذا الشاب المسكين حاول التخفي باسم مصري لمشاركته في الانتفاضة أو (الغوغاء) كما كانوا يسمونها، ولم أكن أصدق القصة التي إختلقها الجاسوس على أنها سبب سجنه، طبعاً هو كاذب، هو ليس سجيناً، هنا، بل جاسوس، أي أنه في مهمة في (الفضيلية) ولن أنسى علياً -رحمه الله- وهو يردد حينما أخذوه.. أنا انتهيت راح يعدموني. إلتقيت في الفضيلية بشيخين جاءوا بهما من أحد المساجد في بعقوبة وتهمتهما الإنتماء إلى مذهب “الوهابية”، وطلب مني الجاسوس أن أتقصى له أخبارهما ليرضى عنى رجال المخابرات، فهذه المهمة سوف تسهل عملية إخراجي من هنا، وكم كانت صدمته كبيرة عندما رفضت وشتمته، فبدأ يسعى إلى تطويل مدة اقامتي بشتى الطرق وأنواع التهم جراء رفضى التعاون وتحذيري من هؤلاء الشيوخ. وفي السجن قصص وحكايات، فهل أنسى مثلاً (رمضان غلوم) كويتي المولد، لكن بلا جنسية كويتية ويسمى بالقانون (بدون)، وحكايته أنهم يريدون إبعاده إلى إيران، وهو يرفض فهو ينتظر رداً من الصليب الأحمر للعودة للكويت هو وابن خالته حيدر، منذ أكثر من عام، والمماطلة جارية والوعود الكاذبة لا تنضب، أم (سالم السوري) الموقوف هنا قبلي بعام من دون أي تهمة، وقد مزقوا جواز سفره وإستغلوا زوجته أبشع إستغلال، أم الفتاة الكويتية ذات السبعة عشر ربيعاً والتي حملت سفاحاً منهم، وغيرها الكثير. والحال في “الفضيلية” أفضل بكثير مما هو علية في “الشماعية”، لأن بعض العقل يبقى للخارج من الأول بينما يفقده كاملاً في الشماعية، هكذا قال لي عاقل عائد من هناك، وعلى الرغم من تنوع جنسيات القابعين في سجون صدام العديدة إلا أن الإيرانيين العربستانيين في الجنوب، والأكراد في الشمال هم الأكثر عدداً في السجون العراقية، وتوالت الأيام والليالي في معتقل الفضيلية، فالنهار هنا هو إمتداد الليل والليل طويل يزيده النهار طولاً ثقيلاً بطيئاً بليداً، هنا الإنسان معلق بين الموت والحياة، بين الحكم عليه بالسجن أو البراءة، فالبراءة كالعملة النادرة، لا يتعاملون بها وإنما ينحصر تفكير السجانين بزيادة العدد وتطويل المدد، والمجتهدون من أصحاب الخبرة بالأحكام كثيرون من المقيميين معنا في هذا القبر الجماعي، وكل يدلو بدلوه، فمن أين للنفس أن تهدأ وكيف يأتينا النوم ؟ وإن أقل حكم هنا هو “كعكة” أي خمس سنوات هكذا هي التسمية بلغة الموقوفين. ومن كثرة حساب الأيام يجد الإنسان نفسه وقد بدأ ينسى، فلا يجد قربه من يسعفه على التذكر، لأن الكل بدأ ينسى، وعندما تسأل الحارس عن اليوم أو التاريخ أو الساعة، لا تجد جواباً سوى السخرية التي يتبعها بشتيمة من العيار الثقيل. كانت حسابات المخابرات تخطط لسجني عشر سنوات، متجاهلين قناعات القضاة الثلاثة الذين حاكموني فمحكمة الجنايات هنا يحكم فيها ثلاثة قضاة، ولا أدري إن كان هذا معمولاً به في المحاكم الأخرى. وحين أعادوني إلى المعتقل، كانوا يفكرون في أسلوب آخر وفي تهمة أخرى يوجهونها إليّ فسلطوا عليّ مخبريهم داخل المعتقل حيث لازموني كظلي وكانوا كثراً، ولكنني أخذت من الجرعات الوقائية ضدهم ومن الدروس، ما يكفى لأن يجعلني معلماً في هذه اللعبة، فطالت اللعبة ! الأحداث كثيرة، والمعاناة كثيرة، وسردها بتسلسل يحتاج إلى الكثير وتذكرها يحتاج لأكثر، كذلك نسيانها أو تناسيها فإنه يحتاج ما يحتاج، فالجرح عميق والألم شديد والتحمل فوق ما أطيق، أُقفلت جميع السبل فما من طريق للنجاة والخروج إلا وباءت بالفشل. بعد مرور أربعة أشهر أصبحنا أحد عشر أردنياً واثنين من اليمن، تضامنا معنا عندما قررنا الإضراب عن الطعام، سبقنا إلى هذا المصريون قبل مجيئنا إلى المعتقل، فأذا قوهم عذاباً لا يطاق وتوفي أحدهم فوضعوه في حاوية القمامة ثم أخرجوه، هكذا أخبرنا من نجا منهم، أما اليمنيان فقد أضربا عن الطعام قبل هذه المرة ولكنهم تحايلوا عليهما فأنهيا الإضراب بعد وعدهم بإخبار السفارة لتسلمهما وتسفيرهما كونهما دون تهم ضدهما، فالأول ألقوا القبض عليه لأنه موجود بالبصرة، وهذا يعني أنه تجاوز مكان إقامته، والثاني ذهب إلى بلدة سنجار في الشمال ليستطلع أمر مذهب الزيدية، فغالبية اليمنيين زيديون، أما في العراق فهم مختلفون تماماً فلهم ديانة أخرى لها أسرارها ولها صلاة بعبادة لما يسمونه طاووس أي (الشيطان) فألقى عليه القبض هناك وجئ به إلى بغداد بتهمة تجاوز الحدود، وبقي سنة دون محاكمة. إتفقنا على الإضراب عن الطعام من الدرجة الثانية في بادئ الأمر، وإذا لم يستجيبوا لمطلبنا وهو إبلاغ السفير الأردني عن رغبتنا برؤيته أسوة بجميع السفراء الذي حضروا لمقابلة رعايا دولهم، رفعنا الإضراب إلى الدرجة الأولى. إنقلبت الدنيا في المعتقل، هددونا وأعادوا التهديد وإحتاروا في أمرنا مثلاً قال لي مدير الإقامة عندما طلبت مقابلته وحضر إلى المعتقل، قال: ألا تعلم أن الإضراب عن الطعام في الإسلام حرام إذا كان يسبب الموت ؟ إلتفوا علينا بإخراج اليمنيين إلى مبنى الإقامة لمقابلة السفير اليمني ولم نرهما ثانية، طلبوا فيما بعد إثنين منا بحجة مقابلة السفير الأردني، ولكن عرفنافيما بعد أنها كذبة وانطلت علينا لفك الإضراب ليخبرونا بأن السفير رفض مقابلتنا، بل رفض الموضوع برمته، بدأت معاقبتنا على جريمة الإضراب عن الطعام بعد أن إطمأنوا إلى أننا إستعدنا قوانا، إذ نقلوني إلى المحجر الإنفرادي وحدي على إعتبار أنني المسؤول عن الإضراب وصاحب الفكرة، ولم أكن كذلك إنما كنت أشدّ المتحمسين لها بتوقيتها وكيفية تنفيذها. دخلت المحجر الإنفرادي في الخامس من شهر رمضان الكريم وبقيت به حتى آخر يوم لي في المعتقل أي الثاني والعشرين من الشهر نفسه، ويصادف الثامن عشر من شهر شباط على ما أذكر، إذ أنني أضعت حساب الأيام كما وأنها لم تعد تشكل لي أي أهمية بعد هذه المدة وطالما أن الليل والنهار يستويان. خرجت على يدي أحد أقرباء الرئيس صدام، الذي له صداقة مع أحد الأردنيين وهذا بدوره له ابن أخت يدرس مع إبني في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وكان إبني قد أخبره بقصتي كاملة، فذهب هذا إلى الشيخ (أحمد خضير الناصري) وهو ابن عم صدام لكنه لا يتدخل بالسياسة مطلقاً، وبمجرد مقابلتي للرجلين الفاضلين إنقلبت معاملتهم معي رأساً على عقب، وشعرت أن المعاناة شارفت على النهاية، ولكن راودني الخوف من أن يضللوا هذين الرجلين الطيبين مثلما ضللوا غيرهما أو عن طريق إقناعهما بأنني مذنب. وبعد يومين من زيارة الشيخين أخذوني إلى خارج المعتقل، وسمعتهم يتحدثون أو بالأحرى يجيبون عن سؤال محضري بأنني (مطلوب للزاهج) وهي كلمة غريبة. ما هو الزاهج ؟ وماذا يريد مني هذا الزاهج ؟ إنتظرنا بالإقامة مدة ساعة، وعاودنا الرحلة سارت السيارة بنا فمرت من أمام مبنى التلفزيون عن طريق الجسر الجمهوري مروراً بوزارة الإعلام وفندق المنصور. في هذه الأماكن وخلف مبنى التلفزيون بالصالحية قيادة الأمن الخاص أو بالأحرى ألعن وأنجس مكان للتعذيب بالعالم وليس في العراق فقط، يشرف عليه نجل الرئيس قصي. إنتابني الشعور بالخوف، ولكن عندما تجاوزنا الدوار متجهين إلى شارع حيفا ثم عرجنا إلى شارع العلاوي باتجاه المنصور من أمام معرض بغداد الدولي، أي إبتعدنا عن بوابة مبنى المخابرات التي خرجت منها ذات يوم بواسطة نفق يؤدي رأساً إلى الشارع يمر من أمام قصر المؤتمرات وفندق الرشيد. لم يطل بي التفكير وأنا أسأل نفسي أين يقع هذا الزاهج وما هو ؟ حتى إنعطفت السيارة فإذا بوابة أخرى مكتوب على لوحة كبيرة قبلها بأمتار (إستعلامات ومراجعات المواطنين). فُتحت البوابة. عندها فقط فهمت ماذا تعني كلمة زاهج. إنني بكل بساطة في مبنى جهاز المخابرات. وكلمة زاهج متى قلبت أحرفها أصبحت (جهاز)، وهناك قابلت رجلاً قال لي إنه منتدب كطرف محايد لإعادة التحقيق معي، فهو مكلف من قبل الرئيس وأن “سيادة الرئيس يهديك السلام ورئيس جهاز المخابرات أيضاً”.. كان أسلوب الرجل ناعماً كي يخفف من غلواء عدائي ومحاولة استقطابي بوضع اللائمة على بعض الأشخاص متهماً إياهم بالجهل مرة وبتجاوز صلاحياتهم مرة أخرى. كما أنه يضع اللوم الأكبر على هذه الحرب اللعينة، وهذا الحصار الجائر الذي أعقب إحتلاله للكويت، وأضاف: “أنت رجل شاعر وقلبك كبير والسجن دائماً يعطي للشاعر فرصة للإبداع فالمعاناة دائماً للشاعر منطلق لنحو تجربة شعرية متميزة، فإن شاء الله أوعدك خير والجماعة ما قصروا، قصدي الشيخ أحمد وصديقه، بعدين أنت سيد العارفين، لولاهم لما خرجت من هنا مطلقاً، لأنه معي هنا بالإضبارة مالتك أربع تهم، كل تهمة تؤدي إلى الإعدام على كل حال هاليومين أنت خارج”. وخرجت إلى الحياة بعد يومين. > تم الاعتماد في تحرير هذه الشهادة، على كتاب صاحبها المنشور باسم (الزنزانة رقم 8)
خولة إبراهيم كل البلاد في صعودٍ والعراق في هبوط أفٍ لها من عيشةٍ بين وغدٍ ولقيط(1) هذه الشهادات الموجعة للقلب، أصحابها أحياء يرزقون، وتحت أنوائها يرزحون، وما كانوا في ذلك الزمان بقادرين على الكلام، ككل شعب العراق السجين، فمنهم من لقيَ وجه ربه طبقاً لــ “تعددت الأسباب والموت واحد”، أو بقي معلقاً بين الأرض والسماء.. كان لا بد من بقاء حفنة من المعذَّبين، كي يستمر “الرئيس القائد.. الملهم.. الضرورة”، وهؤلاء المعذّبون كانت مخصصة لهم جيوشٌ من المعذِبين. وأتمنى اليوم لو تسعفنا المعطيات الاحصائية لمعرفة النسبة التي كانت مخصصة لكل مواطن من “نعمة المخابرات”، حقيقة أتمنى الوصول إلى معرفة هذه المسألة. شهادات مرّة لإناس عاشوا الأمرّين في غياهب سجون صدام، ولا أقول العراق، فقد سجن صدام العراق لأكثر من ثلاثين عاماً بقبضة حديدية وعقلية جهنمية، عبث بمصيره وبجغرافيته وتاريخه، أما رمِّم آثار بابل ليكتب عليها اسمه ! ورسّم حدود العراق مثلما كان يريد فتارة يطالب بشط العرب وتارة أخرى يتنازل عنه، وبين هذا وذاك تُزهق ملايين الأرواح. عبثية القرارات والحروب والاجراءات في كل شؤون الحياة، كانت مدروسة لأجل العبث بمصير العراق وأهله، فلم يسلم شجرٌ ولا بشرٌ ولا حجر، ولم يسلم في العراق ما كان قبل صدام، أو جاء بعده، فلا الأقدمون نجوا من التزوير ولا المعاصرون نجوا من العذاب ولا المواليد خلصوا من أتون الحرب، ولم تكن تلك نكته ولكن مرارة التي تداولها الناس عن طبيب يقول لإمرأة تلد “إن إبنك لا يريد الخروج إلى الحياة قبل أن يتأكد من أن مواليده غير مطلوبه للتجنيد”. جدارية جواد سليم “نصب الحرية” معلم فني رائع في بغداد، لم تسلم من عبث صدام الذي بنى نافورة من الماء تحت النصب كي ينهدم شيئاً .. فشيئاً، فكيف مات فنان العراق الكبير قبل أن يرسم له صورة ؟! ومن يتصور أن نشيد العراق الوطني كاتبه قد قتله صدام(1) ؟! وأن ملايين العراقيين الذين تمكنوا من الافلات من قبضة الديكتاتور وصلوا أطراف الكرة الأرضية.. وحكاية الموت غرقاً أو حريقاً أو تجمداً في شاحنة تبريد هي دلالات أو شهادات بل روايات. وحين بدأنا قراءة “غابرييل غارسيا ماركيز”في الثمانينيات، كانت الخلاصة المشتركة أننا تمنينا على ماركيز أن يأتي إلى العراق ويستهلم موضوعات رواياته من أرض الواقع. فكل ما كان يتخيله “غرائبياً”هو عندنا أمرٌ إعتيادي للغاية، والشيء بالشيء يذكر حينما ظهرت رواية “السيد الرئيس” في المكتبات العراقية كان الأمر يدعو إلى الاستغراب، ولكن سرعان ما عادت المخابرات لجمعها من بعد ما تبين لهم أن الرئيس ليس صدام وأن المضمون لا يمجده ! خطأ مطبعي كان يحدث في صحيفة، يقلب الدنيا على رأس العاملين فيها، ورئيس التحرير “مهما كانت بعثيته وشاعريته”، يتعرض للمساءلة حول خطأ يخلط في تاريخ الحزب المجيد بين البعث السوري والبعث العراقي. وقانون الصدفة لــ “كارل يونج” هو الذي كان يُبقي الكائنات والأشياء حيةً في العراق. فلافتة “الشهيد الخامس والأخير” التي علقها أحد الآباء المكلومين على باب داره كفيلة بأن تكون صورة لثماني سنوات عصيبة، مرت على العراق في حرب ضروس لا يُعرف أولها من آخرها.. وحين جاء ما يمكن تسميته بآخرها كانت المكرمة “الاحتفالات الجنونية في الشارع” تنفيساً لضغوطاتٍ مضت واستعداداً للجولة الأخرى في الكويت لتتبعها جولات مع العالم كله. لقد مرت كل تلك السنوات والعراق يغرق في مستنقع من الدم.. رائحة الموت في كل مكان.. السواد يلف البيوت والنساء أرامل والأطفال يتامى. ولا أكثر صفاقة من أغنيات “الله يخلي الرئيس، إحنا مشينا للحرب”، وأبواب الزنازين تفتح وتغلق آلاف المرات كل يوم.. هذا مات في عبدان أو نهر جاسم أو الربع الخالي، ومعارك جزر مجنون والمحمرة التي وقودها الناس والنفط.. وذاك قتلوه وذاك أخذوه.. ولا تدري إلى أين المسير ومن قبل قال السياب: ماذا يراد بنا وأين المسار والليل داجٍ والطريق عثار أخبار الاعدامات وفقدان البشر وضياع الصلة بهم اعتيادية جداً في العراق، فهؤلاء جيراننا “أخذوا اليوم ابنهم” هكذا يعلمنا الجيران الآخرون وتسأل: أين ومن وكيف ؟ فيقولون لك لا أحد يعلم.. سيبدأون التحريات وهم وشطارتهم ! صديقة تخبرنا عن زوج أختها وأربعة من أخوته ذهبوا ولم يعودوا وإلى حد الآن، وحتى بعد الكشف عن المقابر الجماعية وسجلات المخابرات لم يظهر لهم أثر ! هل هو السحر أم الكيمياء ؟ حضرنا جنازات صامته وأخرى ممنوع فيها البكاء، إختطفوا من وسطنا كتاباً وصحفيين، لا زلت أسأل عن (ضرغام هاشم) الذي طالب بمزيد من الحريات في أعقاب حرب تحرير الكويت، فصار رقماً “في مزيد من الإعدامات”. بلد تتحكم بمقدراته حفنة من اللصوص القتلة، وشعبٌ بين قتيل ومفقود ومعوق أو مطرود وأذكر أن أكثر ما أرعبني فيما بعد قول الشاعر عبد الوهاب البياتي في مقابلة صحفية، أجريتها معه عام 1996 في عمان: “هذا تنين يعود كلما تقطعت أطرافه”. وخفت ألا أشهد يوماً ينتهى فيه التنين وينزاح معه الكابوس عن العراق والعراقيين، واليوم انفتحت بوابات العراق على التغيير والزمن وآفاق الحياة، وولّت الزنازين إلى غير رجعة. وهذا وحده مسار جديد.
|